|
المرأة بين الواقع والمرتجى في النظام الأبوي البطريكي
"دراسة مقارنة"
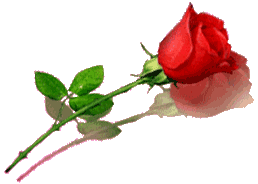 بقلم:
نضال القادري
بقلم:
نضال القادري
يحكى دائما عن مكتسبات في مسيرة الحركة النسائية وعن القرب من تحقيق
المساواة. إن فكرة مساواة المرأة مع الرجل طرحت لعقود طويلة بطريقة لا تخلو من
غياب الجوهر الحقيقي للموضوع، ويستطيع الباحث أن يرصد الكثير من الأقاويل
والقصص المثيرة للجدل للتدليل على قهر المجتمع بصورة عامة للمرأة. فعندما تتحدث
أي امرأة عن ظلم الرجل لها، ومطالبتها بحقوقها، يشار دائماً إلى فكرة أن الرجل
أقوى وأقدر على الحماية والولاية على كل ما يتحكم بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة،
رغم كل ما يقال من أن المرأة هي نصف المجتمع ليس قناعة منه بذلك بل فقط ليدغدغ
عواطفها، ولينقلب إلى شخص أخر في موقع المدح المدفوع سلفا للإقتناص من
معنوياتها في وقت لاحق، والسؤال الذي يطرح نفسه علينا بطريقة مستدركة: إذا كانت
المرأة نصف المجتمع، فكيف يمكن أن يتطور نصف المجتمع ويبقى نصفه الآخر بدون
تطور؟!
إن ما يقال عن تحقيق مكتسبات في تاريخ العلاقة بين الصنفين لهو لغو
نسبي لا يتعدى أكثر من إحصاء بسيط ولا يطال نواحي الحياة الفعلية لهما ولا يدلك
على المجرى الحقيقي الطبيعي للمنطلقات الإنسانية بينهما. فالمكتسبات النسائية
هي هشة بطبيعتها في المجتمعات العربية، وهي تواجه أنواعا عدة من العقبات أهمها
ما يعرف بالهجمة الذكورية، والردة الإيديولوجية للمكنون الديني الذي يقود
المجتمع بطريقة "بطركية" كما يقول الباحث هشام شرابي في كتاباته. وفي هذا الجو
المحموم من العلاقة، تتكرر الموضوعات المستعارة المستوردة في أغلبها من الغرب،
ومن الولايات المتحدة خصوصا، ومفادها أن مستنصري التوجه النسائي يبالغون في
تصوير المشهد الأولي لاضطهاد المرأة في مجتمعاتنا، وعمليا قد يكون انتهى إلى
غير رجعة ذلك الزمن من التحرش الجنسي المستتر، وكذلك الاغتصاب بين الأزواج،
والزواج بالإكراه كما كان ساريا من قبل في مجتمعاتنا العربية، إذ هناك بعض
النساء ممن لا يستسلمن بسهولة لأي وسيلة إخضاعية، وهذا النموذج يتخذ خطوات أكثر
جرأة تبدأ بالتمرد على التهميش العائلي والإستفراد في منزل أهلها وتنتهي بطلب
الطلاق والإفتراق من الزوج الذي لا تحبه أو أجبرت على الزواج منه، ولكن ذلك لا
يشكل البطولة ولا الإنصاف المنشود الذي تسعى لتحقيقه الحركات النسائية. ولا بد
للمتسائل أن ينبري للتوقف عند ما يزعم أنه التحرر والافتراق والإنعتاق من واقع
مرير، لكن عند بعض المجتمع أو بعض الأسر قد تأخذ هذه الصفة (التحرر والافتراق
والإنعتاق) وتعطيها معان أخرى بعيدة كل البعد عن المعنى الأصلي للكلمة،
فمجتمعاتنا تحكم على المرأة المطلقة بالموت المعنوي والدعائي، مهما كانت ظروف
طلاقها وأيضا دون النظر إلى حالتها السابقة التي مرت بها، ومهما كانت معروفة
أطباع وسوء الرجل الذي انفصلت عنه، فلا بد أن تكون المرأة هي المخطئة في
مجتمعاتنا ويكون بذلك الرجل المتحكم بها دائما على حق مبين، هذا إذا لم يطعن
الرجل وأسرته وأحلافه القبليين في أخلاقها وشرفها، وغالبا ما يحدث هذا.بصورة
بشعة، تخلق من دون أدنى شك صورة معنوية هزيلة للمطلقة في مجتمع يحكمه الذكور
المتشوقين إلى ضحية وأصنام الأعراف الماضية البائدة التى لا توفر من لا يعنيهم
الأمر.
إن الردة الرجعية لبعض المفاصل في القوانين التي تتحكم في حياة
المرأة التي أصابها القدر السيء، تضعنا أمام تحديات جمة، خصوصا إذا ما أصبحت
وحدها تجابه الريح العاتية الأتية من كل حدب وصوب، والمثال الأتي يشهد ما أقوله
عندما تكون العِصْمَة التي بيد الرجل أبدية حتى بعد الموت، إذ تتحول إلى سيف
قهار بتار لا يرحم نساءنا في الشرق، فالمرأة مثلاً لا يجوز لها أن تكون وصية
على أطفالها بعد وفاة زوجها، لا في مسألة تزويجهم أو إدخالهم إلى المدارس أو
تسفيرهم إلى الخارج أو توريثهم شرعا، وتبقى الأرملة على الدوام بحاجة أو تحت
رحمة أحد أقارب زوجها المتوفىّ من أصحاب الصفة القانونية لكي يشرف على
معاملاتها التي تبقى دوماً أسيرة لموافقة أو لمزاج أولي الأمر. والسؤال يطرح
نفسه من دون مقدمات تذكر: من ينصف المرأة؟! من يحاسب ظلاّم المرأة ويأخذ لها
حقوقها الأساسية أو يحافظ على ما تبقى منها؟! هل نذهب كما قال البعض: "لا بد من
أيجاد محكمة نسوية صرفة"، الحاكمة فيها امرأة عانت ما تعانيه النساء من ضروب
الظلم المتعددة والتي قد تبدأ بالحرمان من التعليم ولا تنتهي فقط عند تلقي
الضرب والإهانة على يد الأزواج؟! الجواب: لا، إن الأمر ليس كذلك، لا أعتقد ذلك
على الإطلاق، ففاقد الأشياء لا يعطيها، وكيف به إذا صار متحكما ويريد أن يسترجع
ما فقده منذ زمن بلحظة حياة واحدة. إن تطبيق القانون يجب أن يكون سيد المواقف،
وإن أي تشكيل لمحكمة نسوية صرفة سيقلل من مصداقية أحكامها وقراراتها
واجتهاداتها، وسينظر الرجال إلى هيكليتها من زاوية عنصرية فاقدة لكل ما تقوم به
حتى ولو كانت درجات الإستئناف بها تأخذ حيزا كبيرا. إن الناظر في الأشياء يرى
أن جهاز القضاء، على سبيل المثال في لبنان، قد أصبح يعج بالأسماء النسوية وأصبح
عدد النساء في مهعد الدروس القضائية يشكل ما نسبته 80 % من عدد الطلاب
المقبولين، مما طرح أكثر من علامة إستفهام وسؤال داخل الجسم القضائي وخارجه
لمعالجة ما اعتبر مشكلة بين الجنسين، ولكن هذا لا ينتقص من قيمتهن أو كفاءتهن،
إذ أكبر دليل على كفائتهن السيدة القاضية "ربيعة عماش قدورة" التي دخلت تاريخ
الجسم القضائي في لبنان والدول العربية كأول قاضية تتولى مهام "مدعي عام
تمييزي".. مثال أخر هو السيدة القاضية "تهاني الجبالي"، أول امرأة تعتلي عرش
القضاء المصري من بنات حواء للفصل في القضايا بنص القانون وروح العدل، إن قلبها
يتسع للدنيا كلها لتحسم الكثير من الجدل حول مدى أحقية وكفاءة المرأة في أن
تحكم بين الناس وتحل مشاكلهم وتفصل في نزاعاتهم، ولم تقف عند هذا الحد، بل تم
إنتخابها عضوة في المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب، لتصبح بذلك أول سيدة
عربية تنتخب في هذا المستوى بالإتحاد منذ تأسيسه في عام 1944م. ولم تكن المرأة
في سورية بعيدة عن سلطة العدل، إذ وصلت على سبيل إلى أعلى درجات القضاء حيث
تتولى منصب النائب العام القاضية "غادة مراد" وهي سيدة من أكفأ النساء العاملات
في مجال القانون وحكمت في العديد من قضايا الإعدام والإفلاس الشائكة.
منذ القدم، لا يزال المجتمع الذكوري مسيطرا، بالرغم مما قدمته
المرأة على كل الأصعدة، في الحرب والسلم والهدنة، وللمتسائل أقول أنه لا يوجد
نص قرآني يمنع تعيين المرأة في القضاء، وفي ذلك يقول الله في قرأنه الكريم:
(المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، فقد
أعطى الدين الإسلامي للمرأة حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قال أيضا
محمد رسول الله: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء"، حيث أعطى حق الإفتاء للسيدة
عائشة والصحابي عمر بن الخطاب، وأعطى القضاء في السوق لامرأة تفصل فيما ينشب من
مشاكل بين التجار. إن الظلم يقرّه ولاة المجتمع، ويدعمه الجهلة من أتباعه رغم
كل الأقوال البائتة في عدم جوازه، وإن أي محكمة تطرح على بساط البحث يجب أن
تحفظ إنسانية الإنسان بالدرجة الأولى وكرامة المرأة كونها إنسانا رقيقا، فهي
الأم والأخت والبنت والخالة والعمة.. ومن يقبل العبودية لأهله والإهانة لأهله
فهو ليس أهلا للشورى والولاية على كل أنواعها، إن المحاكم التي تقر بوجوب أن
تصدر أحكام على العنصرية والتفرقة بين الجنسين مرحب بها من كثير من أبناء
الشعب، والمحاكم ليست مشكورة من قبل الهيئات التي ترى أن النتائج هي عملية
إنتقاص من صلاحيات يدعون ألوهيتها بطلانا ويعتبرون أن ما ألت إليه الأمور باطلا
بطلانا تاما وبائنا. نعم، لمحكمة تأخذ لنا حقوقنا من مجتمع الرجعية والتخلف دون
النظر للجنس واللون والطائفة والدين لكل من أطراف النزاع والدفاع والحكام،
واقتراح تشجيع استخدام الآليات القضائية مثل الطعن في الأحكام غير الدستورية
واستخدام آليات العدالة الاجتماعية مثل المحكمة الجنائية الدولية وحث الدول
على المصادقة عليها.
إن النظرة إلى المجتمع الأبوي في العالم العربي بطريقة أحادية
الجانب لا تخلو من العنصرية، لذلك يعتبر الخطأ والخطيئة فخاً واحدا منصوباً
أمام الفتاة الشرقية في كل زمان ومكان، علماً بأن العلاقات الشبابية بين الذكور
والإناث هي علاقات أُلفة ومحبة مشروعة ومتبادلة، ولذا ينبغي أن يكون الخطأ
والخطيئة (الذنب) أيضاٌ متبادلاً، أي عندما يتم ارتكاب أية هفوة فإنّ على
المجتمع محاسبة الطرفين على حدٍ سواء، لكن الذي يجري في العادة لا يعكس الصورة
الحقيقية لمجريات الحدث، بل تُنْسَب أي غلطة إلى الفتاة وتعتبر خطيئة لا تغتفر
إلاّ بغسل العار الذي يتم عادة بقتلها، أو إلزامها بالبقاء ضمن أربع جدران إلى
أبد لا نعرفه غسلا لعار مزعوم لم ترتكبه، ويتبين من معاناة المرأة أنها لا تزال
تحت قيد المعاناة، وإن إزالة هذه الحالة عنها لا تعني أن المساواة قد تحققت،
حيث أننا نجد من بين كل عشر إناث تعرضت سبعة منهن للضرب في المغرب ووصلت النسبة
في مصر إلى 25% وفي اليمن إلى64 % ، بالإضافة إلى جرائم الشرف التي تقع ضحيتها
النساء بنسبة 59%، ويخطرني في ذلك، حادثة السيدة "رانيا الباز"، المذيعة
السعودية التي تصدرت حادثة ضربها من قبل زوجها، السعودي أيضًا، عنوانين الصحف
وأجندة الاعلام العربي والغربي في عام 2005 لمدة لا يستهان بها. وبهذا المعنى،
فإن النساء سيشكلن أقلية حتى لو وصلت نسبتهن ديموغرافياً إلى 70% أو 80% في بعض
البلدان العربية في ظل مجتمع "بطركي" أبوي سلطوي المنشأ والمجرى، هذا المنطق
سيكرس ثقافة التلاوين والتمايزات وعدم قبول الآخر، ويمكن أن يؤسس لمثنويات
جوهرية سلبية في المستقبل المنظور (أبيض/ أسود، لغة سيدة/ لغة مبتذلة)،
وبالتالي فإن المثنوية الجوهرية (رجل / إمرأة) ستفسح في المجال لتلاوين عنصرية
أخرى، وستزرع ثقافة أقل ما يقال فيها بأنها "مضطربة" في مكنوناتها.
وفي هذا المجال لا يسعني إلا أن أعبر عن تقديري لرهافة الكاتبة
"سوسن العطار" عندما تكلمت عن زميلتها "أحلام مستغانمي" ناقدة لفكرها القصصي
الذي لا يعبر عن مكنونات المرأة العربية في التحرر والسيادة والإستقلال، خصوصا
عندما تقدم هذه الأخيرة منهما أشخاص نسائها في القصة: "هذه هي أحلام مستغانمي،
تحبها النساء وينام على عبق رواياتها الرجال، تنتظرها بشغف وإعجاب المثقفات
المتحررات/.. من الزوجة الخائنة إلى الزوجة التي تدري بخيانات زوجها وتصمت كأن
ذلك أحد حقوقه، أو الزوجة الغبية التي لا تدري أصلا بخيانات زوجها، إلى الأم
الأرملة التعسة الجاهلة والمطلقة المستسلمة.../ ثم تنبري الكاتبة "سوسن العطار"
لزميلتها قائلة:"بصدق أنا أستمتع وأنا أقرأك، وسأحاول أن أعيد قراءتك لعلي أجد
فيها مخفيا بين الشخوص، عن امرأة ما أو رجل ما، لا أريده / أريدها مثاليا، ولكن
عاديا، يعيش لفكرة ما، لهدف ما إلى جانب غرائزه، ولا يستخدم سحر قضاياه
ورومانسية عذاباته لتجميل غرائزه وجعلها أكثر إغراءا، الخيانة ليست فضيلة،
الخيانة خيانة لوطن، لزوج، لصديق، فلا يتزوج أو يستمر في الزواج من لا يشعر أن
الآخر صديقه وزوجه ووطنه".. إن الزواج ليس إنعتاقا من حالة يأس بالقوة إلى حالة
يأس بالفعل، إن الزواج حالة حياة مثلى لنظام كوني مصغر يختبر الإنسان فيه
مكنوناته الأولى تمهيدا لولوج نهائيات الكون في جمالياته الأخيرة. إن الزواج
عمليا بالنسبة للفتاة هو إحدى الوسائل المساعدة لحصولها على جزء من حريتها
بطريقة أو بأخرى، ويجب ألا يكون إستعمارا جديدا واستعبادا قبليا من الناحية
الأسرية والعائلية، وكذلك السياسية أيضا. وإذا كان الذي يحصل لا يدل على ذلك،
فإن الأخذ بنظام "الكوتا" في الممارسة السياسية لهو ضرورة ملحة على أن يكون ذلك
إجراءاً مرحليا ليحمي المرأة من مجتمع يتحكم الذكور في صغائره وكبائره، وهذا
النظام الحصصي تعمل به حوالي 75 دولة في كافة أنحاء العالم، وبالتالي سيكون
ضرورة للتصدي للإتجاهات المحافظة والرجعية التي إرتفع صوتها، ومن هنا أستدرك
السؤال لأقول: ألا يعتبر النضال من أجل إصدار قانون عصري للأحوال الشخصية من
الأولويات النضال؟!!
بعد كل ما تقدم، أعتقد أن سبب تردي أوضاع المرأة في السياسة كمشروع
نهضوي يرجع لأسباب جوهرية من أهمها عدم إنخراط المرأة في العمل السياسي لفترة
من الزمن، وعدم وعي المرأة الناخبة لأهمية مشاركتها في الانتخابات، ولنقص موارد
التمويل للحملات الانتخابية أو لتأثرها بقرار الرجل في اختيار المرشح أو لغياب
المؤسسة النسائية المنظمة القادرة على تبني المرشحات من النساء ودعمهن. ومن
هنا، إن الدعوة لضرورة التصديق على إتفاقية "سيداو" (إتفاق إلغاء كل أشكال
التمييز ضد المرأة) هو ضربة تشريعية في محلها تسهم إلى حد كبير بوضع الأمور في
نصابها الصحيح. وعند مناقشة هذه الحالة، تحضرني آراء النهضويين الذين عاشوا في
بلاد الشام أمثال الأساتذة الكبار أحمد فارس الشدياق، وبطرس البستاني، وفرح
أنطون، وأنطون سعادة، وكانت مذاهبهم أكثر تنورا ممن عاشوا في باقي العالم
العربي، إلا أن تأثير أفكارهم لم يكن كافيا ورسوليا على ما يبدو لتغيير العقلية
الذكورية المسيطرة على سكان البلاد، مرد ذلك لما شهدته بلادنا من قهر سياسي قضى
على أفكار بعضهم واغتالها تحت ذرائع الإنفتاح الممنوع. ضف إلى ذلك، أن العمل
على وقف بثّ الصورة السلبية للمرأة في وسائل الاعلام التي تمثّلها كجسد والعمل
على إزالة تكريس الصورة النمطية للمرأة هو إنجاز في محله يرفع درجة احترامها
ويعيد الكثير من صورتها المفقودة كوجه متكامل بكل أبعاده الإنسانية. وسأذكر على
سبيل المثال، الوجه المتكامل للمراة التي جسدت صورة بلادي من الناحية الإعلامية
السيدة "لبيبة هاشم" التي أصدرت في عام 1906 مجلة (فتاة الشرق)، والسيدة "ماري
عجمي" التي أسست في عام 1910 مجلة (العروس)، وأسست جمعيات نسائية عدة للنضال ضد
المستعمر العثماني، وقد اتضحت مسيرتها النضالية حين التقت بالمناضل "بترو باولي"،
لكن الأتراك قبضوا عليه، وأعدم مع مجموعة الشهداء في 6 أيار، وبقيت وفية له ولم
تتزوج أبدا، كما واجهت بدورها الاستعمار الفرنسي بذات الروح النضالية، ولم أنس
السيدة "عادلة بيهم الجزائري" التي شاركت في النضال السياسي ضد قهر السلطة
العثمانية، وحمت ورفيقاتها أناسا كثرا من أعواد مشانقهم. ولا يخفى من بعدها،
دور المرأة السورية التي ازدادت وتعاظمت في السمو، إذ نالت حق المشاركة في
الانتخاب عام 1949، وفي شباط 1958 تم تشكيل مجلس أمة موحد في سورية كان من
بينهم امرأتان هما السيدة "جيهان موصللي" والسيدة "وداد أزهري". وفي التاريخ
الحديث، كان على المرأة في بعض البلدان العربية أن تسلك طريقا يعتمد في بعض
أدواره على الكفاءة أو المحسوبية/ أو التلطي تحت سقف العباءات السياسية أو
الإقطاعية/ وإما الإختباء في سلالة المورثين في الحزب والدولة والجمعية ونوادي
السياسة وكل ما إلى ذلك من أجل الوصول إلى المنال والمراد، وهذه الذهنية لم
تشكل حتى الأن صورة مقنعة عن المرأة المستقلة بقرارها إستقلالا تاما يؤدي إلى
أعتبارها نموذجا صحيحا للإقتداء به بين جمهور النساء. ولكن كلامي في ذلك، ليس
للتقليل من أهميتها بل للتدليل على أسلوب وصولها إلى الأضواء في الأنظمة
المركبة بطريقة مثيرة للجدل، وتحضرني الأسماء التالية كنماذج يمكن إسقاطها على
ما تقدم: (ربيعة عماش قدورة، نضال الأشقر، أليسار سعادة، بشرى مسوح، هيام محسن،
جولييت المير سعادة، بهية الحريري، غنوة جلول، مها الخوري أسعد، نائلة معوض،
منى الهراوي، نعمت كنعان، ندى السردوك، منى فارس، بثينة شعبان، أسمى خضر، حنان
عشراوي، توجان الفيصل.
إن الصورة الوحيدة التي لا تزال عالقة في أذهاني هي صورة المراة
المقاومة البطلة التي تخطت كل عرائض المطالبات بالمساواة، إن ما قدمته لهو
زيادة فوق الزيادات، صورة تختلف عن التي طالبت بها المشاركات في "مؤتمر المرأة
العربية" الذي أقيم في بيروت بعد التحرير، ولا أنكر حق المرأة التي طالبت
الأحزاب والقوى السياسية والاتحادات النقابية بترشيحها وإدراجها داخل هيئاتها
القيادية على اللوائح الانتخابية تحت نظام "كوتا" أو التي اقترحت في إطار تنظيم
الاعلام والاعلان الانتخابيين على تصويب صورة المرأة في وسائل الاعلام، بل رأيت
أن الصورة الصواب هي أن نضع فسيفساء الصمود والتحدي أمام مهزلة التخلف التي
نجتهد منذ زمن لتصحيحها. إن النموذج الفريد والأوحد الذي يهز المشاعر هو الذي
شهدناه بعدما إزاحت المشاركات في المؤتمر الستار عن نصب وجدارية «المرأة
المقاومة» التي صممها الفنان "وجيه نحلة"، هذا الستار الذي أسدلت ليل ظلماته في
النضال ضد اليهود، إبنة المفكر "أنطون سعادة" مؤسس الحزب السوري القومي
الإجتماعي الشهيدة "سناء محيدلي" ورفيقات من بعدها على مذابح الحرية الحمراء،
إن هذه الصورة ليست بحاجة لمن يجملها، إنها البداية والنهاية ومساواة للمعنى
والمبنى، إنه وطنها الأرحب الذي لا نشكل كلنا إلا أطراف مجده الأتي.. وخير ما
أسعدني في ذلك اليوم أيضا، ما تقدم به رئيس بلدية بيروت د. عبدالمنعم العريس
عندما أتحف المشاركات بالقول:"كان أوج المجد الذي وصلت إليه المرأة، ارتقاؤها
إلى مستوى المرأة المقاومة، وفي تجربتنا اللبنانية لم تكتف المرأة بدور
المساندة لأعمال المقاومة، بل ذهبت إلى ممارسة المقاومة فعلا، وصولا إلى
السيادة، وإننا إذ نزيح الستار عن نصب وجدارية المرأة المقاومة في قلب بيروت،
نؤكد على معنى المقاومة التي انطلقت من بيروت في عام 1982، وجسدها الشهيد البطل
خالد علوان".
حقا، لا مساواة إلا في محبة الوطن وفي الذود عن بتلاته، ولا تكتمل
المكتسبات إلا للذين يحبون الحرية.
-1- إن "العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في الديباجة التمهيدية يقر بما يلي:
"إن الدول الأطراف في هذا العهد، ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة
البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ
المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر
بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد
لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون
البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة،
هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية،
وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على
الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة
العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه
واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي
إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد".
-2- إن المادة
الرابعة من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في فقرتها الأولى
تقر بالأتي: "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن
قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي
يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد،
شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى
القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".
أضيفت في10/03/2006/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتب
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

ممدوح عدوان... و..«المرأة في أدب توفيق الحكيم»
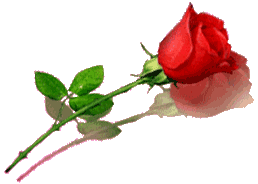 بقلم:
محمد كشك
بقلم:
محمد كشك
سأل الحكيم الصيني المشهور كونفوشيوس أحد تلامذته: من هي المرأة؟
فأجابه تلميذ: نصف المجتمع.. أيها المعلم، بل «هي أساس المجتمع..» أجاب الحكيم
الفيلسوف الذي ذهبت حكمته وأقواله أمثالاً يستشهد بها الآن على الرغم من مرور
آلاف السنين عليها، ويقول الدكتورعبداللطيف ياسين في كتابه «المرأة عبر
التاريخ»: إن مكانة المرأة عبر العصور وعبر الحضارات المختلفة كانت متفاوتة،
وأحياناً متناقضة، حتى في الحضارة الواحدة.. وإذا أرجعنا المرأة إلى تاريخها
وبصماتها الحضارية الأولى عبر العصور المغرقة في القدم.. الضاربة جذورها في
أعمق أعماق الزمان والمكان، ترى أن معظم الشعوب والمجتمعات الانسانية كانت تنظر
إليها وكأنها «إلهة» فهاهي ذي «كالي» في الهند القديمة.. وتلك هي فينوس في
روما، وهذه (عشتار.. أو عشتروت) لدى شعوب بابل وحضارات بلاد مابين النهرين
وغيرها.. الخ وتذهب فريدة النقاش إلى القول بأن تاريخ المرأة العربية في القرن
العشرين وتجربتها هما تاريخ الحداثة- وفي القلب من ثقافة الشعوب تقع قضية
المرأة بتناقضاتها والتباساتها.
وكثيراً ماترى الشعوب أن خصوصيتها القومية هي امرأة تجسد شرف الوطن،
وطالما عوقبت المرأة باسم هذا الشرف.
ولقد تناول الأدباء والشعراء موضوع المرأة من وجهات نظر عديدة، فبعضهم
وقف عند حب المرأة فلمح إلى ذلك في نسيب قصيدته، أو شبب بها وتغزل بها، ومنهم
من وصف خلقها وخُلقها وحللوا نفسيتها، وما تشعر به في صميم قلبها من العواطف
والمشاعر وبحث آخرون ماتقوم به من أدوار اجتماعية وأدبية وسياسية وفنية..الخ.
الروائي والمفكر المصري توفيق الحكيم الذي أكد حضوره على الصعيد
الثقافي في العالم من خلال فكره وأدبه وأعماله التي بلغت 70كتاباً.. كان له
رأيه في المرأة.. حول هذا الجانب، قدم الأديب السوري الراحل ممدوح عدوان دراسة
شاملة.. حيث يرى عدوان في بعض جوانب الدراسة: أن هناك ضرورة أولية، عند قراءة
أي نص إبداعي أو أدبي للتمييز بين الشخصية وسلوكها، وبين مايريده الكاتب منها،
إذ لايجوز الحكم على الكاتب من خلال الحكم على شخصياته، إن هناك وظيفة للشخصية
في العمل ووظيفة أخرى للنص الذي يحتوي عليها، فـ «ليلى» في «المرأة الجديدة»
تدافع عن ضرورة تحرر المرأة من الأفكار السائدة عنها ومن أساليب الزواج
التقليدية، وتناقش سليمان ووالدها، وكذلك تفعل «نعمت» على الرغم من محاولة
الرجال الرد على وجهات النظر هذه أو السخرية منها. «علشان تعرف ان المرأة تقدر
أن تكون صديقة مخلصة للراجل» و«الحكاية كلها عادة قديمة لازم تبطل، أنا في نظرك
واحدة ست بس- لكن بكرة تتعود وتعتبرني زي أي واحد صاحبك تمام»، و«دي بنت زمان
المتأخرة الجاهلة، مسكينة ماكانتش تفهم من الراجل، إلا أنه زوج وبس وماكانتش
تفهم أي رابطة بين الراجل والمرأة غير رابطة واحدة هي الزواج.. بنت اليوم
الناهضة المتعلمة تفهم ان علاقتها بالراجل مش بس الزواج.. فيه روابط تانية، فيه
رابطة الصداقة، ورابطة العمل في الحياة» هذا الكلام على لسان الشخصية وارد في
مسرحية مكرسة ضد مقولة تحرر المرأة فمسرحية «المرأة الجديدة» مكرسة للرد على
الأفكار التحررية الداعية إلى الاختلاط والسفور، وبالتالي فإن الخطأ الأكبر
الذي وقع فيه عدد من الدارسين -للحكيم وغيره «من وجهة نظر عدوان»-هو خطأ محاسبة
الأديب على أساس ان الشخصيات التي في أعماله تعبر عنه، ومن مسرحية «جنسنا
اللطيف» يورد حواراً بين الزوجة وصديقتيها المحامية والصحفية وبين الزوج تؤكد
فيه النساء حق المرأة في الخروج إلى معترك الحياة.. ولعل كثيرين توقفوا عند
القفشات التي صاحبت المسرحية، ليخرجوا منها بتقرير موقف الحكيم، والحقيقة أنه
يمكن الاستدلال بها، ولكن ليس على أنها تعبير عن رأي الحكيم بدقة بل على أنها
ممالأة الحكيم للرأي السائد بين الرجال الذين هم جمهور المسرح، ولهذا يبدو
الحكيم حريصاً على مؤسسة الزواج وحريصاً على الأسرة وتماسكها ولكن بتوزيع خاص
للأدوار فيها، وفي مسرحيتي «الأيدي الناعمة» و «شمس النهار» نجد أن المرأة
«الناعمة» يعيد الرجل خلقها، وهو خلق بمعنى التهيئة والاعداد لكي تكون قادرة
على مواجهة الحياة، ولكي تكون صالحة حتى كزوجة وأم.
ويخلص عدوان إلى فكرتين يراهما عند الحكيم، وتتلخص الأولى: في تركيزه
على طريقة المرأة في اختيار شريك حياتها، فحتى «ليلى» في «المرأة الجديدة» تقول
آراء ذات أهمية بالغة في مسألة تقرير من ستتزوج، وهي تصر على أنها هي التي
ستنتقي، ومن الحياة التي يجب أن تراها وتختبرها، وهذا شبيه بموقف الأميرة «شمس
النهار» التي تريد أن تنتقي عريسها بنفسها بعد أن ترى الناس كلهم على طبيعتهم
وعلى حقيقتهم ودون أية شروط وتهيئة مسبقة، والفكرة الثانية والأكثر أهمية، هي
إصرار الحكيم على أن العمل هو القوة المغيرة للحياة وللانسان ذاته-حتى الباشا
في «الأيدي الناعمة» وبعد أن يحب، يريد تغيير نفسه ، ولا يكون ذلك إلا بالعمل،
وكذلك فإن «قمر الزمان» يعيد تهيئة الأميرة «شمس النهار» بأن يجبرها على أن
تعمل بيدها وتأكل من تعبها فتكتشف أنه قد صار للحياة-وللأكل- طعم آخر.
وهكذا، نجد أن الأفكار الأساس التي يمكن أن تناقش بجدية، هي تركيز
الحكيم على تساؤل: من الذي يصنع الآخر ويؤثر في تكوينه المرأة في الرجل؟ أم
الرجل في المرأة؟ونعثر على مواقف تلفت النظر في هذا المجال.
أضيفت في07/06/2005/ خاص
القصة السورية
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

المرأة في أدب نجيب محفوظ
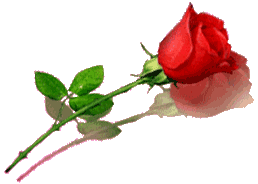 عرض:
رجب سعد السيّد
عرض:
رجب سعد السيّد
المرأة فـي أدب نجيب محفوظ مظاهر تطـوّر المرأة في مصر المعاصرة من
خلال روايات نجيب محفـوظ : 1945 - 1967
وراء هذا الكتاب جهد وافر، قامت به مترجمة الكتاب، التي هي - بالوقت
ذاته - مؤلفته. لقد وضعته المؤلفة/المترجمة بالفرنسية، فهو - بحقيقة الأمر -
رسالتها للدكتوراه، حصلت بها على درجتها العلمية من جامعة ( جنيف )، بسويسرا،
بالعام 1983. إذن، فقـد جـاء المؤلّف الفرنسي ليحتوي جهدا أكاديميا، توفرت له
جوانب النجاح، بعد أن توفرت فيه متطلبات البحث العلمي الأكاديمي، من جدة، ودقة،
ورصانة.
وتشير الدكتورة فوزية العشماوي، في تقديمها لترجمتها العربية لكتابها،
إلى أن رسالتها - موضوع هذا الكتاب - كانت أول رسالة دكتوراه تناقش في جامعة
أوربية، عن نجيب محفوظ، وأن الكتاب من الكتب الأوائل المبكرة، التي صدرت
بالفرنسية عن محفوظ، قبل خمس سنوات من حصوله على جائزة نوبل، في العام 1988؛
ولكنها تمسك - تواضعا - عن أي إشارة إلى احتمال أن تكون دراستها العلمية الجادة
والقيمة، وكتابها في طبعته الفرنسية، قد أسهما - بدرجة أو بأخرى - في تمهيد
طريق نجيب محفوظ إلى نوبل؛ وإن كانت الدكتورة العشماوي تشير في مقدمة الكتاب
إلى أنها، بحسها الأدبي، وبحكم تواجدها بالأوساط القريبة من مركز منح الجائزة،
قد تنبأت لمحفوظ، في لقاء لهـــما بالعام 1979، بأنه سوف يحصل على تلك الجائزة
رفيعة الشأن.
نحن - إذن - أمام كتاب ذي طبيعة خاصة، يندر أن تجد لحالته مثيلا؛ فقد
ولد بهيئة بحث أكاديمي؛ ثم تحول إلى كتاب موجه للقارئ الأوربي؛ ثم رأت صاحبته
ألاّ تحرم أبناء جلدتها من جهدها، فتوفرت على ترجمته للعربية؛ وهي ترجمة لم تكن
سهلة، بالرغم من أن المترجمة هي ذاتها المؤلفة، وبالرغم من امتلاكهــا ناصية كل
من اللغتين، إذ كان عليهـا أن تستغني عن التفاصيل التي لزمت للطبعة الفرنسية،
لتعين القارئ الفرنسي على قراءة الكتاب .. مشوار كبير قطعه هذا الكتاب، لنقرأه
ونحتفي به الآن؛ إذ استغرق الأمر ما يقرب من عشرين سنة ( 83 - 2002 )، ليصل هذا
الكتاب ليد قارئ العربية.
وبالرغم من طول الرحلة، التي قطعهـا هذا الكتاب، إلاّ أنه لا يزال
محتفظا بطزاجته، فلا يزال موضوعه مطروحا في الدوائر الفكرية والاجتماعية، حتى
الآن؛ ولا يزال الجدل حول قضايا المرأة محتدما، غير محسوم؛ ولعل كتاب الدكتورة
العشماوي، وهو يهتم بعرض مظاهر تطور المرأة في مصر المعاصرة، من خلال روايات
نجيب محفوظ المنشورة في الفترة بين 1945 و 1967 .. لعله يساعد في إضاءة جوانب
من هذه القضــايا، الخاصة بالشق المؤنث من أحد أنواع الكائنات الحية، أعطى
لنفسه الحق في اعتلاء قمة هرم التطور بين سائر مخلوقات الله؛ ومع ذلك، لا يزال
يعمّـق الفوارق بين شقيه، حتى أنه ليكاد يصنع منهما نوعين متباينين : أحدهما
مذكر، وهو يري نفسه الأرقى، والآخر مؤنث، ويعيش - لا يزال - محروما من حقوق
كثيرة يحتكرها الشق الآخر !
ويتكون الكتاب من تقديم، ثم مقدمة عامة؛ أما قلبه، فجزآن : الأول، نظرة
عامة على مظاهر تطور المرأة في مصر المعاصرة، من خلال روايات نجيب محفوظ ( 1945
- 1967 )؛ والثاني، دراسة تحليلية موسعة لثلاث شخصيات نسائية؛ هي : " نفيسة " -
بداية ونهاية، 1949؛ و " نـــور " - اللص والكــلاب، 1961؛ و " زهـــرة " -
ميرامــار، 1967.
وتهتم المؤلفة، في مقدمة الكتاب، بالتأصيل للاهتمام بقضايا المرأة في
مصر الحديثة، فتعود بالقارئ إلى مفتتح القرن 19، الذي شهد بداية حركة تحرير
المرأة المصرية، واقتناع مجموعة من المثقفين والمستنيرين المصريين بأن تحرير
الوطن يجب أن يبدأ بتحرير المرأة. كما تمهد المؤلفة لظهور نجيب محفوظ، فتشير
إلى أن ذلك التطور في الفكر الاجتماعي قد صاحبه ازدهار في النشاط الصحافي
والإنتاج الأدبي؛ وقد ترتب على ذلك الرواج الصحفي ارتفاع أسهم النثر العربي،
على حساب الشعر. ولم يلبث ذلك النثر أن تخلص من عيوب كانت تجعله صعبا على قارئ
الصحيفة؛ ثم ظهرت حركة ترجمة للروايات العالمية، التي أقبل عليها القراء؛ فأثمر
ذلك كله أن بدأت إرهاصات الكتابات الروائية. ويسجل التاريخ الأدبي أن " زينب "
– 1914، لمحمد حسين هيكل، هي أول رواية في الأدب العربي الحديث، يتوفر لها
الشكل الأقرب إلى الاكتمال الفني. لقد تأثرت الموجة الأولى من الروائيين
المصريين، والعرب عامة، بالحياة والأدب الأوربيين، بدرجات متفاوتة، حسب الخبرة
الفردية بهذين العاملين؛ وقد صــوّرت المرأة في إنتاج هؤلاء الرواد الروائيين
على أنها مجرد مخلوق جميل، يثير المشاعر، نبيلها أو خبيثها، على حد سواء، دون
أن يكون لها كيان مستقل. كما أن معظم هؤلاء الأدباء قد تفادوا تقديم وتصوير
المرأة المسلمة في رواياتهم، حتى لا يتعرضوا للتقاليد الإسلامية؛ ولجأوا إلى
اختيار بطلاتهــم من بنات وسيدات الأقليات. وحتى " زينب "، بطلة هيكل، لم يوفق
المؤلف في إحكام رسم شخصيتها بحيث يقدم لنا بطلة مصرية حقيقية، عاشت في بداية
القرن 20، فجعلهـا أشــبه بشخصيات القرن التاسع عشر التي صورها ( جي دي موباسان
) في رواياته و ( لا مارتين ) في قصائده؛ إذ كانت زينب، الفلاحة ابسيطة، التي
تنتمي للطبقة الكادحة، تتحدث برقة مفرطة، وبمفردات غريبة على لسانها الأصلي، عن
الحب الذي يفضي إلى الموت عشقا !
وقد تباينت أنماط الشخصيات النسائية التي وردت في الروايات التالية
لزينب؛ فمعظم من جاءوا بعد هيكل قدموا شخصيات نسائية، من الريف والمدن المصرية،
ضعيفة وخاضعة تماما للرجل، يحميها أو يستغلها. أما ( العقاد )، فقد صور بطلته
اليهودية " ســـــارة " - في الرواية التي تحمل اسمها، 1938 - كامرأة مخادعة،
كاذبة، خائنة؛ وعلى العكس منه، جاءت بطلات كتاب مثل محمد عبد الحليم عبد الله،
ويوسف السباعي، نساء مثاليات، ملائكيات الطباع.
ويهمنا، في هذا السياق، أن نشير إلى الفقرة الأخيرة من صفحة 22، التي
تحتاج إلى مراجعة من المؤلفة، لأن صياغتها تصور للقارئ أن نجيب محفوظ جاء في
جيل تال لمحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف السباعي، ونعتقد أن ثلاثنهم من نفس
الموجة.
كما نلاحظ، في هذا المجال، أن المؤلفة، في هذا الاستعراض التاريخي
السريع، لم تشر إلى إحسان عبد القدوس إلا في سطر واحد - صفحة 22 أيضا - بالرغم
من أهمية هذا الروائي الكبير، الذي استأثرت الشخصيات النسائية بكل إنتاجه،
وبالرغم من رؤيته الخاصة لقضايا المرأة، الأمر الذي كان من شأنه – بالمقارنة -
أن يزيد من درجة تجسيد رؤية نجيب محفوظ الاجتماعية لهذه القضايا. وتنسحب هذه
الملاحظة، أيضا، على روائي عملاق آخر، هو يوسف إدريس. ولعل المؤلفة تعود فتقدم
لنا مؤلفا آخر يغطي هذه المنطقة، التي نتفهم أن عدم توقفها عندها ربما كان
استجابة لحرصها على إحكام تصميم وبناء بحثها الأكاديمي، ومن ثم كتابها، الذي
استهدف - بالمقام الأول والأخير، وكما يقول عنوانه المحدد - الإنتاج الروائي
لنجيب محفوظ وحده، وفي نصف مسيرته الإبداعية، التي امتدت لخمسين سنة، أطـــال
الله عمره.
لقد كان ظهور نجيب محفوظ، في الأربعينيات من القرن العشرين، نقلة مؤثرة
في تاريخ الرواية العربية، إذ استطاع هذا الكاتب العبقري - خلال النصف الثاني
من هذا القرن العشرين - أن يخرج هذه الرواية من الإقليمية إلى آفاق العالمية،
لأنه نجح في نقل الواقع الاجتماعي المصري، دون أن يقلد تيارا خارجيا، وإن كان
استفاد كثيرا بالتقانيات البنائية للرواية. لقد جعل محفوظ من الرواية سجلا
اجتماعيا لمصر الحديثة، إذ نقل - بصدق، وبدرجة عالية من الفن - واقع الوعي
المصري المعاصر، وتفاصيل الحياة اليومية الاعتيادية في حواري وأزقة القاهرة
المعزية.
وترصد المؤلفة البداية المبكرة لاهتمام نجيب محفوظ بقضايا المرأة،
فتشير إلى مقالة كتبها الروائي العربي الكبير في مجلة ( السياسة الأسبوعية )،
في العام 1930، وهو بعد في التاسعة عشرة من عمره، ويدعو فيها إلى ضرورة تعليم
الفتاة، بينما ينتقد خروج المرأة للعمل في دواوين الحكومة، لأن ذلك يؤدي إلى
انحلال الأخلاقيات في تلك الدواوين، ويزيد من حدة مشكلة بطالة الشباب، ويؤدي
إلى تفكك الأسرة. والواضح أن الشاب نجيب محفوظ كان متأثرا في آرائه هذه بالفكر
الاجتماعي المتحفظ الذي ساد تلك الفترة. كما تدلنا المؤلفة على مفتاح يجب وضعه
في الاعتبار عند التعرض بالدراسة لإنتاج نجيب محفوظ، بعامة، يتمثل في ثلاثة
تواريخ هامة، أثرت في محفوظ على نحو خاص، وفي الشعب المصري عامة، وهي : ثورة
1919، فمحفوظ هو ابن هذه الثورة، التي أرضعته أساسيات الوعي السياسي
والاجتماعي؛ وثورة يوليو 1952، وهو من منتقدي هذه الثورة الأشداء؛ ثم هزيمة
يونية 1967، وهي محطة أساسية، ارتاد بعدها نجيب محفوظ آفاقا روائية مختلفة، في
مضامين رواياته وبنياتها، على السواء.
وكان من الطبيعي أن تتجاوز المؤلفة مرحلة الإنتاج التاريخي لمحفوظ (
رواياته الثلاث: عبث الأقدار – 1939؛ ورادوبيس – 1943؛ وكفاح طيبة – 1944 )،
لأنها لا تخدم صلب قضية كتابها؛ وإن كانت توقفت أمامها، من الوجهة الفنية، إذ
كانت هذه الروايات بمثابة حقل لتجريب ( الواقعية الحديثة )، التي اعتمد عليها
محفوظ في كتاباته التالية، والتي خدمت نظرته الاجتماعية؛ إذ أن تلك الواقعية،
كما أسس لها الناقد الألماني " باتريك أوبرباخ "، تهتم برصد وتصوير صعود تجمعات
بشرية، ذات وضع اجتماعي متدن، إلى مستويات أعلى، بكل ما يصاحب هذا الصعود من
مشاكل وجودية، وملابسات تخلقها تفاعلات هذه التجمعات في المجرى العام للتاريخ
المعاصر.
وبعد فشل ثورة 1919، نجح محفوظ في نقل مشاكل الطبقة المتوسطة - وهو
ينتمي إليها - من خلال شخصياته الروائية، التي انتقاها بعناية فائقة، ومنها
الشخصيات النسائية؛ فاختار نساء عاديات من تلك الطبقة، يتوفر فيهن الصدق الفني،
وكن مطابقات تماما للواقع الاجتماعي، وإن اختلفن من رواية لأخرى، حسب المهمة
المطلوبة من كل شخصية على حدة، في خدمة البناء الروائي، ومدى نجاح الكاتب في
استخدامها لتوصيل معلومات إلى القارئ، وتجسيد حقائق الأحداث والشخصيات الأخرى.
وكان بعض الشخصيات النسائية بمثابة المحور لمعظم روايات نجيب محفوظ،
مثل ( حميدة )، في " زقاق المدق "؛ و ( نفيسة )، في " بداية ونهاية "؛ وهما
شخصيتان شاردتان، خرجتا عن التقاليد وانحرفتا.
وبدأ نجيب محفوظ، بعد يوليو 1952، مرحلة جديدة في مسيرته الروائية،
وكانت مرحلة نقد مجتمع ما قبل الثورة قد انتهت بالثلاثية؛ ويقول محفوظ، في
مقابلة صحفية : " بعد انهيار مجتمع ما قبل الثورة، لم يعد لديّ الرغبة في نقد
ذلك المجتمع ". والواقع، أن التتابع السريع للأحداث أخذ الكاتب الكبير إلى أراض
جديدة من الرؤى الفكرية والاجتماعية؛ وظهر ذلك في إنتاجه الجديد، الذي بدأ
بروايته الشهيرة ( أولاد حارتنــا ) – 1959؛ وقد جاءت بعد سبع سنوات من تحسس
واستكشاف ما جري في المجتمع، بعد الثورة. وقد أخرجت المؤلفة هذه الرواية من
دائرة اهتمامها، عند إعدادها لهذا الكتاب، وذلك لأن لها طابعها الخاص؛ كما أن
المرأة فيها لا تمثل نوعية المرأة المصرية، بل هي رمز عام للمرأة منذ بدء
الخليقة؛ وإن كان محفوظ قد بدأ بهذه الرواية منهج النقد الاجتماعي، الذي تبدى
بأوضح صوره في روايات المرحلة التالية : اللص والكلاب، 61 – السمان والخريف، 62
– الطريق، 64 – الشحاذ، 65 – ثرثرة فوق النيل، 66 – ميرامار، 67.
ويحسب للمؤلفة اهتمامها برصد التطور الفني في البناء الروائي عند نجيب
محفوظ، وارتباطه بتطور الشخصيات النسائية، محور بحثها؛ إذ أن ذلك أعطي لهذا
العمل قيمته كدراسة نقدية، ولم يقف به – كما في كتابات عديدة مماثلة عن نجيب
محفوظ - عند حدود الرصد الاجتماعي؛ كما يحسب لها أنها لا تقدم لنا ملخصات
لروايات محفوظ، لمجرد ملء فراغ الصفحات، كما يفعل كثير ممن يتعاطون الكتابة
النقدية، ولكن استعانتها بالنصوص المحفوظية كانت تجيئ من خلال رؤى تحليلية لهذه
النصوص، لخدمة غرض البحث.
وفي الجزء الثاني من الكتاب، المخصص للدراسة التفصيلية للشخصيات
النسائية الثلاث : نفيسة، ونور، وزهرة، اتبعت المؤلفة منهجا أسمته ( تتبع
المسار الروائي للشخصية )، وذلك من خلال :
= تحديد الإطار النفسي للشخصية.
= رسم المسار الحياتي لها.
= التوقف عند نهاية المسار الحياتي.
وقد استدعي هذا التتبع للمسار الروائي للشخصيات الثلاث التعرض للتكنيك
وتطوره، فلم يعالج محفوظ الشخصيات الثلاث، كما أنه لم يكتب الروايات الثلاث (
بداية ونهاية – اللص والكلاب – ميرامار ) بطريقة واحدة.
وينتهي تحليل المؤلفة للمسار الروائي لنفيسة، بطلة ( بداية ونهاية )،
إلى أنها أفضل نموذج روائي للمرأة المصرية، من الطبقة المتوسطة، يجسد حياة تلك
الطبقة وأزمتها الاقتصادية الطاحنة، في فترة ما بين الحربين العظميين.
ويلفت نظر المؤلفة أن نجيب محفوظ شديد الاحتفاء بالنساء الخاطئات،
ويقيم على بعضهن أبنيته الروائية، كمحاور رئيسية، أما النساء العاديات، مثل (
نوال )، في رواية "خان الخليلي" – 46، فهن لا يحظين باهتمام الكاتب، إذ أنهن
مجرد إفراد متشابهات في قطيع، لا يصلحن لأن يقوم عليهن بناء روائي؛ أما إذا
شردت واحدة من هذا القطيع، هنا ينجذب إليها الكاتب، أو الراعي، الذي يترك بقية
القطيع، فهو مطمئن إليه، ويسعى خلف تلك الشاردة. وقد كانت ( نفيسة ) من
الشاردات، وكذلك ( نور )، بطلة اللص والكلاب.
إن محفوظ، في احتفائه بالضالات الشاردات، يجتهد أن يجعل القارئ
لرواياته يتعاطف معهن، ويتفهم ظروفهن التي دفعت بهن إلى الخطيئة؛ فالظروف
القاسية، كما يقول الدكتور طه وادي في كتابه ( صورة المرأة في الرواية المعاصرة
)، لا تجتث كل ما هو إنساني في الإنسان؛ بل يبقى دائما ذلك الهامش الإنساني،
بمأمن من تلوث الجسد؛ وفي كثير من الحالات، تبقي الروح محتفظة بجوهرها، على
درجة من النقاء. وهكذا، رسم نجيب محفوظ شخصية ( نور ) كامرأة ملوثة الجسد، نقية
النفس، قلبها من ذهـــب !. ولكي يصل محفوظ إلى درجة الصدق الفني المطلوبة لكي
يقنع قارئه بهذه الشخصية، تخلى عن منهجه الواقعي في بناء رواية اللص والكلاب،
واعتمد على الرمز وتدفق الذكريات ( الفلاش باك )، فنجح – كما تقول المؤلفة - في
أن يلف شخصية نور بدرجة من الغموض، وهو ما يتسق وشخصية المرأة البغي، في
الواقع، إذ يهمها أن تتخفى وتتنكر، فلا ترصدها أعين المجتمع المتحفز لإدانتها !
وتفرد المؤلفة لشخصية ( زهرة ) مساحة أكبر من تلك التي أعطتها لكل من
نفيسة ونور؛ ويسهل على القارئ أن يلمس انحياز الدكتورة فوزية العشماوي لزهرة
واحتفاءها بها، بالضبط كاحتفاء نجيب محفوظ بهذه الشخصية الفريدة في أدبه. ويأتي
تفردها من أنها أول فلاحة في الإنتاج الأدبي للكاتب الكبير، تتمحور حول شخصيتها
رواية كاملة من رواياته، فهو لم يتعرض للريف في مجمل أعماله، وإن اعترف بأنه
كان قد كتب رواية قديمة عنه، وأخفاها؛ وظل مخلصا للقاهرة المعزية، التي يعرفها
حق المعرفة؛ وحتى عندما رسم شخصية نازحة من الريف، مثل زهرة، جعلها تعيش بعيدا
عن مسرح رواياته الأثير، القاهرة القديمة، وأنزلها الإسكندرية، وهي مدينة
يعشقها محفوظ، ولكنه لا يعرفها معرفته للقاهرة.
ومن خلال التتبع للمسار الروائي لزهرة، تؤكد المؤلفة على أن محفوظ يرمز
بها إلى مصر. والحقيقة أن مصطلح ( الرمز ) لا يزال يكتنفه قدر من الغموض
والقصور عند كثير من المبدعين والنقاد والقراء، على السواء؛ وقد كنا – في زمن
مضى – نتسابق في البحث، مع النقاد، عن احتمال وجود رمز لمصر في أعمال روائيين
ومسرحيين، من أمثال محفوظ ونعمان عاشور وسعد الدين وهبة، وغيرهم؛ وكان بعض
الكتاب يتعمد، قسرا، أن يلصق صفة الرمز على بعض شخصيات هؤلاء، حتى تاه المعنى
الحقيقي للرمز. فهل توفر معني الرمز في ميرامار ؟؛ وهل كانت زهرة – كما تقول
الدكتورة العشماوي – رمزا حقيقيا لمصر، مكتملة أركانه الفنية ؟. هذا ما تؤكده
المؤلفة في دراستها التحليلية والمتعمقة لشخصية زهرة؛ وأحسب أن هذه من أكبر
الدراسات التي أفردت لشخصية واحدة في عمل أدبي، كتبت في الدراسات الأدبية
العربية.
تقول الدكتورة فوزية العشماوي أن زهرة تستحق أن تكون رمزا لمصر، أولا،
لأن نجيب محفوظ جعلها محورا لجميع الأحداث؛ وثانيا، لأنه رسمها ثائرة - - وقد
ثارت عدة مرات … ضد من حاولوا استغلالها، بعد وفاة أبيها ( تماما، مثل مصر، بعد
وفاة سعد زغلول، أبو الأمة المصرية، كما كان يوصف )؛ ثم إنها ثارت ثانية ضد من
أرادوا الاستفادة من ورائها، من الأجانب ( ماريانا، اليونانية، مالكة نزل
ميرامار )، والعجوز الإرستقراطي " طلبة مرزوق " ( تماما كمصر التي قامت بثورة
يوليو 52 )؛ كما أن مجمل الخطوات التي خطتها زهرة في مسارها الروائي موازية
لتلك التي خطتها مصر، بفضل ثورة يوليو.
ويهمنا أن نشير إلى أن المؤلفة أهملت التعرض للشكل الروائي الخاص، الذي
اختاره محفوظ لرواية ميرامار، حيث جعل الرواية تحكى من وجهات نظر متعددة
ومتباينة لشخصياتها، على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية والطبقية.
فهـــــل أسهم هذا الشكل في اكتمال شخصية زهرة، وفي ترسيخ قيمتها الرمزية في
الرواية ؟
وتنتهي الدراسة عند علامة تاريخية فارقة في تاريخ كل من الوطن، ونجيب
محفوظ .. عند العام 1967؛ فبعد هذا التاريخ، بدأ محفوظ مرحلة، أو عدة مراحل،
مختلفة تماما؛ وتمكن من شق طرق جديدة للرواية العربية؛ وارتفع حســـه النقــدي؛
وقد كان كل ذلك، فيما نحســــب، ضـــروريا، ومفيدا !.
الكاتبة: دكتورة فوزية العشماوي
الكتاب : المرأة فـي أدب نجيب محفوظ - المجلس الأعلى للثقافة –
القاهرة
أضيفت في07/06/2005/ خاص
القصة السورية
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

السيرة الذاتية النسوية : البوح والترميز القهري
( إننا حين ننحني على كتف نرسيس ،فإنما لنرى وجهنا، لا وجهه منعكساً على صفحة
ماء النبع ).
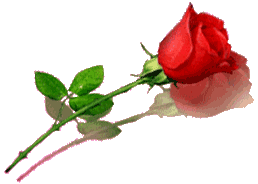 بقلم:
حاتم الصكر
بقلم:
حاتم الصكر
1- في سبيل التحديد: مقاربة نظرية لمفهوم السيرة الذاتية :
في حوار جديد مع فيليب لوجون
-أبرز منظّري السيرة الذاتية- أجرى هذا
العام، يؤكد "أن الكتابة السير-ذاتية هي أولاً ممارسة فردية وإجتماعية لا
تقتصر على الكتاب وحدهم"( )
إن هذا التوسيع لأدب السيرة الذاتية، يرتب إعادة النظر في مفهومها
ودلالاتها وينعكس دون شك في اشتراطات كتابتها ، وفي أعراف تلقيها وقراءتها.
وإذا كنا في أدب السيرة الذاتية العربية ، لم نحسم بعد ، تداخل الأنواع ضمن هذا
الجنس الأدبي الجديد على أدبنا ، والنادر فيه قياساً الى غيره ، فإن دعوة لوجون
الآنفة لن تجد صدى لها ، خاصة وهو يقترح ( العبور من السيرة الذاتية إلى
اليوميات الشخصية ) في إشارة إلى استيعاب كتابات الناس العاديين ، وتوسيع قناة
التوصيل لهذا النوع الكتابي ، كي لا
تنحصر في الكتابة فقط ، بل تمتد إلى وسائط
إعلامية مثل شبكة الانترنيت ، والرسوم المتحركة التي يرى إنها ستخدم بكونها رسم
صورة شخصية أو رسم حصيلة واصفة لها( ) .
واضح إذن إن إهمال كتابة السيرة الذاتية في أدبنا ، وقراءتها نقدياً ،
وحل مشكلات تجنيسها في إطار نظرية الأدب ، ستظل تشغلنا طويلاً ، وتحول دون
النظر في توسيعها أو إمكان تمددها ، كما يتقرح لوجون المنشغل منذ حوالي ثلاثين
عاماً في هذا الحقل .
إن السيرة الذاتية لا تزال من أكثر الأجناس الأدبية بلبلة ومرونة ،
وأصبح من المعاد المكرر قولنا بأنها جنس غير مستقر، وغير متعين بشكل نهائي،
حتى لتوصف أحياناً بأنها (جنس مراوغ) ( ) وبأن مصطلحها نفسه يكتنفه (غموض
واللبس ) ( ) وذلك متأت من جهتين:
1-قربها من أجناس وأنواع محايثة
كاليوميات والمذكرات والرسائل وقصائد السيرة ، والشهادات ، والحوارات
الشخصية ، واقتراضها بعض آليات عمل تلك الأنواع ، أو نظمها الداخلية ، وأشكالها
التي تأثرت هي أيضاً بالسيرة الذاتية .
2-الإكراهات والقيود التي تتحكم في كتابتها، وتجعلها تسرب مضامينها وأشكالها إلى
تلك الأنواع ، تحاشياً لعائديه السيرة الذاتية الى (شخص) كاتبها الواقعي ، وما
ينتج عن ذلك من أحكام وتقييم سالب للكاتب ، فيفر إلى ما يعرف مثلاً برواية
السيرة الذاتية، او يتخفف من بعض اشتراطات كتابتها ، كالسرد بضمير الغائب ، او
اللجوء الى التعديل والحذف. إن التعريفات المتداولة للسيرة الذاتية لا تخرج عن
تحديدها بأنها قصة حياة الشخص التي يسردها بنفسه ..
ولكن التـنـويعات المتقرحة سترينا تعدد المناظير وتشعبها، وسننتقي عدداً منها
هنا للتمثيل:
جبور عبد النور رواية حياة المؤلف بقلمه .. تحكي ماضياً بسرد متواصل ( )
والاس مارتن هي قصة كيف أصبحت حياة ما كانته ، وكيف أصبحت نفس ما
هي عليه( )
ديلتاي هي الصورة التي يتحقق فيها أقصى قدر من إدراك الحياة وفهمها ( )
جورج مش وصف لحياة شخص بواسطة الشخص نفسه ( )
فيليب لوجون حكي إستعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص ،
وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته ، بصفة خاصة( )
والاكتفاء بهذه التحديدات ( مع وجود غيرها لدى مجدي وهبة وإحسان عباس
وجورج ماي وليون أدل وسواهم ) نهدف منه الى بيان إمكان الخلخلة الأجناسية في
السيرة الذاتية وتداخلها مع سواها .
فالحاصل من العينات التحديدية المنتخبة يرينا ان السيرة الذاتية:-
-رواية / قصة / صورة / وصف / حكي / تاريخ
مما يسمح بدخول أعراف تلك الأجناس والأنواع ، وحضور جوانب من شعريتها
في موضوع السيرة الذاتية وشكلها أيضاً .
كما يترتب على التحديدات المنتخبة ووفق تعريفاتها انحصار السيرة
الذاتية بزمن ماض هو زمن الأحداث المستعادة ، وتحديد السارد بصاحب السيرة نفسه
والضمير المعبر عنه وهو ضمير المتكلم .
لكن ذلك الاطمئنان والوثوق في متن الحدود الآنفة ، سرعان ما يسلمنا إلى
(تعارضات) هائلة ..
فالزمن في السيرة الذاتية سيكون ثلاثي الأبعاد :
فثمة زمن ماض مستعاد هو زمن الأحداث ،
وزمن حاضر هو زمن الكتابة ،
وزمن غير متعين يلقيه وعي القارئ أثناء إنجاز فعل القراءة.
وأما الجانب اللساني ( روايتها بضمير المتكلم ) الدال على العائدية،
فيدخلنا في مأزق سردي، حيث سيكون ( التبئير على بطل السيرة شيئاً مفروضاً في
الشكل السير ذاتي)( ) بتعبير جيرار جينيت الذي يضيف في الموضوع ذاته بان السارد
السير – ذاتي غير ملزم بأي تحفظ بازاء ذاته ، والتحدث باسمه الخاص ، بسبب تطابق
السارد مع البطل ، لكن جينيت يثير المشكلة من زاوية ( وجهة النظر ) حيث ان
التبئير الوحيد من وجهة نظر السارد – البطل ، يتحدد بالعلاقة مع معلوماته
الحالية كسارد ، وليس بالعلاقة مع معلوماته الماضية كبطل، أي أن اتجاه السرد
لا
يبدأ بشكل خطي ، كما هو في الحياة التي عاشها في الماضي ، بل الحياة التي
يرويها ( الان ) كجزء من ماضيه .
سيكون لدينا إذن عند التدقيق في موضع المتلفظ المحدد بضمير المتكلم ثلاثة أنواع
من الأنا تندرج في المتن السير- ذاتي هي:
1-أنا المؤلف الحقيقي او الكاتب المعلن صراحة وفق الميثاق أو التعاقد السير-
ذاتي بأنه صاحب التلفظ المندرج في المتن .
2-أنا السارد المتموضع في متن السيرة الذاتية ، بكونها سرداً ذاتياً، وإحتكاماً
الى التبئير الذي سينفرد به .
3-أنا الكائن السيري الذي سوف يتعين بأبعاد محددة نسبة الى الأفعال والوصف
والمحددات السردية داخل العمل نفسه ( ).
تلك الأنوات التي يختلط فيها النحوي بالكتابي والسردي تدعو إلى السؤال
عن إمكان التطابق بين المؤلف والشخصية والسارد، أو عبارة ( أنا الموقع أدناه )
كما يلخص لوجون( ) الذي يعد هذا التعارض مناسبة لمقابلة السيرة الذاتية
والرواية ، وهو ما سنحاول نفيه أو إقصاء الرواية حتى بتسميتها (رواية سيرة
ذاتية ) من الشكل المقترح للسيرة الذاتية.
إن تلازم الانوات الثلاثة ضرورية في إنجاز برنامج الكتابة السير- ذاتية
كي لا
يجري الخلط بينها وبين الرواية او أشكال السرد الذاتي الاخرى التي يكون
فيها الراوي مشاركاً او داخلياً .. متلفظاً بضمير المتكلم .
ولنعترض أولاً على التخفف من شرط تطابق المؤلف والسارد والكائن السيري
(الشخصية) بالتجوز في إستخدام ضمير الغائب ( كما فعل طه حسين ) في ( الأيام)
مثلاً ، فذلك يدل على تعارض واضح يسبب خللاً سردياً يبتعد فيه السارد عن
الشخصية ، والمؤلف عنهما معاً بالضرورة ، ولا يخفى أن وراء ذلك التخفي أو
التقنع بضمير الغائب سبباً اجتماعيا يحاول الكاتب بفعل ضغطه ان يبرأ من عائديه
الأفعال إليه .. ولا يمكن ان نقتنع بالدفاع عن هذا الموضع النحوي والسردي
بالقول إن (الأيام) ( قد استخدمت ضمير الغائب ، وخلقت مسافتها بين الذات
الراوية والذات المكتوبة لترهف وعينا بهما معاً ، ولتكشف لنا ان حساسية
(الفتى) المفرطة وكبرياءه الشخصي منذ الطفولة هما عماد ثقة هذه الذات ...) ( )
أو نرضى في تبرير استخدام ضمائر مختلفة لكاتب السيرة ( ضمير المتكلم – ضمير
الغائب) بالقول إن ذلك يتم ( لنقل أبعاد متعددة ) من الشخصية و ( مراحل من
العمر ) أشبه بعملية اقتراب وابتعاد تساعد على الإلمام بكافة جوانبها ( )
فالضمير انا في السيرة الذاتية لا يعجز عن تمثل ثم تمثيل (الأبعاد) و (المراحل
) ومن ثم الإلمام بجوانب الشخصية كافة .. ولا تكون (الرهافة) سبباً جمالياً
كافياً لإقناعنا بالكتابة السير –ذاتية بضمير الغائب ، بل لعل ضمير المتكلم
ينجز تلك المهمة بجدارة أكبر نظراً لإلصاقه بالذات بشكل حميمي.
لكن ذلك ليس المأزق الوحيد في تداخل الأجناس ، إذ ترتب عليه قيام بعض
النقاد بتعقب الأعمال الروائية للكتاب والكاتبات ، والبحث عن كسر او أجزاء
ذاتية ، تقدمها القراءات النقدية على إنها سير مهربة او غير مصرح عنها ... وهو
ما يعرف برواية السيرة الذاتية وذلك خطأ لا نوافق عليه ، ونرى أنه يعيد مقولة
(الانعكاس) وتعبير العمل الروائي عن حياة صاحبه بالضرورة ، بإغراء ضمير السرد
الأول ( ضمير المتكلم ) ، أو إستحضار معلومات او إستنتاجات غير نصية ، تذكرنا
بالمنهج البيوغرافي وإسقاط حياة الكاتب الفعلية على المتخيل السردي ، وهو ما
حاولت المناهج النقدية الحديثة مقاومته وإقصاءه لصالح قراءات تستند إلى النص،
وتنطلق منه بعيداً عن المعلومات الخارجية أو التاريخية . ولا نريد ان تزحف
التفسيرات الخارجية على النصوص من جديد ، حتى لو كانت بحجة خصوصية الإبداع
العربي ، وقوة الموانع او الكوابح السياسية والاجتماعية التي تدفع الكاتب (
إلى كتابة "سيرته الذاتية" تحت مسميات إجناسية أخرى) ( ) إن (قصد) المؤلف
وتجنسيه المسبق لعمله سيكونان من موجهات القراءة التي تستحضر أعراف جنس أدبي
أخر هو الرواية ، حتى في حال اعتقاد القارئ بوجود التطابق بين شخصية الكاتب
والسارد والبطل ، فتلك الحدوس التي تخلقها القراءة ، تضعف بفعل الاستجابة لخبرة
القارئ في قراءة النوع الروائي نفسه ، أي ان استقباله للعمل سيتوجه بالتجنيس
الصريح على الغلاف ، فيستحضر ذخيرة قراءته وفق ذلك ، ويعيد إنتاج المقروء في
فضاء المتخيل السردي للرواية. وفي هذا المجال يفرق فيليب لوجون بين خاصتين : (
التطابق) في ميثاق السيرة الذاتية بين السارد والشخصية ، و (التشابه) الافتراضي
في العمل الروائي وهو من صنع القارئ ( ) إن السيرة الذاتية كميثاق او عقد قراءة
تحتم التطابق بين المؤلف والسارد والكائن السيري ، وهو بذاته أمر مقلق لا يمكن
التيقن من مفرداته تماماً ، وهو موضوع شك دائم ، فالصدق المطلوب غير مؤكد في
كتابة السيرة الذاتية لأسباب صارت معروفة ، فكيف يمكن الوثوق من بعد ، بعمل
تخييلي كالسرد الروائي ليكون ضمن جنس السيرة الذاتية؟ ولعل ذلك يبرر إستبعاد
السيرة الذاتية نفسها من مجال الدراسات النقدية عند استخدام الدارس لها من أجل
إضاءة حياة المؤلف والبحث عن وظيفتها الأدبية كما يرى توماشيفسكي والشكلانيون
الروس عامة ( ).
وذلك يسمح بقراءتها منعزلة كعمل إبداعي له خصائصه ومقاصده المنفردة ،
خاصة إذا عرفنا ما تتعرض له السيرة الذاتية من إمكان الخطأ أو التصحيف المتعمد
كالنسيان او التناسي ، والحذف والإضافة ، والتعديل والتكييف ، وإكراهات الوعي
القائم زمن الكتابة والاسترجاع اللاحق للأحداث، فكتاب السيرة الذاتية كما يلاحظ
والاس مارتن ( يتعرضون للخطأ بقدر ما يتعرض له الناس الآخرون ... ويسلطون على
أنفسهم أحسن ضوء ممكن طامسين بعض الحقائق ، مخفقين في التعرف على أهمية حقائق
أخرى ، وناسين وقائع...)( ) ويسرد مارتن ما يراه متغيرات تمنع تقديم صورة ثابتة
لحياة الكتاب منها ما يتعلق بالنفس التي تصف الأحداث حيث تتبدل منذ تجربة
الأحداث ومنها ما يتعلق بالأحداث وقيمتها في زمن استرجاعها وكتابتها ( ).
يظل (الصدق) في السيرة الذاتية كحد أخلاقي ( مجرد محاولة ) ( ) يحبطها
او يحد منها زمن الكتابة ، كما ان فعل الاسترجاع والاستعادة بواسطة الذاكرة
يتمان في الحاضر ، ذهاباً الى الماضي بطريقة الانتقاء او الاختيار التي تسميها
يمنى العيد (الاستنساب) وعجز الكتابة عن استعادة كل أبعاد المحكي بل إجتزاء
وأحياناً تقديم وتأخير الوقائع كما يقتضيه السياق ( ).
إن ثـقل الماضي رغم كثافته سيكف إزاء ضغط الحاضر وتشكل الوعي في فضائه
وضمن إطاره ، بحيث أصبح التخلص من زمن الكتابة (الحاضر) ليس إلا وهماً فلا
يستطيع الكاتب السير – ذاتي (التخلص من الحاضر الذي يكتب فيه، ليلتحم بالماضي
الذي يرويه)( ).
سيلجأ الكاتب إذن الى ما يسميه النقاد ( خلق الماضي)( ) الذي يعز على
الإستعادة رغم استنفار آليات الذاكرة ومسراتها في ( الإستحضار) لتفعل فعلها
وتؤلف قصة حياة( ) .
تلك المحاذير والشكوك لا تنفي الحاجة الى كتابة مزيد من السير الذاتية،
والاحتيال على تعارضاتها (اللسانية والزمنية والسردية والأخلاقية ) ولا تنفي
الحاجة الى معاينتها، فالفضول الذي يشد القارئ إليها يجعله منجذباً الى قراءتها
، ومنهمكاً في تعديل موقعه ليقرأها وفق إشتراطاتها المفترضة أو المتحققة ،
فالسيرة الذاتية ليست رقشاً للذات فحسب بعبارة صبري حافظ بل هي رقش للقارئ في
ثنايا النص( ).
هذا القارئ ذو الفضول سيحاول إنجاز فعل المشابهة ، بينه وبين السارد او
الكائن السيري، بفعل المشاركة والتجارب المتماثلة ، كما يحاول أن يملأ فراغات
النص أو (المسكوت عنه) ( ). بفعل إعادة ترتيب الأبحاث وفق متنها لا مبناها الذي
ظهرت عليه في السيرة ، ولعل ذلك جزء من مكافأة القراءة ، ومتعتها ، وإنجاز طلب
( الاعتراف) والقبول الذي ينص عليه ميثاق السيرة الذاتية وطابعها التعاقدي وهو
اعتراف لايتعلق بنص الكاتب فحسب بل بشخصه وحياته( ).
إن السيرة الذاتية كعمل مرجعي تستلزم في قراءتها تلك الإكراهات التي لا
تقل ثقلاً عن كتابتها ، كالصدق ومطابقة الوقائع، والتيقن من الذاكرة ، وإسقاطات
الحاضر على زمن الأحداث ، والرقابة الذاتية والخارجية ، وغياب الحرية ، وتغيرات
النفس والحدث ، تحضر كلها في ميثاق ثانوي لكنه مهم ، أعني قراءة السيرة الذاتية
التي لاتقل أهمية في إنجاز شعرية السيرة الذاتية عن فعل كتابتها.
ويمكننا لإنهاء هذا المقترب النظري ان نجرد الأشكال الآتية كخلاصات :
1-الأنواع المحايثة للسيرة الذاتية
رواية السيرة الذاتية المذكرات اليوميات الرسائل الشهادات
المحاورات قصيدة السيرة الذاتية.
2-(الأنا ) او ضمير السرد في السيرة الذاتية
أنا المؤلف أنا السارد انا الكائن السيري
=(الكاتب) =(الراوي) = ( الشخصية)
3-الزمن في السيرة الذاتية
4-محاذير تمنع من وجود سيرة ذاتية نموذجية
الكذب الخطأ الرقابة النسيان التناسي التبرير التعديل
الإسقاط الإضافة الحذف الانتقاء الصمت
2-أفق
السيرة الذاتية النسائية ومحدداتها :
سيكون من المناسب أن ننيب عنا كاتبة امرأة لنسأل عبر تساؤلها ( هل
هناك سيرة ذاتية نسائية ؟) ( ) مادمنا في المقدمة النظرية عن السيرة الذاتية قد
أوردنا مخاوفنا المبررة من إمكان وجود سيرة ذاتية نموذجية أصلاً، بغض النظر عن
جنس كاتبها / أو كاتبتها.
إن هناك تناظراً بين عودة السيرة الذاتية كجنس أدبي من هامش اهتمامات
الكتاب والقراء إلى مركز اهتمامهم ، و بين إسهام المرأة التي هي جزء من هامش
اجتماعي بحكم موقعها وعلاقاتها وعملها والوعي بدورها ... فكأنما أصبح التناظر
متحققاً عبر الاهتمام بالسيرة الذاتية كتابة وقراءة ، والاهتمام بكتابة السيرة
الذاتية النسوية .
ولكن المرأة سيكون لها حضور ( خاص) داخل الجنس السيري المستعاد من
الهامش ، ينعكس في خصوصية تجربتها ذاتها ، المتشكلة تحت وطأة ظروف لا تماثل
ظروف تجارب الرجل كاتب السيرة .. فهو يكتب في مجتمع ذكوري ، ساهم باعتباره
رجلاً في صياغة لغته وخطابه وأعرافه ، فيما تكتب المرأة في المجتمع الذكوري
ذاته ، كصوت هامشي مضغوط أو مقموع ، مما يلون سيرتها الذاتية بالمزيد من
المحذورات والمحظورات والإكراهات التي تعاني منها السيرة الذاتية عامة (وكما هو
مبين في القسم الأول من الدراسة) .
ولكن هذا الضغط والقمع المضاعف للمرأة ، سيهبها فرصة تشكيل خصوصية
أسلوبية وموضوعية في كتابة السيرة الذاتية ، وأبرز ملامح تلك الخصوصية ( تركيز
الكتاب على البعد العام لتجاربهم ( حياتهم المهنية وعلاقتهم بالمجتمع ) في نصوص
تعتمد على السرد الزمني ، وتناول الكاتبات البعد الخاص في أسلوب قصصي يلجأ الى
التشظي)( ).
فضلاً عن هذا التشخيص النقدي يمكننا التركيز على الدوافع وراء كتابة
المرأة لسيرتها الذاتية، تحت وطأة تلك الظروف التي تسهم في تشكيل وعيها
بوجودها. فالشاعرة والباحثة زليخة ابو ريشة تتذكر أن أول درس في العربية تعلمته
من معلمتها هو إننا نخاطب بجمع المذكر حتى إذا كان الحضور المخاطبون من النساء
وكان بينهن رجل او ذكر واحد ، ثم كانت صدمتها حين قرأت إهداء إحدى زميلاتها
لكتاب ألفته جاء فيه ( في سبيل الأطفال ، رجال الغد وأمهاته..) ( ).
إن القهر الذي تعانيه المرأة يبدأ من اللغة التي هي جزء من خطاب يلبي
دوافع صانعه (الرجل) ، حتى أصبحت ( خارج اللغة) ، وترتب على ذلك ما هو أخطر
ثقافياً إذ تحولت المرأة الى ( موضوع ) ثقافي ، ولم تعد ( ذاتا) ثقافية أو
لغوية ( ).
فاللغة هي أولى المفردات الخاصة في السيرة الذاتية النسوية ، حيث تحاول
المرأة أن تؤكد وجودها كائناً سيرياً بتحويل ذاتها الى موضوع ، وتستخدم (
الأنا) للتمحور على الذات وتأكيد الوظيفة التعبيرية لعناصر الرسالة الأدبية ( )
لكونها مرسلة الرسالة ، وهذا ما ستؤكده السير المدروسة في القسم الثالث من
البحث.
يأتي بعد ذلك عامل أخر يتيح لنا القول بخصوصية السيرة الذاتية النسوية
، هو القهر الاجتماعي المتمثل في مصادرة اختيارات المرأة منذ الطفولة (حرمانها
من اللعب والظهور والتعليم)، ثم في الفصل أو العزل الجنسي في مرحلة الصبا ،
وتحديد حركتها ، وحرمانها من إختيار الزوج أو الدراسة أو العمل ، وفي بعض
المجتمعات سيكون النشر والظهور الأدبي من الممنوعات أيضاً.
أما العنف المسلط على المرأة من الرجال ( آباء وأزواجاً واخوة ) فيشكل
عائقاً اخر في تشكيل وعيها ، لاسيما وأن هذا العنف يتمدد ليشمل بعض القوانين
والمؤسسات ، وحتى في تعامل الأحزاب معها أحياناً ، كما سيرد في قراءة بعض
الشهادات لاحقاً.
إن غياب الحرية قد حوّل كتابات المرأة الى وسائل دفاعية ، فصارت
الكتابة النسوية – بتعبير نازك الاعرجي- دروعاً لا سهاماً( ) فتكتفي بالدفاع
دون إكتساب حق ما.
وأما الجسد فليس له حضور ثقافي ، أي ان وعي المرأة به يتشكل وفق الصورة
التي يريدها المجتمع ، فهي مذخر أمومي للولادة والتناسل ، وكذلك لاداء الأعباء
اليومية في المنزل حتى يصح وصفها بأنها حارسة الهيكل المنزلي( ) بالإضافة الى
وطأة الزمن الذي تسجل فيه المرأة وجودها عبر تكرار دوري للحمل والأمومة بجانب
الأعباء البيولوجية التي تخلق وجوداً خاصاً بالمرأة يفرض تمايزها عن الرجل .
وسوف ينبني على ما سبق محاولة المرأة وسعيها لإيجاد لغة للخبرات
الجسدية الخاصة بها ، لغة تعمل على ( تبديل وتكييف) لما تسميه فرجينيا وولف
(الجملة السائدة) ولتصوغ من بعد جملة تأخذ الشكل الطبيعي لأفكارها ( ).
ويلتحق بما سبق من مفردات الأسرة ككيان ، والأب والأم كوصيين ، والحب
والزواج كعلاقات ، والولادة والموت كأحداث....
يتعين على الكتابة السير –ذاتية النسوية أن تتصدى لتلك المحددات ، لا
على سبيل التحدي وإنما كاستجابة لها كتحديات قد لاترد في برنامج السرد السير –
ذاتي الذكوري.
صحيح أن بعض الكاتبات يتجنبن الاحتكاك بالمسننات الاجتماعية ، وتضيع
معاناتهن بين الانجذاب إلى عالم المعاناة النسوية من جهة، ورغبة الكاتبة في
تقديم نفسها كاتبة..على قدم المساواة مع الرجل( ).
ولكن الكتابة السير- ذاتية النسوية ، تصبح مطلباً ثقافياً هذه المرة ،
أي إنها تتعدى أفق الإبداع الأدبي، أو التدوين الذاتي لأجزاء من حياة الكاتبة
بأسلوب سردي .. إن هذه السير الذاتية النسوية، ستكشف لنا عما هو أبعد من (ذات)
الكاتبة و(أناها) :هنا أيضاً ستدفع المرأة عن سواها، ما يجب أن يقدموه ، فتصبح
أناها (وذاتها ) معبراً الى (ذات) جماعية ، وتغذو سيرتها سيرة جماعية ، تشهد
على مجمل العلاقات في لحظة تاريخية ما ، ليس لأنها (تتعدى تجربتها الشخصية
لتعطيها بعداً اجتماعياً وتاريخياً)( ). ولكن لأن وضع المرأة هو المجس او
المقياس لدرجة وعي الجماعة لهويتها، من خلال شهادتها على مؤسسات المجتمع بدءاً
من العائلة ، فالمحيط والمدرسة، ومؤسسات الحب والزواج ، ثم العمل والإسهام
الفكري، وهي ملامح أساسية في تعيين هوية الجماعة ذاتها.
ولكن المرأة قد تنكص عن هذا الهدف الجماعي في سيرتها، استجابة
للمحذورات التي تحف بالسيرة الذاتية كجنس أدبي، فينخلق تعارض ثقافي / إبداعي ،
تكون السيرة نفسها ضحيتها وتفقد دلالاتها أحياناً كثيرة.
إن المرأة واقعة تحت وطأة الخشية من البوح ، وتحديد موقفها من الأخر –
الرجل – بمسمياته الكثيرة، ومن (الجماعة) بمؤسساتها ( المكرسة) ، ومن (ذاتها )
المنطوية على (جسد ) تجهله ، ورغبة لا تصرح بها ، وإختيار لا تجرؤ على الجهر به
، محفوفة بمتاعبها البايولوجية التي تزيدها نظرة الأخر حرجاً وشعوراً بالقمع .
إن السير الذاتية النسائية تسير في طريق شائك ملغوم ، أهون مافيه ان
المرأة تغدو ذاتاً أنثوية وقد تحولت الى موضوع( ) فهي المؤلفة – بقانون
العائدية والعقد السير- ذاتي، وهي موضوع السرد السير- ذاتي نفسه ، وهذا مظهر
ثانٍ لتبدلات موقع الكاتبة ، حيث كان الموضع الأول للتبدل ، عبور ذاتها من
خصوصيتها الى دلالة جمعية على المستوى الثقافي ، فضلاً عن تبدل داخلي ثالث هو
تعبيرها عن جنس النساء عامة ، عبر اشتراكها معهن في أغلب جوانب المعاناة
والتعرض للكوابح ، وان جرى ذلك بدرجات متفاوتة أحياناً.
ولعل التبدل الأكبر- وهو الرابع – سيكون ضرباً من التعارض ، فالكاتبة
إذ تدون سيرتها الذاتية ، فإنها ستلجأ الى خطاب ذكوري ولغة تتسيدها جملة الرجل
ومفرداته ، فيكون عليها إذن (إبتكار) لغة أخرى ، لعلها اللغة الغائبة بتعبير
زليخة أبوريشة، اللغة التي تسودها أنا الكاتبة بشكل مركزي يلفت النظر( )، ويوجه
مسار القراءة من بعد، وهي لغة تبتعد أو تقترب بحذر من محددات حياتها، لتغذو –
وهذا خطر حقيقي – محددات لغوية ثم نصية ، لينتهي بها مطاف الحذر والخطاب السائد
الى محددات ثقافية ، فيكون الجسد مثلاً أمراً مسكوتاً عنه في تجارب سيرية كثيرة
، كتبتها نساء في مجالات العمل الثقافي المتنوع ، وكذلك يكون الموقف من
المؤسسات والتقاليد وأفق الحرية الذي يظل ابتعاده علامة على صعوبة إمكان السيرة
الذاتية النسوية.
إذن، أهناك سيرة ذاتية نسوية من بعد ؟
نعم . ولا !! فالسيرة الذاتية النسوية تتقدم – كالمرأة نفسها – من هامش
الأجناس الأدبية وهامش القراءة الى المتن منها ، ولكن بمصارعة المحددات
والتضحية بكثير من توقعات القراءة الآتية من خارج معاناة الكاتبة وعذاباتها ...
إن ما يزيد الطوق حول السير الذاتية النسائية ، ويغلفها هو عامل
القراءة التي لا تريد كفعل ينجزه ( قارئ) أن تريه ما يمكن تخيله نواقص او معايب
او تحديات لثوابته.. هكذا تغدو توسعة ( ذات ) الكاتبة وتمدد (أناها) إلى
الجماعة ، جزءاً من مبررات رفضها وتهميشها ثانية ، فكأن التكرار الدوري لوجود
المرأة البايولوجي سيفرض تكراراً دورياً أخر: طلوعاً من الهامش عبر السيرة
الذاتية وعودة الى الهامش نفسه ، عبر تهميش سيرتها أو فرض سنن وتقاليد تخلقها
قراءة القارئ الذي لا يمثل إلا مناسبة لعبور الخطاب ونفوذه ، لتكون القراءة
استعادة لوجود المحددات ذاتها... خاصة إذا ما امتد هذا القارئ قبل قراءته ، أي
حين يغدو قارئاً ضمنياً رقيباً على الكتابة. ( )
3- نماذج من الكتابة السير- ذاتية النسوية
1- سيرة فدوى طوقان : التجنيس المقصود
لعل (رحلة جبلية ... رحلة صعبة ) للشاعرة فدوى طوقان ، من نماذج
الكتابة – السير ذاتية النسوية المصحوبة بقصد مسبق ، فهي تضع هوية العمل ( سيرة
ذاتية ) تحت العنوان مباشرة ، في توجيه واضح لقارئها صوب استيعاب المقروء على
أساس آليات اشتغال هذا الجنس الكتابي، فضلاً عن إلزام نفسها باشتراطات هذه
الكتابة ، في الحد الذي توفرت عليه ولكن صفحة الإهداء التي تلي العنوان ستصيب
القارئ بخيبة أمل على مستوى أفق انتظاره للبوح والاعتراف المقترنين بتلقيه
للسيرة الذاتية، فهي تكتب في هذه الصفحة عبارة قصيرة لكنها ذات دلالة :
( لقد لعبوا دورهم في حياتي ثم غابوا في طوايا الزمن ) ( ) .
فدوى طوقان
إن إمضاء الشاعرة تحت العبارة ، وفي التمهيد للقراءة ، وعلى عتبات نصها
السير- ذاتي المجنس بشجاعة وصراحة على الغلاف ، إنما يقودنا عند تحليله الى
حضور مفردات سيرية كثيرة :
لعبوا- واو الجماعة – الذكوري- وهو الفاعل النحوي والدلالي معاً في الجملة.
حياتي – ياء المتكلمة التي يقع عليها فعل اللعب .
غابوا – المرور والعبور إلى الغياب ( موتاً أو فراقاً أو تخلياً ..).
الزمن – مفردة ظرفية تلتهم (الحياة) و ( الأعمار) وما جرى خلالها من أحداث...
إذن ستكون قراءة ( رواية ) حياة الشاعرة بقلمها كما تنص أبسط تعاريف
السيرة الذاتية ، منطلقة من الآخرين الذين ابتدأت بهم حياتها (لعبوا) وانتهت
أيضاً (غابوا) وكأنها ستقص علينا ما بين قوسي واو الجماعة الذكور ، صانعي
حياتها ومؤطريها .. وصانعي (سيرتها) ومؤطريها بالضرورة. وهذه الثنائية ستظل
تتحكم في سيرة الشاعرة التي يختلط فيها الشخصي بالسياسي، حين تقول :
( بين عالم يموت ، وعالم على أبواب الولادة ، خرجت إلى هذه الدنيا).
فهي تشير إلى انحلال الإمبراطورية العثمانية ، واحتلال الإنجليز لما
تبقى من فلسطين (ولدت الشاعرة عام 1923م في نابلس) ، ولكن ولادتها ذاتها كانت
مرفوضة ، فالأم حاولت إجهاض جنينها (الشاعرة فيما بعد ) وكانت ولادتها غير
مرغوب بها في الأسرة ، التي لم تهبها اسماً إلا بعد أيام ، بل لا تكاد – الأسرة
– تذكر الميلاد الحقيقي للشاعرة ، إلا وهي تستعيد الى ذاكرتها حادثة موت قريب
لها في السنة نفسها . كان على الشاعرة إذن ان تبحث عن ( ولادتها ) في الموت مرة
(أخرى) أي بين دورة الولادة والموت ..
وهذا الدوران السيزيفي يعززه العنوان (رحلة جبلية ...) فالوصف يحيل الى
صخرة سيزيف التي كان عليه أن يرفعها كل مرة عقاباً إلهياً يتسم بالديمومة
والتكرار .. ويؤكد المنحى السيزيفي قول الشاعرة " حملت الصخرة والتعب ، وقمت
بدورات الصعود والهبوط ، الدورات التي لانهاية لها )( ).
ولكن اصطدام الشاعرة بمفردة (الموت) وهي من المفردات البارزة في
الكتابة السير- ذاتية ، لم يمنحها طاقة البوح الكافية لإنجاز سيرة نموذجية ،
فهي تصارح قارئها –ونفسها ؟- بأنها لم تعرض إلا ( بعض زوايا حياتها، وأنها لم
تفتح خزانة حياتها كلها) ( ) لكنها ستعرض بعض الحرمانات التي تمثل دورات
الانقطاع في حياتها مثل:-
-محاولة الأم التخلص من الجنين – الشاعرة فيما بعد .
-فقدان الاسم وتاريخ الميلاد.
-الإقصاء من حضانة الأم .
-إجبارها على التوقف عن الدراسة المنظمة .
-نهاية قصة حبها الأول .
-قمع موهبة الشعر وكتابته .
-التوقف زمناً عن الكتابة ( ).
يرافق ذلك ما تصرح به الشاعرة عن (قسوة الأسرة وسوء معاملتها وما وصفته
إنشائياً بأنه غرق (في بحر من اليأس). ( )
الى جانب الموت، والحرمان (أو الانقطاع) سيأتي ثالثاً عامل (الخوف)
الذي تقول إنه لازمها منذ الطفولة ، وتكرر في شكل أحلام تعاودها من أهمها حلمها
بأنها ترى نفسها تركض في زقاق مظلم هرباً من عجوز يلاحقها ولكن جداراً مسدوداً
يحول بينها وبين الهرب ، فتتحول الى زقاق أخر لتراه مسدوداً كذلك ، والعجوز
يلاحقها ، كوحش هائج ، فيما هي تلهث رعباً وتعباً ، لتستيقظ غارقة في العرق
واللهاث ( ) وتستوقفنا في الحلم بصفة خاصة ، الجدران التي تطالعها بشكل (دوري)
أي بالتتابع جداراً بعد أخر ، وزقاقاً مسدوداً بعد آخر.
وإذا تفحصنا الحلم متجاهلين تحذيرات إندريه موروا في (أوجه السيرة )
حول نسيان الأحلام بعد دقائق من يقظتنا مما تجعله يتساءل عن إمكان وجود
(الأحلام ) كعناصر قراءة في السيرة الذاتية( )، فإننا برغم ذلك سنتأكد واثقين
من الطابع السيزيفي للسيرة الذاتية لفدوى طوقان التي حاولت التعويض - بسرد
الحلم - عن مخاوف كثيرة قد يجد لها المحللون النفسيون معادلاً في مفردات حياتها
ذاتها .
والبدائل في سيرة فدوى طوقان كثيرة ، ليست الأحلام إلا إحداها، فهي على
مستوى الحياة ذاتها ، ستحاول اجتياز ( جدران) كثيرة : جدران ( الحريم )
و(البيت) و (المدرسة )... وبديلاً للعزل أو الفصل الذكوري حاولت الانسحاب الى
ذاتها (صرت لا أملك إلا التحديق في مرآة هذه الذات ... ) ( ) وبديلاً للحياة
المريرة ستحاول (الانتحار) لكن موت أخيها سيكون دافعاً آخر لمزيد في الحزن ،
حتى تأتي أحداث عام 1967م عام النكسة الشهيرة أو (الفضيحة) كما تسميها الشاعرة
فتخلد الى صمت طويل لا تكسره إلا بعد شهرين .
والتعويض سوف يسم علاقتها بالرجال كذلك ، فثمة أربعة رجال تأرجحت
علاقتها بهم بين الصداقة والحب ( دون بوح تفصيلي) ولم تنته كلها نهايات واضحة
بل على العكس لم يسعفها الحبيب عندما صدمها موت أخيها وهي في لندن، لأن كل
إنسان – كما تقول – ( إنما هو وحيد في شقائه وفي حزنه وفي موته )( )ولترميم
السيرة الذاتية وملء فجواتها، تستعين فدوى طوقان بالمذكرات والرسائل ، وتحاول
الخروج على التسلسل الزمني المتصاعد الخطّي الذي هو من مزايا السيرة الذاتية
التقليدية( ).
تظل سيرة فدوى طوقان شهادة على الأحداث خارج ذاتها أيضاً وهو ما سيؤكده
الجزء الثاني من السيرة الذي انشغلت فيه بسرد جماعي كانت للسياسة فيه وأحداثها
حصة كبيرة على حساب الشخصي والذاتي .
2- نازك الملائكة : اللمحات المهربة من سيرة لا مدونة :
تحت عنوان مراوغ ، تتخفى نازك الملائكة ، وتهرب من السيرة الى ما
تسميه (لمحات من سيرة حياتي وثقافتي ) يبدو إنها كتبتها استجابة لطلبات بعض
الباحثين وطلبة الدراسات العليا ، لكن قارئها يتسلم منها وعداً لم يتحقق ،
بأنها ترجو أن يتاح لها التفرغ لكتابة سيرة حياتها المفصلة بما فيها من الغرائب
الممتعة الكثيرة ( ).
ومن قراءة (اللمحات) السريعة نعلم ان الشاعرة توقفت عند مطلع
السبعينيات وهو عام صدور مطولتها الشعرية (مأساة الحياة وأغنية للإنسان) .
ونلاحظ ازدحام اللمحات بالتواريخ(الولادة –الدراسة – بدايات كتابة
الشعر – النشر – محاولة كتابة الشعر الحر – دراسة الفن واللغات الأجنبية- السفر
في بعثة لأمريكا لدراسة النقد الأدبي – التدريس – موت الأم- دراسة الماجستير في
أمريكا – زواجها – سفرها للعمل في جامعة الكويت- مؤلفاتها النقدية ... ) وهي
كما سنرى سيرة عامة أولاً ، وثقافية مهنية ثانياً ، لعل في غياب ( المذكرات )
التي دونت فيها خواطرها ، والتبدلات النفسية التي مرت بها ، ما يجعلها قليلة
القيمة لاتفيد إلا دارسي حياتها وعملها .
وسوف نستـثـني هنا بعض الندات المهربة عفوياً ، كحديثها عن اكتشافها ان
المذكرات ستخرجها من العزلة والانطواء:
"وقد اكتشفت أنني لا أعبر عن ذهني وعواطفي ، كما يفعل كل إنسان حولي،
وإنما الوذ بالانطواء والصمت والخجل ، واتخذت قراراً حاسماً : أن أخرج على هذا
الطبع السلبي ، وشهدت مذكراتي صراعاً عظيماً مع نفسي من أجل هذا الهدف، فكنت
إذا تقدمت خطوة تراجعت عشر خطوات"( )
وهذا يؤكد ما شخصناه في القسم الثاني من دراستنا ، حول موانع الخجل
والانطواء والصمت ، مما يحول دون إنجاز الكاتبات لسيرهن الذاتية، أو إخفاء ما
يكتبن من أنواع محايثة كالمذكرات واليوميات ...
ولعل أهم ما في اللمحات بعد ذلك ، هو الكشف عن مصادر ثقافة الشاعرة
التقليدية منها (في صباها)والحديثة ( بعد قراءاتها للشعر الغربي) لكن ( موت
الأم ) كان الحدث الأكبر في حياتها ، وقد روته مسبوقاً بحلم أيضاً:
"حلمت إنني أسير في شوارع لندن وأحاول شراء تابوت ملون وأبحث في لهفة
ورعب ولا أجد من يبيعني تابوتاً" ( ).
تتكرر إذن في (اللمحات ) رغم شحتها وإيجازها ، رموز كثيرة كالأحلام
والخوف من الموت والعزلة والتعويض ( أعتبر شخصياً اندفاع نازك لتعلم الإنجليزية
والفرنسية واللاتينية ودراسة العزف على العود والتمثيل تعويضات قهرية لما تسلط
عليها من ضغط بسبب ميولها التحديثية في الشعر ، وآرائها الأولى حول حرية المرأة
وعملها ووضعها الإنساني).
وفي مفردة الأسرة تحاول نازك أن تقدم مشهداً متصالحاً ، يشفع لها في
ذلك ثقافة الوالدين الأدبية (الأم شاعرة والأب باحث ولغوي) وجو الأسرة الأدبي
العام ، لكنها مع ذلك كانت تجد نفسها في عزلة عن الجميع ، آمنت بأنها هي التي
تحقق للكاتبة والشاعرة وجودها، رغم إنها ستميل لاحقاً الى الاندماج في الجماعة
عبر الهموم السياسية، والمعالجات القومية في شعرها للأحداث الكبرى في حياة
العرب لاسيما قضية ضياع فلسطين واحتلالها .
سنقف في اللمحات على ملمح أخر يلصقه الباحثون بالسيرة الذاتية النسوية
هو التركيز على (الأنا) كما بينا في الجزء الثاني من الدراسة ، وقد وجدت في
حديث نازك عن كتابتها لقصيدة الكوليرا التي تعدها القصيدة الحرة الأولى في
الشعر العربي الحديث ، ما يؤكد ذلك حيث تسرد وقع القصيدة على أسرتها عند
كتابتها واعتراض والديها عليها فتقول لهم :
"إني واثقة ان قصيدتي هذه – تعني الكوليرا - ستغير خارطة الشعر
العربي.. فكتب لقصيدتي أن يكون لها شأن كما تمنيت وحلمت في ذلك الصباح العجيب
في بيتنا".( )
ولكن القلق النفسي الذي أسلم نازك لفترة من الشك وعدم التدين بسبب هاجس
الموت وقسوته، لا نجد له صدى في ( اللمحات) وإنما علينا ان نتعقبه في وثائق
سيرية أخرى، كالرسائل ، فهي تصرح بأنها لم تكن متدينة ولا تقرأ القرآن أو تهتم
به ( لان عوامل كثيرة قد تجمعت في حياتي وشككتني في وجود خالف مهمين لهذه
الخليقة ، فنشأ في أعماق نفسي فراغ فاغر رهيب لا يملؤه شيء) ( ) لكنها تعود
لتؤكد في الرسالة المكتوبة مطلع عام 1978م أن ذلك القلق والشك والحيرة التي
دامت بين أعوام 1948و 1955م انتهت الى الإيمان بالله إيماناً كاملاً عام 1957م)
ولا تخفي في اكثر من مناسبة أن خوفها من الموت كان السبب في ذلك الشك "أما أنا
فلم تكن عندي كارثة أقسى من الموت ، كان الموت يلوح لي مأساة الحياة الكبرى ..
فقد بقيت ارفض مسألة فناء الإنسان أشد الرفض .. فأتعذب بفكرة الدود الذي
سيأكلنا والجماجم التي سنثير أليها..."( )
إننا لا نستطيع أن نعد الخوف من الموت مقصوراً على السير الذاتية
النسوية لكن الحديث عنه في رسائل نازك ولمحاتها ، يوحي بثقل الفكرة نفسها :
فكرة الموت إزاء العجز عن مواجهته ، هذا العجز الذي يضاعفه كون الكاتبة امرأة
مستلبة اجتماعيا في الأساس.
وأرى أن ذلك التحدي ولد عندها التحدي المضاد ، فكان تمردها على الطريقة
الخليلية في الشعر ، ورفضه للقيود الفنية على الشعر بحماسة وصلابة انعكاسا
لعجزها عن مواجهة الموت الذي أنهكها التفكير فيه .. على مستوى الخطاب تقع نازك
فيما يعرف تنميط صورة المرأة ، فهي تطلب الحماية من الجماعة ، وتعد عودتها
للإيمان، وخروجها من العزلة ، واهتمامها بالقضايا القومية ، جزءاً مهماً من
خلاصها ونجاحها في حياتها في سنواتها اللاحقة (النصف الأخير من الخمسينيات) بل
تستعير الخطاب الذكوري للحديث عن تلك المواقف والمواجهات ، وتسرد علاقتها التي
حددتها بالإعجاب والتأثر بالشاعر علي محمود طه، وكذلك بالرئيس الراحل جمال عبد
الناصر الذي تقول إنها أهدته عام 1962م كتابها (قضايا الشعر المعاصر)، وعلاقتها
بزوجها الذي تقول إنه كان لها " نعم الصديق والرفيق والزميل"( ).
يتحصل من سيرة الحياة المهربة لنازك إنها ظلت في إطار الصمت والبوح
المحدود وهذا أحد موانع إنجاز وعدها سواء بكتابة سيرة حياتها او بنشر مذكراتها
.. ولم تغن عن ذلك الغياب ما نشرته بعنوان (الشعر في حياتي) كمقال في مجلة.
3- غادة السمان : الاستجواب بديلاً للسيرة الذاتية :
في الكتاب الذي جمعت فيه غادة السمان ما أجري معها من حوارات ولقاءات
صحفية والذي أسمته (القبيلة تستجوب القتيلة) تصنف عدداً من الحوارات تحت عنوان
يحيل الى السيرة الذاتية هو (استجواب حول سيرة ذاتية)، وهو الفصل الثاني من
خمسة فصول (إستجوابية) حول المرأة والأدب والفن والحياة والعمل .. أجراها
كحوارات معها عدد من الصحفيين والصحفيات، ولتبرير التسمية تقول غادة السمان في
مقدمة الكتاب التي سمتها (مصارحة) :
"الفصل الثاني من الكتاب أسميته ( سيرة ذاتية) وجمعت فيه الاحاديث التي
تنصب مباشرة على حياتي الخاصة كإنسانة وعن علاقة ذلك بفني. هذا الفصل رتبته
وفقاً للتسلسل الزمني ولكن بدءاً بالماضي وانتهاء بالحاضر، فقد أحسست وأنا أعيد
قراءة أحاديثه إنني أقرأ حياتي موجزة في سلسلة محاولات .. وإن قراءتها بدءاً
بالماضي وإنتهاء بالحاضر له مذاق من يقرأ قصة مواطنة طموح ، والناس تحب قراءة
القصة ، وأنا أحب خلق المذاق القصصي في كل ما أكتبه أو حتى أرتبه وأبوبه " ( ).
وتدعيماً لهذا التجنيس المهرب من السيرة الذاتية كفعل يبدأ من الكاتبة
، لا بطريق الاستنطاق من الآخر المحاور او المحاورة ، فإن غادة السمان قدمت
للفصل الخاص بـ (استجواب حول السيرة الذاتية) بأربعة مقتطفات لكتاب عالميين ،
تتركز حول صعوبة كتابة السيرة الذاتية ، والتشكيك بذاكرة كاتبها ، وكونها
إملاء من لا وعي الكاتب.
الدلالات التي تعطيها معالجة غادة السمان لسيرتها الذاتية ، تنسجم مع
اعتقادها بان ما يطرح حول ( الأدب النسائي) مجرد ثرثرة تقليدية ، وحديثاً
تافهاً ( )، فلا شيء في أدب المرأة وكتابتها يستحق في رأيها خصوصية ما ، لذا
فهي نموذج للمرأة التي تقف ضد أنوثتها في خطابها وفي لغتها كما يرى عبد الله
الغذامي( ) لذا فهي تنتخب صوت (الآخر) محركاً أو مثيراً لتداعيات سيرتها . إن
المحاور (أو المحاورة ) ينبش في طيات ذاكرتها ، ويستنطقها ، ويستفزها ... رغم
موافقتها على أن الكسر والشذرات والتداعيات التي كانت المحاورات مناسبة لها، هي
(سيرة ذاتية) لها مواصفات خاصة، نجملها في الأتي:
1-تعبر عن ( حياتها الخاصة ) كإنسانة.
2-تعبر عن علاقة تلك الحياة بفنها – ككاتبة.
3-تخضع هذه (السيرة) الملفقة أو المجمعة من حوارات ، لتسلسل خطّي من الماضي الى
الحاضر، إعتقاداً منها بشرط السيرة التقليدي المعروف ( البدء من الطفولة...) .
4-هذا التسلسل يعطيها – أي السيرة الذاتية – صفة السرد القصصي..
5-تحسب الكاتبة أن ذلك يمنح القارئ (متعة) قراءة من نوع خاص ، لان سيرتها هي (
قصة مواطنة طموح) ! وذلك في ظنها ما يحب (الناس) قراءته.
6-تحقق لها هذه الطريقة متعة ( خلق المذاق القصصي) الذي تحبه، بتسلطها كساردة
على النص كما على الأحداث قبل تدوينها.
وعند الدخول في تفاصيل ومفردات الحوارات السير- ذاتية ، سنجد ( الزواج)
من المسائل الأكثر وروداً في النصوص ، فكيف تزوجت ( الفتاة المتمردة) و (أستقرت)
؟
ترد غادة السمان بأن الاستقرار عندها هو الموت فقط ، أما زواجها فتم
بصيغة ( غير تقليدية) كما تقول ، وتسهب في الحديث عن فترة حملها بطفلها الأول(
)وهي انتباهه لصالحها ، إذ لم تتحدث سير النساء الذاتية عن مثل هذه التجربة
التي صادرت قدرتها على الكتابة وخلقت هوة تسميها (أزمة صمت) لستة أعوام ،
مصحوبة بالخوف من الليل والظلام والنوم .
وعن طفولتها تعترف للمحاور بأنها بلا طفولة كأغلب بنات وأبناء جيلها،
والسبب هو قوة الأحداث التي عاشتها كمواطنة عربية، أما طفولتها ( الزمنية ) كما
تسميها فتتسم بالإرادة وضبط الذات( ). ونلاحظ هنا كمية الإسقاط والتجميل الذي
تجريه الكاتبة على طفولتها ومحاولة تناسي أو تجاهل وإقصاء الملامح الخاصة بها ،
لصالح ما يشيع عنها محاوروها من (قوة) شخصيتها ، وهو أمر يسم خطاب غادة السمان
بالانشطار: فهي متمردة، وزوجة، كاتبة وليست أنثى ـ وحيدة وناجحة دون دعم،
رافضة وواثقة، غادة السمان ومدام داعوق معاً، لكنها في استجواب أخر تطلق سراح
ذاكرتها وتستعيد نشأتها الأولى في دمشق وصباها وأسرتها وأصدقاءها، غير إنها
تشذب أيضاً كثيراً من مفردات طفولتها ، فالحكايات التي استهوتها صغيرة ليست
حكايات الجان والعفاريت، بل حكايات يرويها أبوها عن تحرير سوريا من الانتداب
الفرنسي، وعن دوره ورفاقه في دحر المستعمر ( ).
وإذا ما عدنا لتفحص إضراب غادة السمان عن كتابة سيرتها الذاتية إلا
بتهريبها عبر الاستجوابات ، وتذكرنا رفضها للمنظور النسوي الخاص في الكتابة ،
فلن نفاجأ بالابتسار والسرعة في سرد ذكرياتها وفترة تكونها خاصة ، حتى عند
الحديث عن غياب الأم المبكر وهجرتها الى لبنان وزواجها. وفي نموذج غادة السمان
يتجلى خوف الكاتبة من سيرتها الذاتية، انعكاسا لخوفها من البوح الذي تعرف ثمنه
وتخشاه .. لذا يتركز اتجاه إجاباتها حول الكتابة عادة وتأكيد ذاتها عبر أعمالها
، واجترار لغة الخطاب الذكوري الذي يند عفوياً في إجاباتها ( أكدح كأي رجل ،
وبوسعي إعالة نفسي وطفلي كأي مواطن آخر .. إنني مجرد مواطن عربي أخر من حقه –
بل من واجبه – ان يعمل ما يتقنه) ( ) .
وهكذا تشظت (السيرة الذاتية )التي وعدت بها الكاتبة قارئها، رغم أنها
جعلت حواراتها مناوئة للقبيلة أي لكيان الجماعة، ليتشظى منها ويتبدد نثارا
وعيها بذاتها، في ستار مضبب من الإجابات الإنشائية الهروبية، كهروب (الاستجواب)
صيغة وشكلاً من السيرة الذاتية جنساً وخطاباً ، فينخذل قارئ سيرتها الذي يصفه
فيليب لوجون في حواره الأخير بأنه "شخص يبحث عن لقاء وسحر ولوج وجود الآخر" (
).
4- المذكرات : نوال السعداوي سجينة وطبيبة :
ستكون (المذكرات ) صيغة هروبية أخرى ، تقترحها نوال السعداوي وهي (
تتذكر) أجزاء من كفاحها في الحياة – بسرد متصل يجعلنا نسمي ما كتبته (ذكريات)
وتداعيات وليس (مذكرات) بمعنى الرصد اليومي المنفصل للأشياء والأحداث .. فعنوان
(مذكرات طبيبة) لا يعد القارئ بعائدية خاصة ، إلا بعد ان يعلم داخل النص ان
الطبيبة هي المؤلفة والساردة والكائن السيري، وهي نوال السعداوي التي يعلو
اسمها غلاف الكتاب الخارجي ... بينما يكون ضمير المتكلمة في كتابها ( مذكراتي
في سجن النساء) وعداً بلقاء أو عقد سير- ذاتي بصيغة المذكرات التي لم تلتزم
الكاتبة بتقنيتها، أي لم تضع تاريخاً يعلو أو ينهي الفقرات ، بل قسمت المادة
المستعادة الى أجزاء ذات عناوين منفصلة.
في ( مذكرات طبيبة) ينقسم النص الى ستة أقسام مرقمة (من 1– 6 ) تبدأ
بالطفولة وبعبارة مستفزة .
" بدأ الصراع بيني وبين أنوثتي مبكراً جداً .. قبل أن تنبت أنوثتي وقبل
أن أعرف شيئاً عن نفسي وجنسي وأصلي .. كل ماكنت أعرفه في ذلك الوقت إنني بنت
كما أسمع من أمي . بنت ! ولم يكن لكلمة بنت في نظري سوى معنى واحد .. هو إنني
لست ولداً ... لست مثل أخي"( ).
إن هذا المقتطف يعني الكثير في تصنيف وعي نوال السعداوي بوجودها
وهويتها كأنثى ، فهي تعكس إحساس رائدات النسوية حول الإختلاف الجنسي ( لا
النوعي) بين الرجل والمرأة ، فالمرأة لا وجود إيجابي لها بل هي ليست الرجل
بالاحتكام الى التكوين البيولوجي والتقسيم الجنسي، ويغيب عن هذه النظرة (
التقليدية) الوعي بالهوية النوعية ( الجنوسة) التي هي أعمق من ملاحظة الاختلاف
الضدي ( رجل / امرأة ) .. وذلك يبرر استخدام الكاتبة لفظة (الصراع) مع الأنوثة
، كترحيل غير واع للصراع مع (الآخر) المضاد بثقافة النوع النسوي .. ويبرر كذلك
انزعاجها من بروز علامات أنوثتها ... وتتحكم النظرة نفسها في العلاقة مع الرجل،
فهي علاقة عدوانية تتسم بالخوف:
"رأيت عيني البواب وأسنانه تلمع وسط وجهه الأسود سواد الفحم ... وأحسست
بطرف جلبابه الخشن يلمس ساقي وشممت رائحة ملابسه الغريبة فابتعدت في اشمئزاز
ووقفت مذعورة واندفعت اجري بعيداً عنه" ( ).
وهذا النفور الطبيعي من الرجل بحكم الإحساس بالفارق الجنسي هو الذي
سيجعل الكاتبة تعترف أن دراستها للطب وتشريحها لجسد الرجل الميت كانت انتقاماً
لها من الرجل الذي تقول عنه:
( ما أقبح الرجل ! من خارجه ومن داخله أشد قبحاً ! ) ( ).
وحين تتحدث عن زواجها الأول ترينا مواضع (القبح ) التي تتلخص في (
السيطرة ) والتملك مما يجعل العيش بين الكاتبة وزوجها مستحيلاً ، فتعود الى
وحدتها منتصرة وتنشغل بعملها حتى تلتقي زوجها الثاني الذي تأوي اليه بعد أن
أحست بالفراغ والوحشة والصمت رغم الشهرة والنجاح .
إن السرد القصصي الممتع والمليء بالحوار الذي يؤدي دور مرور الكشف عن
طبائع الشخصيات وأفكارها ، لم يلغ حاجتنا الى ( سيرة ) ذاتية مجنسة، لا تقودها
رغبة تركيز الذات وإشباع تلك الرغبة عبر تجسيد الأحداث بصياغات سردية تضيع معها
شذرات الحياة ومفرداتها التي تستعيض عنها الكاتبة بالأفكار ، وتنميط الشخصيات :
(البواب) الرجل الأول، الصديق ، الأم ، الطبيبة ، الزوج الأول، الزوج الثاني،
لتسقط في أشد عيوب السيرة الذاتية خطورة : تنميط الشخصية لتبرير كراهيتها او
محبتها ، واجترار عناصر الخطاب المألوف في الحركة النسوية الأولى ، بل ان تحدد
هدفها بالبحث عن هوية مختلفة ثقافياً عن الرجل ، وليس المطالبة بالمساواة بشكل
تقليدي وانتقادي يتسم بالتعالي والاستنكاف .
وفي (مذكراتي في سجن النساء) يزحف ما هو إيديولوجي ليلتهم عناصر السيرة
الذاتية الأقل حضوراً منها في (مذكرات طبيبة)، ولكن مفردة (الحرية) اكثر حضوراً
في (مذكراتي) .. حيث تربط الكاتبة في مقدمتها القصيرة بين سجنها - كقهر وحجر
لحريتها– وبين ما عانته من اضطهاد ذكوري من الأخ والزوج والحاكم.
لكن الوصفة التي تقدمها الكاتبة حلاً تذكرنا بغادة السمان والانحصار في
شرنقة ( الكتابة ) كفن وتعبير تقول السعداوي: (لم يبق لي من سلاح في حياتي إلا
القلم . أدافع به عن نفسي، عن حريتي وحرية الإنسان في كل مكان .. ولا أتزين
كالحريم ولا أستحم بالشامبو الأمريكي...) ( ).
وتكون الأنوثة هنا ضد نفسها كما حصل مع غادة السمان ، والتمرد ضد
الأنوثة ذاتها كثقافة ، وتميز نوعي، هذا إذا شددنا على عبارة الامتناع عن
التزين كالحريم التي تتنازل فيها الكاتبة عن زينتها، واقعة تحت تأثير خطاب
الرجل دون وعي، إذ تعد تلك الزينة مطلباً ذكورياً ترفضه بالتخلي عنه!.
وبتكرار (الأنا) كضمير عائد لا للأحداث فحسب بل للطبائع التي تلصقها
الكاتبة بنفسها في معرض (امتداح) خصالها وتميزها عن الرجل ، تؤكد نزوعها الضدي
ذاك، وصولاً الى تفردها في (السجن) الذي صار مناسبة للتعرف على افتقاد الحرية
بالمعنى الحسي لا الرمزي، وكذلك لقراءة (أفكار) مجموعة من النساء السجينات،
تبالغ الكاتبة في تنميط شخصياتهن ليعبرن عن وجهات نظر وأفكار مع (أو ضد) المرأة
في حقوقها العادية كالسفور والغناء والضحك بصوت عال أحياناً! وهو أمر تربطه
الكاتبة بنموذج (الأم) أو نمطها فهي أيضاً مثلهن:
"حتى أمي كانت ترمقني بضيق أو كراهية حين تراني أرقص بفرح، كنت أظن أول
الأمر أنها لا تريدني أرقص، لكني أدركت فيما بعد أنها لا تريدني أفرح لماذا؟" (
)
إن ما تسميه (الاغتراب) لا يتوقف عند وجودها في السجن أو اختلاطها
بالرجال أيام دراستها، أو عملها وسط الأطباء، ويقودها ذلك لتذكر طفولتها وعيني
جدتها، لتقطع جدران السجن تلك التذكرات وتعيدها إلى الهم السياسي الذي كان
سبباً في دخولها السجن.
لقد كانت المذكرات نصوصاً سردية متقنة وذات وقع على قارئها الذي يتسلم
مدونة تحكي عبر المذكرات (التي هي الأخرى بلا تواريخ أو يوميات موثقة) ما أضمره
وعي الكاتبة، وما سمح به ليتسرب للقارئ..بينما اختفت عشرات المفردات السير
ذاتية كوجود مسكوت عنه، في شبه سيرة ذاتية تريد تقديم المرأة المكافحة نموذجاً
للرفض دون خطأ أو خطيئة.
5- فاطمة موسى: صفحات من دفتر الحياة:
(صفحات من حياتي) أو (أوراق حياتي) هي مسميات تهرب كسابقاتها من جنس
السيرة الذاتية المخيف باشتراطاته..لذا فإن ما سمته فاطمة موسى (صفحات من
الذكريات) هو شذرات من سيرة ذاتية، تتواضع معتذرة عن اختزالها بوصفها بأنها
(صفحات) وكأن ثمة دفتراً للسيرة تم انتزاعها منه...أما (الذكريات) فهي دون ما
تتطلبه السيرة الذاتية من نظام وفق التعاقد السيري المعروف، لأنها سوف تتخفف من
قوانين كتابتها من جهة، وتعتذر للقارئ عن غيابها من جهة أخرى.
كما تضمر التسمية الهاربة من التجنيس الصريح وعداً للقارئ بوجود (صفحات
أخرى) لعل فيها ما يبرر المسكوت عنه أو المحذوف والمغيب في المنشور للقراءة من
(الصفحات) مع ملاحظة التهرب من العائدية دون وعي ربما، إذ لا ضمير يعود للكاتبة
في الصفحات والذكريات التي احتلت عنوان ما نشر منها.
وهي تحيلنا إلى شعور قريب من (لمحات) نازل الملائكة، فهي تسرد فترات
دراستها وعملها، ودلالة انتظامها في قسم اللغة الإنجليزية رغم معارضة صديق
والدها، فكان انتسابها للقسم انتصاراً لرغبتها:
"من حسن حظي أني ولدت في أسرة هامشية لا يضغط عليها رأي عام من الأهل
والأقارب".( )
وكانت تلك مناسبة لسرد مهنة الأب وعمله بالتجارة، ووصف المنزل الذي
عاشت فيه طفولتها بتفاصيله الطريفة، وما يحيط به من أماكن.
الملاحظ أن فاطمة موسى وضعت عناوين فرعية للصفحات، هي عبارة عن تواريخ
ذات دلالة، كالثورة على الإنجليز في يناير 1952 والتي يجئ في سياقها حديثها عن
زوجها، وعيشها المتواضع كرفض لما تسميه "طقوس الزواج التقليدية".
"كان زواجنا بالطريقة التي تم بها..في نظرهم جنوناً..لا مهر ولا شبكة
ولا فرح ولاجهاز لائق ولا رصيد في البنك...نسكن في بدروم ونبدو سعداء بما في
بيتنا من رفوف مكتظة بالكتب، ولوحات غريبة تغطي الجدران" ( ) وتكشف الصفحات عن
أفكار فاطمة موسى حول المساواة الطبقية عندما تتحدث عن مربيات الأولاد والتغاضي
عن (غرابة أطوارهن)، ثم تعود لسرد انعكاس الثورة الشعبية والهيجان العام
للمصرين ضد الإنجليز، على القصر وقادة الجيش والساسة.
لقد اتضح لي أن الهروب من السيرة الذاتية المباشرة، سمح للكاتبة بعدم
الالتزام بالترتيب الزمني لأحداث حياتها، فقد اندمجت أو (تناثرت بالأحرى) بين
زخم الأحداث الأكبر التي عاشتها مصر، وكذلك فعلت مع أفكارها ورؤاها التي تتناثر
هي الأخرى بعد كل حادث أو موقف..رغم التزامها بضمير المتكلمة-شأن زميلاتها
كاتبات السيرة الذاتية أو تنويعاتها الممكنة.
6-رسالة من ليلى صبار..الإقامة في المنفى :
شأن رسائل نازل الملائكة القليلة المتسربة عن أصدقائها وزملائها، سنجد
في قراءة نموذج من رسائل ليلى صبار، الكاتبة الجزائرية المقيمة في فرنسا، كسراً
من السرد
السير- ذاتي، تضعنا مقدمة المترجمة (نهى أبو سديرة) في أفق تلق تعويضي
حين تقول:
"هناك (قصد) لكتابة السيرة الذاتية عبر نوع آخر من الكتابة عن الذات،
ألا وهو نوع الرسائل"( )
وتعد المقدمة هذا النوع من الرسائل المقصودة تعويضاً عن شيئين:
1-المذكرات اليومية لكونها حواراً مع النفس.
2-الحكي الشفوي لأنه لا يكفي للتعبير عن الأزمة.
والأزمة هنا مشتركة بين الكاتبتين: نانسي هيوستن (الكندية التي تعيش
المنفي الباريسي) وليلى صبار (العربية الجزائرية التي تعيش الوضع نفسه) وبذلك
غدت الرسائل نصاً من نصوص السيرة الذاتية بحسب المترجمة "حاولت البحث عن أساليب
غير تقليدية لكتابة حياة الذات عبر رؤية حياة ذات أخرى وهو حديث مرآوي يجعل
الشيء نفسه مختلفاً ومتماثلاً في آن واحد".( )
الرسائل –كخلاصة-هي سيرة منفى، ومناسبة متاحة لتذكر الوطن الأول: البيت
والأسرة والتعليم والعلاقة بالرجال، وأخطر ما في رسالة ليلى صبار، وهي (الثالثة
عشرة) في سلسلة مراسلات تضم ثلاثين رسالة، شعورها بأن "الأمية تتهددها ..أمية
الإحساس والمشاعر"( ) في إشارة ذكية إلى الغربة اللغوية التي تعيشها في المنفى
الباريسي.
وأظن أن هذا هو التنويع الأساسي في الرسائل إذا ما وافقنا المترجمة على
اعتبارها نوعاً مطابقاً للسيرة الذاتية..
ومن استطرادات الرسالة تعود مخيلة ليلى صبار إلى (المنزل) أيضاً كمكان
استذكار سيري مهم لا يخلوا منه أي نص سير-ذاتي..وتصف فضاءه وغرفه وما يحيط به
من جوار.
ولعل اللافت هنا هو (رد الفعل) فالأسوار والأبواب المغلقة على الفتيات
في بيت الجزائر البعيد (مكاناً وزماناً) رغم صلادتها وكونها موانع ومحددات
للمرأة ستصبح شيئاً يبعث على الأمن والشعور بالحماية بتعبير الكاتبة. فهل يعقل
ذلك إذا لم يكن وعي الكاتبة القائم اليوم قد تم إسقاطه على شعورها الماضي؟
وسيؤكد ملاحظتي هذه حديث ليلى صبار عما تسميه (جذوراً حقيقية في المكان) وهو
شعور تتخيله الكاتبة بالمقايسة إلى وضع الاقتلاع اللغوي والإنساني في بيتها
القائم في المنفى.
ولكي (تبرر) لا شعورياً استقرارها في المنفى، ستعمد إلى صنع مدينة أخرى
للجزائر العاصمة التي عرفتها من قبل، إنها تغيرت، ولم تعد محبوبة، "مدينة لم
ارتبط بها قط، والتي أراها كأنها مدينة أجنبية.." بمقابل تذكر مسقط رأسها !
المكان الوحيد في الجزائر الذي يعد مؤسساً لحياتي باعتباره أرضاً، وهي المدرسة
في هذه القرية... ( )
نفهم الآن سبب إلحاح رسالة ليلى صبار التعويضية (قياساً لغياب السيرة
الذاتية المجنسة) على اللغة من جهة والمكان القصي في الزمان والذاكرة.
لقد تحكم زمن الكتابة-كتابة الرسالة-في زمن الأحداث المستعادة، فكان
حضور (الأنا) السير-ذاتية، مرهوناً بشدة بالمكتوب نفسه، بما أنه متجه إلى مرسل
إليه متعيّن، وهذه إحدى معضلات إنتماء الرسالة إلى السرد السير-ذاتي، بل هو أحد
موانع قبولها نوعاً مطابقاً على مستوى المرجع، للسرد والسير-ذاتي المجنس
والمقصود.
7-الشهادة: بغداد/ الزمان والمكان
يوسع فيليب لوجون بعبارة موجزة خلال حواره الأخير من مفهوم السيرة
الذاتية، ويقترح معاينة الشهادة كمصدر من المصادر الأخرى للسيرة الذاتية، تظهر
فيها قوة التزام الشخص الذي يتكلم، ذلك لأن السيرة الذاتية -كما يقول- ليست
نصاً تاريخياً يلتزم فيه المؤلف بقول الحقيقة في مقابل التخيل الذي لا يلتزم
فيه المؤلف بشيء. ( )
إنه يتحدث عن نص (علائقي) يقترح إقامة علاقات مع القارئ، ليست بصيغة
(التصديق) أو (إني الموقع أدناه) كما في السيرة الذاتية التقليدية، بل هي
(اقتراح) قابل لملامسة فضول القارئ وإثارة شهيته، بهذا تخلق الشهادات (أثراً)
في القارئ، لا يقل عن السيرة الذاتية المجنسة.. وتصبح الشهادات تنويعاً آخر على
كتابة السيرة..
إن الشهادات المكتوبة غالباً بدعوة ما أو اقتراح، هي أفضل مناسبة لبروز
(الأنا):
-هكذا نستطيع أن نفهم عنوان شهادة عالية ممدوح وهو (أنا : شذرات من
سيرة الشغف) حيث يعطينا تحليل العنوان أكثر من معطي قرائي:
فالضمير الدال على العائدية (أنا) هو الإعلان المباشر عن الذات في
مركزيتها اللافتة، وهو نوع من مقاومة ضدية للسائد، حين كان استخدام ضمير
المتكلم في المدارس الثانوية-كما تقول-وأمام الأسر والأحزاب لا طائل منه، إذ
كان برهان الشجاعة (هو حصر استعمال الأنا)( ) هكذا كان مطلوباً من الجميع اقصاء
الأنا لصالح (الجميع) حتى لو كانت (الأنا) فكرة... وبذا يصبح الضمير (أنا)
عنوان الشهادة ثاراً من ذلك الفقدان. أما (شذرات) فهي اعتذار ضمني عن الخوض في
تفاصيل الحياة المفترضة في السرد السير-ذاتي ... إن المسكوت عنه والمنسي
والمقصى سيكون لحذفه ما يبرره، ما دمنا نعاين (شذرات) ترصع بها الكاتبة شهادتها
التي تفترض غالباً الإيجاز والتركيز، مع ما في دلالة الكلمة من تباه وافتخار،
فالشذرات ترصع الخواتم والتيجان غالباً وتزيدها ألقاً وجمالاً .. ولشعور
الكاتبة بأنها في مقام أو سياق سيري، فقد جاءت بلفظ (سيرة) للإشارة إلى
الاجتزاء وأن هذا الذي سنطالعه، جزء مختار من السيرة وليس هو السيرة بالضرورة.
يظل المضاف إليه (الشغف) وصفاً دلالياً للسيرة التي أرادت الكاتبة أن
تكون متميزة عن السير الذاتية الأخرى، أو كأنها تريد أن تلخص نجاحاتها
واخفاقاتها بهذا المشغّل الشعوري أو العاطفي: الشعف الذي كان يوجه حياتها سلباً
وإيجاباً. وسوف يؤازر هذا الشفف ما يطالعنا في الشذرات من ألفاظ دالة مثل (الانخطاف)
كتعبير عن إعجابها بالحبيب الذي يكبرها عمراً، وصولاً إلى (التمرغ بالغرام) كما
تقول حين قررت الذهاب إلى المحبوب (البطل بقدرات الجوع والعطش والأنا الناقصة
والمؤجلة..). ( )
ولكن كيف ستوفق الكاتبة بين تركيز أناها واستكمالها –حتى بالبدء
بمصارحة المحبوب بحبها-وبين عطفها الواضح على من حولها من أفراد الأسرة والحي
والمدينة: بغداد التي ستكون في خاتمة الشهادة هي المحبوب! الذي كان الانفصال
عنه هو الاتحاد النهائي به؟( )
إلى هنا وصل (الشغف) – وكأنه حب من طرف واحد وتبرير للخيبة والإحباط –
إلى حد العشق الصوفي: الانفصال عن المحبوب – ولنلاحظ تذكير المؤنث: بغداد-
بالعيش في المهجر، ثم القول بأن ذلك كان السبيل للاتحاد به-بغداد المؤنثة
المذكرة -.
لا تعود عالية ممدوح كثيراً إلى طفولتها، فالشهادة كنسق سيرى حر لا
يفرض عليها ترتيباً خطياً، أو تراتباً حدثياً متصاعداً (من الماضي إلى الحاضر،
ومن الطفولة إلى النضج ومن المنشأ إلى المهجر) لكنها تلتقط ضمن شذراتها أمكنة
وأحياء وشوارع بغدادية، كما ترسمها المخيلة، وشخوصاً-هامشين في الغالب: عاهرة
الحي،- والسيارات الفارهة وأصحابها الموسرين الذين لم تحفظ لهم سمات أو أسماء
فانزووا كذلك في هامش ذاكرتها.
إذن فقد كانت شهادة عالية ممدوح شهادة (على) بغداد المدينة
والطقس..الحضن الذي نشأ فيه شغفها، وليس الذي نشأت هي فيه، ولعل ذلك يبرر حضور
الأنا بهذا الوضوح والمباشرة دون أن نغفل الهاجس النوستالجي في تذكر بغداد:
التي صارت عنواناً للشذرة الأخيرة فيما كانت الأجزاء الأخرى مرقمة من 1-6.
وفي شهادة كاتبة عراقية أخرى تعيش ظرفاً مشابهاً-العيش خارجاً
الوطن-هي
بثينة الناصري سنجد تجليات ثقافية بديلة للمفاصل الحياتية وسنوات
التكوين التي ترتكز عليها أغلب السير الذاتية.
وإذ وضعت بثينة لشهادتها عنواناً موجزاً (حياتي..الكتابة) فإنها اختصرت
فحوى الشهادة وموضوعها فكان العنوان يعرّف حياة الكاتبة بأنها الكتابة، ولا شيء
سواها، وهو إسقاط شعوري تعاني منه الشهادات بعامة، لا سيما ذات التعريف الذي
ضمه العنوان والموحي بأن (حياتي=الكتابة) قد أعيد ثانية في ختام الشهادة
بعبارات أخرى: "ولكن تظل الكتابة ملاذاً أخيراً". ( )
إذن سينحصر بين قوسي (حياتي=الكتابة) و(الكتابة=الملاذ الأخير) الملفوظ
السير-ذاتي لبثينة الناصري، التي تشبه حياتها بمحطات سفر، وتحاول استرجاعها عبر
صور فوتغرافية من هنا وهناك، تتخذها وسيلة سردية ناجحة لعرض موتيفات من السيرة
الغائبة، وللتعليق على ما كانت تحلم به (كنت أطير بجناحين إلى العالم
الواسع..كنت يومها أؤمن أن كل بلاد الله وطن لي). ( )
ولكن وعيها الحاضر يخذل حلمها ذاك، فتسميه (وهماً) إذ أنها رغم حياتها
في مصر منذ ثمانية عشر عاماً أحست أن ليس ثمة إلا مدينة واحدة أو محطة واحدة هي
(بغداد)..."هي المكان والزمان والحلم معاً".
وتثير شهادة بثينة الناصري موضوع الهجرة كثيمة أخذت تلح على الكاتب
والكاتبة العراقيين، فأصبح (الحنين) إلى بغداد بديلاً للمكان الأصغر، البيت:
مكان الولادة والنشأة والصبا والتعلم..
لكننا نتسلم إشارات واعترافات بأن الكاتبة قد عاشت حياتها كما أرادت
وأنها عاشتها أكثر مما كتبت عنها..حياة مليئة بالسفر واتخاذ القرارات المصيرية
بنفسها..لكنها تعترف مرة أخرى بأنها لم تكتب شيئاً عن حياتها التي عاشتها
فعلاً. فالحياة أكثر ميلود رامية من الخيال نفسه، وهذا تبرير لعدم انعكاس
حياتها في قصصها، ولكنها حتى في هذه الحالة لا تـنجو من المطابقة بين شخصيات
قصصها وأحداثها وبين عائديتها إلى الكاتبة بحجة (الصدق) في التعبير( ) بينما
تعلل الكاتبة ذلك بالقناع الذي ترتديه كلما أمسكت القلم. وهذا الفصل بين الحياة
والكتابة يبرر لنا التعميم في سيرة بثينة الناصري المتخذة شكل شهادة. ولا غرابة
ما دامت الحياة لا تمد الكتابة بمادتها، أن تصرح الكتابة بأنها غير منشغلة
بذكورية الكتابة أو أنوثتها، "فعندما تبدأ عملية الخلق يتحول الخالق إلى كائن
لا ينتمي إلى جنس بعينه..." ( )
وهذا الفهم للكتابة غريب حقاً، لأنه يجرد فضاءها من الضغوط والإكراهات
والموانع التي عانت منها الكاتبة نفسها، وهي تتذكر أن الرجل في البيت كان يرغب
في الإطلاع على كل ما تكتب قبل النشر، والأم حتى في سن الكاتبة الآن لا تزال
تجعل نفسها وصية عليها وتراسلها متوسلة ألا تكتب في المواضيع (المخجلة) ( ).
كيف إذاً سيكون (الكائن) مبدعاً دون فروق ، وخالقاً لا ينتمي إلى جنسه
؟ إلا إذا كان يرتدي (القناع) الذي تشكو منه الكاتبة ولنلاحظ أن استدراكها على
رفض الجنوسة في الكتابة جاء بصفة المذكر: (خالق/كائن/ينتمي/ يبدع...) ( )
المهم في شهادة بثينة الناصري تذكرها لثلاثة منازل لا منزل واحد كما
جرى في سير ذاتية نسوية أخرى، منزل الطفولة والصبا والزواج وهي تسميها (بيوتاً)
لترمز بها إلى الطمأنينة التي ستفقدها لاحقاً.
أما بغداد فحاضرة في الشهادة لا كمكان بعيد، بل كوجود لا يكف عن ملاحقة
وعيها، لذا تتكلم عن ظرف الحصار اللاإنساني الذي تعانيه بغداد وأهلها وظلال ذلك
الحصار على الأشياء كلها، حتى ذكرياتها هي نفسها كلما عادت إلى بغداد بين زيارة
وأخرى.
ثمة اعتراف أخير بالفشل يجعلنا نقدر (شجاعة) بثينة الناصري الفشل الذي
يمتد من الولادة حتى الموت المؤجل..وهي لا تسهب في بيان أسبابه، لكنها تلمح
إليه تلميحاً لتعود وتجعله متركزاً في غيابها عن بغداد ونخيلها الذي يهتز مع كل
قنبلة تلقيها طائرات العدوان وهي تطير وتغير باسم الشرعية الدولية الفاقدة لكل
مسوغ إنساني أو قانوني.
8-شهادات أكثر كثافة: صيحات في برّية الرجال:
هذا الجزء من دراستنا نخصصه لشهادات سبع أدبيات يمنيات تقدمن بها
لمناسبة صدور محور خاص في مجلة اتحاد الأدباء اليمنيين (الحكمة) عن أدب المرأة
اليمنية، وهي شهادة قُرئت أيضاً في مهرجان خاص بالأدب اليمني عام 1997.
والملاحظ في قراءة هذه الشهادة تركيز كاتباتها (وهن شاعرات وقاصات) على
بنية القمع التي عانين منها، أكثر من زميلاتهن العربيات بحكم خصوصية اليمن
الخارجة قريباً من عهود ظلام طويل لا تزال بعض آثارها واضحة في الجانب
الاجتماعي خاصة.
ولئن كان اتجاه طلب الشهادة يوجه الكاتبات صوب الانحصار في تجربتهن
الأدبية، لكن مجال البوح لديهن امتد إلى حياتهن الشخصية وما يعانين منه في
ممارسة الكتابة في مجتمع شديد الذكورة يقوم على الفصل الجنسي في أكثر مرافقه
ومؤسساته.
الكاتبات السبع جميعاً بدأن الممارسة الكتابية وهن صغيرات ولكن بسرية
وتخف وعصامية.
فالشاعرة فاطمة العشبي تعنون شهادتها (قصتي مع الشعر) ( ) لكنها تخرج
إلى ما يحيط الشعر من ظروف، فرغم أنها ذات تجربة شعرية محدودة، كانت تحس أنها
ولدت محبة للشعر، بل أنها تصدق زعم جدتها بأن من يمسك بطائر الوطواط ويغمس جسده
في الماء يصبح شاعراً، فاصطادت طائر وطواط حاد الأسنان وغمسته بالماء وانتظرت
أن ينطق داخلها الشعر ! ولما شعرت أن والدها يهمل تعليمها أخذت تتلصص على حلقات
الدرس الذكورية لتتعلم وتتفوق على الذكور، وتجبر والدها الذي تصفه بأنه كان
أباً مرعباً على أن يستدعي لها معلماً خاصاً.
لكن بدايتها مع الشعر مثلت نهايتها مع والدها الذي هددها بقطع يدها لأن
الشعر مقصور على الرجال في ظنه.
ثم جاء عذابها التالي بتزويجها وهي في الثالثة عشرة من رجل يكبرها
بثلاثة أضعاف عمرها، وإذ رفضت ذلك الزواج حفر لها الأب قبراً وخيرها بين الزواج
أوالدفن حية.
ثم تسرد معاناتها حتى بعد الانفصال عن الزوج، وتعرضها بسبب النشر إلى
حملات تشويه وتلويث مخيفة.
ووتساءل نبيلة الزبير (الشاعرة والراوية الأكثر شهرة بين زميلاتها
الآن) إن كانت بصدد الحديث عن تجربة شعرية أم عمرية، مستذكرة معلمتها وزميلتها
وكتابتها الشعر العمودي الذي لم تنشره، وتسرد من بعد ما هو أهم: الالتزام
الاجتماعي وخوفها من ردود الأفعال مما جعلها تتجنب مخاطبة الآخر الذكر وإيراد
كلمات الحب. ( )
وعبر تجاوزها للآخر والجماعة (القبيلة) تقع في مأزق الزواج غير
المتكافئ "كلما قلت هنا. قال: هاهنا" فتوقفت عن الكتابة سنوات ثم عادت لتسترد
هويتها وشعرها معاً.
وفي تجربة القاصة أروى عثمان ثمة محطات: التقاط جزئيات الواقع، زيارة
القرية، التمرد والرفض.. ثم تسمي مفاهيمها حول الكتابة لترى أنها بدأت في مرحلة
الدراسة الثانوية، وتبلورت في فضاء الجامعة، وهامش الحرية والاختلاط وتبادل
الخبرات فيها.
لكنها تورد أسباباً مهنية واجتماعية تحدد نتاج المرأة في مجتمع تصفه
بأنه مجتمع ذكوري تسيّر الحياة فيه قوانين الذكورة مقابل تهميش المرأة، ومن ذلك
وعلى رأسه (العبء الأسري والاجتماعي) والقلق الدائم وعدم الثقة بالنفس( ) لكن
حديثها عن الأسرة يأخذ طابع المرارة حين ترى زميلاتها الكاتبات يخفين ما يكتبن
خوفاً من سلطة الأب أو الزوج بل الأخ الأصغر أحياناً! فضلاً عن الإرهاق الجسدي
الذي تعانيه جراء العمل المنزلي لتصل أخيراً إلى طاولة الكتابة منهكة وغير
قادرة على العمل إلا بطريقة (السرقة) في أوقات الليل حين يهمد البيت.
وتتساءل فاطمة محمد بن محمد عن معنى أن تكون امرأة، ومثقفة مبدعة أيضاً
فهي "مسكونة بالمخاوف ومحفوفة بالمخاطر"( ) ولما كانت فاطمة قد صرفت جزءاً
كبيرا من جهدها بالعمل السياسي فقد تعرضت لأسئلة وشكوك وصلت إلى حد الاصطدام
بالمسؤول الحزبي (الرجل) الذي نسي لقاء صحفي دورها القيادي، فشهر سيف الوعيد
والتهديد لاختلاف الشاعرة معه في الرأي، ولم تسلم من هجمات أدعياء الذود عن
الدين وحرماته الذين لم يعجبهم طرحها لحقوق المرأة في الإسلام.. فالتقى الضدان:
الحزبي الماركسي والداعية المتعصب وهبوا هبة رجل واحد كما تقول لأن امرأة نطقت
بالحكمة.. وهي ترصد بذكاء بعداً خطيراً لإشكالية قمع المرأة، فهي لا تعاني
كثيراً من المجتمع الذكوري نفسه بل من (سلطة) ذكورية قوية. هذا المجتمع الذكوري
هو الذي جعل كاتبة وشاعرة (أزهار فايع) تتلقى اللوم لأنها نشرت نصاً باسمها، أو
لأنها كتبت عن الوحدة اليمنية بألفاظ الحب والحبيب، واستكثر قريب لها أن تشكو
قلقها إزاء الوجود فتساءل: إن كان أحد قد قيدها؟( )
وتتنبه أزهار فايع إلى خطر مضاد، وهو مجاملة كتابات المرأة مهما كان
مستواها بحجة تشجيعها من ذكور ذوي نيات مختلفة تماماً.. ولكن الشاعرتين ابتسام
المتوكل وهدى أبلان تذهبان بعيداً عن خصوصية تجربتهما لتفلسفا منظور الأدب
النسوي، فالمتوكل تعترف بالخوف من الأسرة والمجتمع كمانع لدى بعض الكاتبات من
نشر نتاجهن( ) وتسمي عدداً من الموانع الاجتماعية كانتشار مجالس المقايل التي
تمنع الاختلاط أو الاستماع للآخر على الأقل، وانطواء بعض المبدعات على ذواتهن..
لكننا لا نلمس معاناة الشاعرة ذاتها في هذا الرصد الاجتماعي الذكي.. بينما
تتحدث الشاعرة هدى أبلان( ) عن رعاية الأسرة لها وهي حالة نادرة تؤكدها
بالتشجيع الذي لاقته موهبتها وهي صغيرة من المدرسة والمحيط، إلا أنها تستدرك
حين تتذكر زميلاتها بالقول "إن إشكالية التعبير عن الأنا تظل قائمة عند الأدبية
اليمنية بسبب علامات الاستفهام القاتلة التي تواجهها".
وإذا كانت حصيلة الشهادات السبع -وقد تغيرت أشياء كثيرة خلال الأعوام
الستة التي تلتها- تشي بشكوى مريرة من محددات تمتلك قوة الموروث والعرف، فإن
الروح الكفاحية للكاتبة اليمنية، وكدها الإبداعي والاجتماعي في مجتمع شديد
الخصوصية، لم تظهر في شكل سير ذاتية أو لمحات حياتية، ربما لأن الكتابة النسوية
ذاتها في طور التشكل والبلورة، مما يجعل رصد تفاصيلها أمراً سابقاً لأوانه.
9-خلاصــــــات:
أين سنضع استقصاءنا للتلفظ السير ذاتي النسائي إذا كنا نلملم أجزاءه
المتناثرة في سير مجنسة قليلة وشهادات مبتسرة وتهريبات تحت مسميات جزئية؟
لا شك في أن الإشارة إلى ندرة المكتوب في هذا الجنس هو الخلاصة الأولى
لجهدنا المحدود بالزمن والمصادر دون شك.
ودلالة الندرة مفتوحة على الأسباب الذاتية وتوقعات القراءة ، فضلاً عن
المحددات والموانع الاجتماعية.. ومكانة هذا الجنس في نظرية الأدب العربية.
ثم عند الدخول في صلب مادة (أو متن )الملفوظ السير ذاتي النسائي
واجهتنا مشكلة الحذف أو المسكوت عنه رغم بروز (الأنا) واضحتاً في كثير من
الكتابات، بشكل يبدو لقراءة المؤول تعويضاً عن إقصاء متعمد في متن الحياة،
تحاول الكاتبة أن تصححه برفض التهميش عبر التركيز على ذاتها.
ومما واجهنا كترميزات قهرية أو إكراهات على مستوى الكتابة، مسألة
التركيز على التجربة الكتابية دون الخوض تفصيلاً في مفردات الحياة، تحت مبرر
مساواة الكتابة للحياة والحياة للكتابة، وهذا ليس امتيازاً للكتابة السير ذاتية
النسوية العربية، بل تبرير للمسكوت عنه في طرف المعادلة الأول: الحياة، فبدلاً
عن أن تكون الحياة مناسبة لحدث الكتابة، تكون الكتابة مناسَبة لسرد حدث الحياة،
وهذه مصادرة منطقية، نعللها بالهروب إما لأنواع محايثة لا تستلزم أو تفرغ البوح
التام (رسائل-أوراق-شهادات..) وإما لرصد تجربة الكتابة كفعل متحقق مجرد من
سياقه.
وإذا كان بعض الباحثين يعتبر أشكال السرد المجنسة الأخرى
(رواية-قصة...) ملفوظات سير ذاتية فإنني رفضت هذا المفهوم لأسباب بينتها مفصلاً
في القسم الأول من الدراسة، إذ وجدت إن اعتبار الروايات سيراً ذاتية لمجرد
استخدام الكاتبة ضمير المتكلمة في السرد، غير كاف، كما أن هذه القراءة تعيدنا
لهيمنة حياة المؤلف والمناهج الخارجية على قراءة المتون وإغفال قيمتها النصية،
بالمطابقة بين المتخيل السردي والحياة خارج السرد.
ولقد وجدنا مفردات مشتركة في السير والشهادات والرسائل تتركز حول البيت
(المنزل) كمكان، والطفولة، (كزمان) وهما يشكلان أساس الوعي بالذات، والانتباه
إلى القمع والمنع والحجز أو الفصل الجنسي غالباً كما شكلت الأسرة
(الأم-الأب-الزوج-الأخ..) رمزاً تظهر من خلالها تلك الأساليب القهرية التي لا
يتوقف ضررها عند فرض خطاب الرجل (الذكر) فحسب، بل في تسلل مفردات هذا الخطاب
إلى اللغة ذاتها، ولغة المرأة الكاتبة في أحيان كثيرة لقد كان على النساء
(كاتبات وقارئات) أن يسبحن ضد التيار دائماً منذ مقولة ارسطو عن الأنثى التي هي
عنده أنثى بما تفتقر إليه من خصائص، وليس بما لديها من مزايا، ومقولة توما
الأكويني: أن المرأة رجل ناقص وتصنيفه للشكل كمذكر والمادة كمؤنث ينطبع عليها
شكل العقل المقدس المذكر. ( )
وأحسب –ختاماً- أن العكوف على كتابة السير الذاتية النسائية، هو جزء من
هذا الكفاح المستمر على مستوى الإبداع، لإظهار تميز المرأة، وتأكيد هويتها
النوعية، بمقابل عسف وعنف ذكوري تفصح عنه الملفوظات السير ذاتية بمختلف
تشكلاتها.
أضيفت في20/05/2005/ خاص
القصة السورية/
جورج ماي- السيرة الذاتية
ترجمة محمد القاضي وعبد الله صولة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   
 |
