|
النساء قادمات
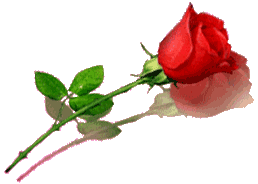 بقلم الكاتبة:
كلاديس مطر بقلم الكاتبة:
كلاديس مطر
سعدت جدا بحضور المؤتمر الذي عقده مركز الإعلاميات العربيات الأردني
في اللاذقية الصيف المنصرم ، والذي أريد له ان يكون في الوقت نفسه، ورش
عمل و تدريب للإعلاميات السوريات على مهنة أردن أن يكن مبدعات و متميزات
فيها . ان مركز الاعلاميات التي ترأسه فخريا الاميرة بسمة بن طلال، لا يحصر
نشاطه في الإعلام فقط ، و انما هو ايضا مركز متخصص للدراسات و الابحاث و
الاستشارات الاعلامية . و هدفه خدمة قضايا المرأة اينما وجدت من اجل ان
تصبح الديمقراطية ثقافة و سلوكا ، كما تقول مديرة المركز الاعلامية و
الناشطة في حقوق المرأة السيدة محاسن الأمام .
لقد اتاح لي ترؤس الجلسة الخاصة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة
التمييز ضد المرأة ، ان اطلع على بنود هذه الاتفاقيات و تحفظات الدول
العربية عليها ، و ان انتبه الى ان التمييز لا يأتي اولا من " الرجل "
كنموذج مطلق و انما من المؤسسات التشريعية القانونية التي لا تزال تحمل
مبخرة التقديس ، و تدور بها على هذه القوانين ، التي بسمرت واقع المرأة و
كأن الدنيا توقفت عن الدوران .
الحق ليست حقوقُ النساءِ بالبدعةِ الغربيةِ ، بل ليست حقوقُ
الإنسانِ كلُّها بدعةً غربيةً . انها في الواقع اعادة الامورِ الى نصابِها
تماما كما ارادها الله ان تكون . حين تكون المساواةُ بين الجنسينِ امرا
الهياً فاننا لسنا مخيرين بان ننتقي ما يناسبنا من هذا الامرِ و نتحفظُّ
على الباقي . و لماذا نتحفظ ان كان نموُّ مجتمعاتِنا و ازدهارِها يتوقف
تماما على هذه المساواة؟ .
مم نحن خائفون ؟! و لماذا كلما مر شبحُ تغييرٍ طفيفٍ بالقربِ منا ،
ارتعدت ثقافتُنا وقوانينُ مجتمعاتِنا ؟! و لماذا نحول رموزَنا الجميلةَ
النسويةَ القديمةَ من عشتارَ آلهةِ الخصبِ و الجمالِ مرورا بملكاتِنا
العربياتِ القديماتِ و انتهاءا بمريم العذراء .. الى اصنام للفرجةِ و
الزينةِ ليس الا ؟! و رموزُنا المعاصرةُ مثل السعداوي و أخرياتٍ الى رموزٍ
للمطاردةِ و الخروجِ عن الاعراف !
مم نحن خائفون ؟!
هل الانسانَ رجلٌ فقط ؟! اما ان الانوثةَ و الذكورةَ المتكاملين في
بُعديهما الاكثرَ جوهريةً هما اختصارٌ لهذا الوجودِ البشري حولنا !؟
لماذا نحن بحاجةٍ الى كبشِ فداءٍ دائما لكي نبرر هذه المحارقَ
المهولةَ الكبيرةَ التي نوقدُها كل لحظةٍ لنقاطِ ضعفِنا ، و لماذا تكون
المرأةُ دائما هي هذا الكبشَ السهلَ نحرُه و المزايدةُ عليه ؟!
تخيلوا معي ان نصفَ المجتمعَ يضيع في محرقة لا تنتهي ! و كلُّ هذا
يحدثُ بمنتهى الهدوءِ و السريةِ و الصمتِ، بمباركةِ نصوصٍ تشريعيةٍ و
قوانينَ أصبحت بقدرةِ قادرٍ غيرَ قابلةٍ على المسِّ او النقاش ! ان من يخطئ
بحقِّ الآخر بهذه السريةِ و الصمتِ يتحولُ مع الوقتِ الى جبان . إذن لماذا
نريد تحويلَ بعض رجالنا و نسائنا الى جبناءَ !! و لماذا نضع كل مستقبلِ
بلادِنا و حياتِنا على كاهلِ بضعةِ قوانينَ تمنعُ فعلا هذه الامةَ من
تحقيقِ تنميتِها الاجتماعيةِ و الاقتصاديةِ و الروحيةِ الأكملْ ! و حين
تظهرُ اتفاقياتٌ دوليةٌ تحرمُ هذا النوعَ من التعطيلِ او التمييزِ ..
نلوّحُ براياتِ التحفظِ عاليا من دونِ ان نقدمَ تبريرا – كما هو مطلوبٌ منا
في حالِ تحفظنا على أي بندٍ من هذه الاتفاقياتِ – حقيقيا لذلك ، على الرغمِ
من ان تحفظنَا كان تماما على جوهرِ نصوصِ هذه الاتفاقيات !.
مع ذلك ، ان اتفاقياتِ مناهضةِ التمييزِ ضد المرأةِ ، هي في واقعِها
نصٌ بشريٌ ، أي انها ليست اتفاقياتٍ مقدسةً و ليست منزهةً او منزلةً .. لكن
قوتها المضمونيةُ و الاعتباريةُ تأتي لكونها محصلةٌ جماعيةٌ لحاجاتِ نساءِ
الكثيرِ من الدولِ و الأقاليمَ لكي تخرج من قمقمِ التجاهلِ و اللغيِ . ان
بنودَ هذه الاتفاقياتِ انما هي مشروعٌ إنسانيُّ المصدرِ و النزعةِ و لهذا
فهو غيرُ مقدسٍ إنما يبقى في هذه اللحظةِ الصيغةَ الأفضلَ لحمايةِ هذا
الكائنِ المسمى " امرأة " .
اننا نقدرُ تماما ان هناكَ نسبيةٌ ثقافيةٌ يجب مراعاتُها لكن
مراعاتِها لا تكونُ بالتسترِ على اكبرَ الكبائرِ من خلالِ قوانينَ أحوالٍ
شخصيةٍ و جزائيةٍ مهينة ..و لا تاتي من بنودِ تشفي بيدٍ و تخلقُ العلةَ
باليدِ الاخرى !!
و بالرغمِ من ان قوانينَ الأسرةِ هي الاكثرَ صعوبةً على الاقترابِ
منها بسببِ تغلفها بهالةٍ التقديسِ و التحريمِ ، الا ان الدولَ العربيةَ لم
يتحفظْ كل منها بالطريقةِ نفسِها على نفس هذه البنودْ. الأمر الذي بيّن ان
هناكَ نسبية في قراءة التاريخِ الاجتماعي العربي الاسلامي لهذه القوانينَ و
اولها قوانينُ الزواج !!
الحقُّ لقد آن الاوان لنا لكي نفهمَ ان كل فكر لا يندمجُ مع
الصيرورةِ الزمانيةِ و المكانيةِ للتاريخ – أي لا يتفاعلُ مع حركةِ التاريخ
– انما هو آيلٌ للزوالِ ضمن الحدودِ التي رسَمها لنفسهِ في فترةٍ محددةٍ
سابقةٍ من الزمن . و ان عليهِ لكي يبقى في حالةِ تنفسٍ و حياةٍ ان يخلقَ
ذاتَهُ من جديد بحسبِ ظروفِ المرحلةِ المعاصرةِ و الا فان زوالهُ قرارٌ
طبيعيٌ و حتمي .
كما آن الاوانُ لكي نفهمَ انه يجبُ فصلُ القرارِ السياسيِّ عن هذه
الجميعاتِ التي تحاولُ ان تعيدَ الامورَ الى نصابِها فلا تموتُ قبل ان
تولدَ بسكينِ البيروقراطيةِ و تبتعدُ عن العملِ الجماهيري .
لا نستطيعُ ان ننتهكَ حقاً من الحقوقِ من دونِ ان يؤثرَ هذا على
بقيةِ الحقوقِ الاخرى ، و لا يمكنُ التحفظُ على بندٍ واحدٍ من دون ان يؤثرَ
هذا على كاملِ الاتفاقية . ان فهمنَا لهذا الامرِ هو شرطٌ لدخولِنا من
بوابةِ الانسانية . ان المطالبةَ بحقوقٍ للمرأةِ لم يأتِ من الفراغ .
راجعوا التاريخَ لتعرفوا ان الرجلَ كان أول الضحايا عندما كانت شريكتُه
كبشَ فداءٍ لمحرقةِ المجتمعِ الكبرى .
عندما يكونُ هناكَ سببٌ قويٌ ، و يعرف الإنسان في قرارةِ قلبه بأنه
سبب حقٍ وأنهُ عادلٌ و مع ذلك يرفض الدفاعَ عنهُ ..فانه في الطريق الى
حتفِه . و انا لم أرَ في حياتي جثثا تمشي على قدميها و تتحدثَ عن العدلِ
كما أرى اليوم .
ليس الرجل وحده ، و لوحده هو المسؤول عن هذه القوانين الجائرة ، و
هذا الحال المتذبذب للمرأة ! النساء هن مسؤولات أولا و الا لكانت هذه
القوانين و هذا الحال قد تغيرا منذ زمن بعيد.
في الانسان ميل لكي يحتفظ بشيء من واقعه المزري ..و الا فكيف سيقضي
قسما كبيرا من عمره في التأفف و رمي مسؤولية حالته على الآخر، و التمرغ في
وحل التباكي و التظلم؟ ربما هذا هو السبب في كون هذه الانسانية لم تتقدم
كثيرا على المستوى الروحي ، اذ أن اغلب ناسها " يقضون وقتا ممتعا و لطيفا "
في التأفف و الكسل و الاستسلام للقضاء و القدر .
أضيفت في05/03/2008/ خاص
القصة السورية / المصدر الكاتبة (
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

أدب نسائي جريء
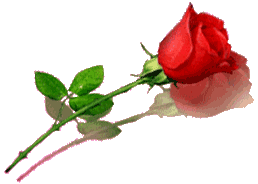 بقلم الكاتبة:
كلاديس مطر بقلم الكاتبة:
كلاديس مطر
إذا اتفقنا على أن الكتابة بعمقها وسيلة إبداعية لحل مشاكل
المجتمع،و طريقة للالتفاف على (اللامسموح او التابو) بغية طرح موقفنا منه،
نفهم لما كان الأدب النسائي – اذا قبلنا هذا النوع من التخصيص جدلا –
مرتبكا امام البوح و التعبير الحر. إن المرأة مصنع من الأحلام ! هي حارثة
مثالية لأوهامها الصامتة ! متفوقة في علم حساب الذات، حتى و لو كانت أميه !
فطريه تتعامل مع الدنيا حولها بإحساس بوصلي راداري تلقائي، لكنها متمكنة
في الوقت نفسه من إحداث الثقوب و التلصص على العالم من خلالها. و من بين
كل هذا كان هدفها الأكبر : حقوقها ! و كانت كلما كسبت المزيد منها، كلما
انعكس ذلك على قدرتها على التعبير عن ذاتها و حالها، و كان هاجسها يتمركز
على كسب المزيد. حتى دخل على الأدب مصطلحات مزيفة مثل (أدب نسائي جريء ) و
( محاولات نسائية بدائية ).
والحق إذا أمعنا التدقيق في هذا الكم الكبير من النصوص النسائية
الأدبية العربية لوجدنا أن اكثر من 99 % من الجرأة في التعبير، تندرج تحت
مواضيع اعتقدت المرأة أن تحررها يجب أن يكون منها أولا: الجنس وعلاقتها
بالرجل. ولم يستطع النقد العربي الباهت او غير المحترف او القليل، ان يوجه
خطوات هذا النوع من الأدب، ولا ان يدير الدفة بحيث يقوم بتعريف الأنوثة
والذكورة أولا، و يحدد الوظائف، وإنما قام بتمجيد الجرأة في تناول
الموضوعات الجنسية متناسيا دور الأنوثة في النضال المجتمعي !
في البحث الذي اعمل عليه حول أنوثة المرأة العربية بين التحقق و
الضمور – و هو أيضا كان موضوع المحاضرة التي ألقيتها في اتحاد الكتاب في
ابو ظبي الشهر الفائت _ أردت أن اعرف معنى الأنوثة التي تحاول المرأة اليوم
التملص منها باعتبارها السبب المباشر و الغير مباشر – برأيها – لتاريخها
الطويل من القمع و الاستلاب. انها تعتقد ان مجرد كونها امرأة كان سببا
لقمعها متناسية ان الانوثة- بالمعنى العميق للكلمة - ليست سوى هذه الطاقة
الداخلية المتحركة من الداخل الى الخارج و ليس العكس. انها جزء من البنية
التحتية للمجتمع باعتبارها العنصر الذي تبنى عليه السلامة النفسية للأسرة –
خلية المجتمع الوحيدة.
مع الأسف لم يستطع أدب المرأة ان ينطلق من هذه النقطة و يبحث عن
تكامل العلاقة بينها و بين الرجل، و إنما اخذ يعالج الموضوع من ابهت و
اسخف جوانبه، وكأنه تقرير مكرر لسجال تناحري بين الطرفين، فهو اما يشتم و
يظهر كل تهجم على الرجل، و اما ينتقد بشكل تذمري بعيد عن طرح أي حل.
والحق، ولم استطع ان أميز سوى القليل من المفكرات العربيات الرائدات
ممن استطعن ان يضعن أيديهن على نبض الحقيقة مثل فاطمة المرنيسي ونوال
السعداوي اللتين تناولتا الموضوع بشكله التاريخي الأكاديمي ولم يظهرا أي
انحياز او نقد الا بعد ربطه بالشواهد و المصادر. لقد تحدثتا عن الحرملك
العربي المعاصر الذي يقبع بين جدران الرأس، وعن فيروس الحريم الذي يصيب حتى
اكثر رجالنا ثقافة و وعيا بينما لم يستطع الأدب ( شعر، قصة، مسرح ) ان
يستغرق فيصل إلى هذه الأعماق او المستويات من الطرق، وبقي اما شاتما او
مادحا من دون تبيان الكثير من المبررات المنطقية، او حتى طارحا لحلول يمكن
ان يعول عليها.
غريب ان تنتشر مصطلحات مثل ( أدب نسائي جريء ) فقط للتدليل على
نوعية المواضيع المطروحة و الإباحية في التناول. صحيح ان المرأة – الكاتبة
يجب ان تقتحم مستويات لم تقتحمها من قبل، و لكن فقط لتعريف الآخر بأعماقها
و وجدانها و دور أنوثتها النضالي – الأنوثة بالمعنى العميق و المضموني
للكلمة -، ما عدا ذلك لا قيمة معنوية او أدبية له برأي.
لم يستطع أدب المرأة العربي الحديث – أُذكر انه لم يكن هناك أدب
قديم إلا بعض القصائد القديمة القليلة هنا و هناك – ان يرقى لمستوى الأدب
الإنساني و يندمج بموقف الأدب عموما من القضايا الكبرى، فنادرا ما نقرا
رواية نسائية تتمتع بهذه الخلفية الاقتصادية – السياسية – التاريخية
العميقة للواقع، او لحقبة ما، و كأن أدب المرأة لا يجب ان يعبر إلا عن هموم
علاقتها بالرجل واستجداء حقوقها منه او المعاناة من قهره. و نادرا، ما نجد
نصوصا نسائية أدبية تحمل فكرا فذا تقدميا يطرح حلولاً بديلة.. وكأن هذا
النوع من الكتابة متروك للدراسات و التحليلات.
أنا أرى أن الأدب الذي تكتبه المرأة، مهما كان جريئا، إن لم يأخذ
دوره في التغيير المجتمعي و التركيبة الوجدانية الأخلاقية للمجتمع فانه
يكون أي شيء إلا أدب. و هذا الهذر الرومانسي الناعم ، او هذه العصبية
اللغوية المستفزة التي تمتلئ بها الكتب ليس إلا دليلا آخر على فشل الأدب
النسوي العربي. بالتأكيد هناك الكثير من الأعمال النسائية العربية الممتازة
والنصوص التي تعتبر ثروة حقيقة أدبية و لكنها بالتأكيد قليلة، فأدب السيرة
الذاتية إن لم يرفق ( بتصور حل) فانه غير مجدي وسيكون ( كتاب آخر ) على رف
المكتبة العربية.
إن القمع الطويل الأمد الذي تعرضت له المرأة عبر تاريخها لا يبرر
تجاهلها لقطب الذكورة و ضرورة التكامل معه. فالنضال لا يكون ضده و إنما معه
و من خلاله ؛ بمعنى توحيد ( الجبهات ) أمام تحديات الاقتصاد والمجتمع
والخلفية الثقافية
ان المفكرة و الباحثة العربية فاطمة المرنيسي في كتابها ( أحلام
النساء الحريم ) مثلا، لم تعرض فقط هواجس النسوة المختبئات في الاحاريم
المثلية، و إنما تذهب الى ابعد من هذا عندما تبحث عن اصل الكلمة. ولأنها
تعتقد أن البداية كانت لعبة من العاب السلطة حيث النفوذ لمن يملك اكبر عدد
من النساء، فإنها تكشف سخافة و ضحالة كل تبريرات هذا النوع من النفوذ. فضبط
الحريم في مكان واحد خوفا على الرجال من اللهو و عدم الالتفات الى ما هو
أجدى مجتمعيا : العمل بغية كسب القوت، قد دحضه الغزو الفرنسي بكل تؤدة و
هدوء. فنساؤهن يخرجن على هواهن بل و يعملن، بينما وجد الرجال الوقت مع ذلك
لتأليف جيش جرار و غزو المغرب !!!!! و هي حين تشرح التاريخ القمعي العربي و
تظهر ماله و ما عليه فإنها في الوقت نفسه تقدم الحل : و هذا هو تعريف الأدب
بأعمق معانية، و هذا هو دور الأدب بأجمل صوره. ان المرأة لا يجب أن تلجأ
إلى القلم من اجل ان تسرد ما يحصل،فهذا امر لا يغني و لا يسمن. فالنضال
الأدبي- القلمي يجب أن يربط قضايا المرأة و الرجل بحركة الصيرورة
التاريخية وتفاعل الإنسان مع حقائق الواقع المعاش و تبدلها في الزمان و
المكان و إلا فلا معنى لهذا النضال و لا دور يحسب له.
ولهذا،فأنا لا أرى ان الأدب النسائي الذي يكتب حاليا يمكن ان يسحب
البساط من تحت أقدام الأدب الذي يكتبه الرجل العربي، و لا حتى العكس.. انني،
ككاتبة، أتطلع إلى الأمر من منظور آخر.. يهمني جدوى الطرح قبل جماليته،
رسالته قبل فنيته او صناعته، قفزته كفكر قبل تدفقه. كل كتاب جيد، بمعنى
قدرته على الحوار مع المتلقي عالية، أكان كاتبه رجل او امرأة، هو أدب
إنساني و هكذا انطلق في التصنيف.
لا زلنا، كوعي، نحبو على أربع. و الحريم المعاصر اليوم يتبدى من
خلال قواعد مختلفة ظاهريا. انه أيضا من صنع الرجال و تضبطه ليس الجدران
السميكة ولا الباحات الداخلية، و انما قوانين السوق و العمل التي تجعل
المرأة تفقد شخصيتها و هكذا فإنها عادت من جديد حبيسة عالم الذكر. انه الفخ
المعاصر الذي يجمل العمى و يخلق التماهي بين الجنسين تحت اسم تطور. و اذا
راقبنا عن كثب نتائج الحريم المعاصر و القديم، نجد انها متطابقة بشكل مذهل
: امرأة مشوهة الأنوثة وجدانيا، مثلية غير سوية و رحم وجداني ضامر، و
طغيان لعالم الذكر بكل قوانينه. و الى ان تعي نساؤنا هذه الازدواجية، بل
هذا الفخ، و يبحثن عن الحل في داخلهن و وجدانهن، و يعبرن عن كل هذا من
خلال موقف فكري – عملي متجل في أدبهن، فان الطريق يبدو طويلا جدا ً، مهما
حاولن ان يكتبن ( أدبا جريئا ) بمعايير اليوم.
أضيفت في05/03/2008/خاص
القصة السورية / المصدر الكاتبة (
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

جماليات السرد
في القصة القصيرة النسوية السورية
بقلم
الكاتبة:
د. ماجدة حمود
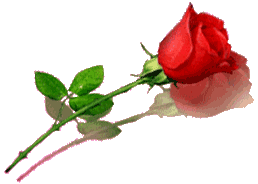
نماذج سورية
يحسن في البداية أن نتوقف عند إشكالية مصطلح (النسوية) الذي أسيء
فهمه كثيرا! إذ إن ما أقصده هو انفتاح اللغة الأدبية على خصوصية التجربة
النسوية، التي نلمسها في إبداع المرأة، دون أن نحمّل هذا المصطلح أي دلالات
تؤدي إلى تمييز أو تفوق أدب المرأة على أدب الرجل! لأن الإبداع، في رأيي،
هو الانتماء الحقيقي للأدب بغض النظر عن جنس قائله.
خصوصية دلالة العنوان:
نلمح هذه الخصوصية في اختيار عنوان قصة "أنياب رجل وحيد" (1) (في
مجوعة
غادة السمان
"لا بحر في بيروت" التي ظهرت طبعتها الأولى 1963) يلاحظ
أن هذا العنوان يحمل دلالات القهر والمعاناة التي تتبدى في اختيار لفظة
(أنياب) التي أضيفت إلى الرجل، وشكلت وحدة دلالية معها بسبب وحدة
المتضايفين، مما يعني أن الكاتبة ترى الآخر بصورة مشوهة، لكن صفة (وحيد)
خفّفت من هذا التشوّه، إذ جعلتنا نلمس تعاطف الكاتبة مع ظروف الرجل (أستاذ
الجامعة بسام) الذي يعيش تجربة غرائبية، فقد أُخبر عبر هاتف أتاه في المنام
بأنه مشرف على الموت بعد يومين، فيطغى عليه إحساس الزوال، ويتضاعف إحساسه
بالحاجة إلى الآخرين، لكنهم يكشرون عن أنياب الخداع، فلم يجد أمامه إنسانا
مخلصا سوى (سلمى)
تبدو المرأة هي ملاذ الرجل في محنته، بما تجسده من قيم الحب التي هي
حبل نجاة للإنسان الوحيد عالم مزيف! فهي تعيد للرجل إنسانيته، وتخلصه من
أنيابه ووحدته، مما يعني سيطرة صورة المرأة المنقذة على لا شعور الكاتبة
غادة السمان!
خصوصية التجربة:
نلمس في مجموعة
ألفة الأدلبي
"ويضحك الشيطان" التي ظهرت (1970)
نعايش في قصة "من أجلك أنتِ" تجربة المرأة المهانة التي اعتدى خطيبها على
شرفها وتخلى عنها بعد أن عرف أنها حامل!
يتجلى الخيال المقهور هنا في تحويل هذا الرجل إلى قطيع من الذئاب،
وبذلك لا تستخدم الكاتبة الصفة السلبية (ذئب) بصيغة المفرد بل تجعلها بصيغة
الجمع، فيصبح الخطيب الهارب من مسؤوليته قطيعا من الذئاب تلاحق المرأة! "آه
من الذئاب!…قطيع من الذئاب يحمل رؤوسا بشرية يطاردني، يعوي ورائي…أسرع
الخطا، أركض كمجنونة…"(2)
بدت لغة الحلم إثر تجربة المرأة مع الرجل المعتدي تجسيدا لمخاوفها
تستطيع عبره التنفيس عن رعبها وقلقها الذي يصل حدّ الجنون!
نلمس جمالية الحوار الذي ينبع من خصوصية التجربة، إذ نعايش في هذه
القصة تجربة فريدة تجسد بؤس المرأة الحامل المخدوعة، التي لا تجد من تبثه
شكواها وحزنها سوى الجنين! فهو المستمع الوحيد الذي ترتاح إليه، لذلك تنشئ
حوارا مدهشا بينها وبينه في أحشائها (مفترضة أنه طفلة) وبما أن المستمع
(الجنين) لا يستطيع الحوار، فإن حوارها بدا داخليا أشبه بلحظة بوح واعتراف
ودفاع عن النفس، إنه حوار مع الذات وكشف للحظات ضعفها وحرمانها! كما هو كشف
لآمالها ومخاوفها، إذ يطاردها كابوس أنها ملاحقة تقع في فخاخ الذئاب!
اهتمت الكاتبة بأن تجعلنا نعايش تفاصيل هذه الأزمة منذ الافتتاحية،
ففي الجملة الأولى فيها "صحوت من نومي مرتاعة أرتجف" وحتى الخاتمة "سأقدم
على الأمر الفظيع (إسقاط الجنين) وسأحرم منك! لا من أجلي أنا بل من أجلك
أنت"
تلجأ الكاتبة إلى تقنية الحوار الذي يعتمد اللحظة الراهنة (أي
الترهين السردي) فيكشف مدى أزمة بطلتها الداخلية (إسقاط الجنين أمر فظيع
ومحرم دينيا واجتماعيا) كما يكشف صراعا بينها وبين ذاتها تحسمه لصالح
الطفلة، وكذلك لجأت الكاتبة إلى العبث بالزمن وجسدت لنا عبرالحوار الذي
يجسد لحظة مستقبلية حاسمة في حياة (الطفلة لجنين)!إذ تخيلت طفلتها صبية
جميلة يرفضها خطيبها لأنها ابنة غير شرعية، فنجدها تحاسب أمها باكية "لِمَ
كتمت عني الأمر؟…"
إن تجاوز اللحظة الحاضرة إلى المستقبل، يدفعها إليه خوف من مجتمع
ينسج البؤس حول مصير طفلتها غير الشرعية، لذلك تساعدها هذه التقنية على
استباق الأحداث وحسم أمرها في التخلص من الجنين، وهي تمهد لهذا الاستباق
الذي يستشرف المستقبل بعبارة "هأنذي أتخيلك" كي تمهد للمتلقي نقلتها
الزمانية وتضمن تفاعله.
ثمة نوع من الترتيب رغم تجاوزها للمألوف في تقديم أحداث القصة عبر
إطار زمني حر (حاضر، ماض، مستقبل) فقد لاحظنا أن حديثها عن الماضي قد سبق
حديثها عن المستقبل، إنها تريد أن تقدم للمتلقي ماضي الشخصية ولحظات ضعفها
ثم آلام تنتظرها في المستقبل، مما سينعكس على قرارها الذي اتخذته في
حاضرها، رغم أنه يتنافى مع تلبية حاجات المرأة الداخلية وهي تجربة الأمومة!
تجربة الأمومة:
في مجموعة ملاحة الخاني "كيف نشتري الشمس" (1978) تستوقفنا قصة "أنت
شبيهي" التي نجد فيها تجربة الأمومة بصورة مدهشة، فقد استطاعت الكاتبة أن
تقدم رؤيتها عبر صورة تجسد بؤس العلاقة بين أم وحيدة وابن عاق نسي أمه وهو
يلهث وراء لذاته ونجاحاته المادية، وقد جاءت هذه الصورة على لسان الابن
العاق، فبدا لنا صوت أعماقه واضح البشاعة "مع توالي الأيام نبتت لي مخالب
أخفيها وبراثن أتستر عليها، وفي موضع القلب أحمل فلزة من صخر …أنت وحدك
موئلي، ودارك ملاذي.
مررت أصابعها على جبيني، توقفت عند العينين، تبسمت. المرارة تقطر من
التجاعيد المرسومة حول الفم. أحس طعمها فوق لساني تلدغني ، أصابعها تغوص
الآن في عمق شعري، تدغدغه بعنف..شيء ما مدبب في رؤوس الأصابع يجرح جلدة
الرأس…يهبط على جبيني الذي ينـزف للتو، تكاد الأصابع تبلغ عينيّ… الأظافر
نبتت واستطالت وقست باتت مثل أظافر فهد متوحش."(3)
ثمة هاجس لدى الكاتبة هو أن تجسد خصوصية مشاعر الأمومة المكلومة،
فحاولت تجسيد هذه التجربة عبر أدوات تصويرية، فأي انحراف في العلاقة بين
الأم وابنها، تجعل الولد العاق يضع صخرا مكان قلبه، فيعيش حياة منسلخة عن
عالم الإنسان! إذ تنبت له مخالب، خاصة بعد أن حلت المرارة محل الرقة والحب
في قلب الأم، لذلك لن نستغرب هذه الصورة للأم التي تود لو تمزق ابنها
اللاهث وراء المادة ناسيا المعاني النبيلة والقيم! لهذا نكاد نفتقد، هنا،
الألفاظ الرقيقة، مع أن المشهد الذي تقدمه مشهد لقاء أم بابنها المسافر!
فقد طغت الألفاظ ذات الدلالة القاسية والمتوحشة (فلزة من صخر، المرارة، شيء
ما مدبب، الأظافر: تكررت مرتين، برائن، مخالب، فهد، متوحش) كذلك نجد
الأفعال بدت ذات دلالات عنيفة (تلدغني، يجرح ، ينـزف) حتى الفعل الذي قد
يحمل دلالة تبعده عن العنف (يدغدغ) تضيف إليه صفة تجعله قاسيا (تدغدغني
بعنف)، أو تجعله يحمل هذه الدلالة من خلال السياق (تقطر المرارة) (تكاد
الأصابع أن تبلغ عيني)
قدمت الكاتبة عبر ذلك كله صورة فنية تشكل معادلا لحقيقة بتنا اليوم
نعايشها، وهي افتقاد كل ما هو جوهري ينعش الوجود الإنساني ويعطي للحياة
معنى (رقة الأمومة وحنانها، وتجاوز الأبناء أنانية الذات) في مقابل اللهاث
وراء الزيف والمال، لهذا بتنا نستبدل بحب الأم مخالب فهد متوحش!
استخدمت الكاتبة أم عصام (خديجة الجراح النشواتي) في مجموعة "عندما
يغدو المطر ثلجا" في قصتها "الحقيقة العارية" لغة رمزية للدلالة توحي ببؤس
العلاقة بين الرجل والمرأة، لذلك تستعيض في هذه القصة عن الاسم أو الصفة
الاجتماعية، فالزوجة تصبح "فأرة" والزوج "سجانا" وبذلك تكون الدلالة
السلبية من نصيب الرجل والمرأة دون أي تحيز من الكاتبة لجنسها!
لكن ما لاحظنا في هذه القصة هو تسليط الضوء على صوت المرأة في لحظة
تأزم، فنلمس تفاهة الحياة التي تعيشها بسبب الزوج الذي يفرض عليها قيم
الحياة الحديثة بنظره (السهر، الرقص، المجون، حيث يتبادل الرجال زوجاتهم)
في حين نجد الزوجة ترفض الانصياع لهذه الحياة، وينتابها الخوف على ابنتها
فتقدم لها الحقيقة العارية التي تعني خلاصة تجربتها المرة في الحياة
فتقول؛: "المدينة زيف وتمثيل لا تحرر وصدق…ستهمس لها بألا تقبل الحياة في
سجن كسجنها، بل في قصر… قصر في مفهومه لا في قيمته المادية ورياشه
الفاخرة…ستعلمها بأن تقبل رفيق عمرها صديقا وندا وفيا، يقدر وفاءها له
ويحترمه… سترسم لها خطوط الحقيقة العارية."(4)
مع الحياة المشوّهة لن تستحق المرأة اسما عاديا أو لقبا اجتماعيا
وإنما ستطلق الكاتبة عليها اسما رمزيا "فأرة" يجسد بؤس حياتها التي أوصلتها
إلى الهامشية والمهانة، وكذلك لن نسمع اسم الزوج ولن نلمس صفته الاجتماعية،
بل سنجده من خلال الدور الذي يمارسه هو "السجان" ويتحول بيت الأحلام
الزوجية إلى سجن تنتهك القيم فيه!
لذلك نجد المرأة تهرب من حاضرها التعس إلى أحلام الماضي، لكن هذا
الهروب لن يشكل ملاذا لها، فقد تجسدت أحلامها في أسوأ صورة، لهذا كان إحساس
الفجيعة يشمل حاضرها كما شمل ماضيها، يأتي صوت أعماقها عن طريق الراوية،
الذي يبدو لنا حميميا أحيانا، إذ قلما تتحدث الشخصية بلسانها (مستخدمة ضمير
الأنا) فهي تتحدث بلغة حذرة، مستخدمة صيغة الغائب، لعل الكاتبة تتجنب إساءة
فهم قد تتعرض له من قبل المتلقي الذي قد يماهي بينها وبين الشخصية النسوية!
لذلك تلجأ إلى ضمير الجماعة، كي تلمح إلى أن هذه المعاناة جماعية لا علاقة
لها بذات الكاتبة.
خصوصية علاقة المرأة مع الزمن:
نلمح هذه الخصوصية في قصة أخرى لأم عصام هي "المرحلة الصعبة" إذ
نعايش تجربة تكاد تكون خاصة تدعى أزمة منتصف العمر، صحيح أن هذه الأزمة
يتعرض لها كل من المرأة والرجل، لكن معاناة المرأة تبدو أكثر حرقة، لهذا
تسيطر لغة الوجع الروحي على الشخصية النسوية فنسمعها تقول: "تتحسر روحها"
أو "روحها تتبدد في الشكوى" أو تتلوى الروح تتمتم" فقد أعلن موتها حين بلغت
منتصف العمر!
وبذلك نعايش في هذه القصة أزمة المرأة التي تدعوها الكاتبة بـ"المرحلة
الصعبة" في عنوان يجسد المقولة الأساسية للقصة، ويسلط الضوء على لحظة
مأزومة تمر بها المرأة، تزيدها قلقا وخوفا من الحياة، خاصة حين لا تجد عونا
من أحد، حتى من زوجها ينشغل بالقراءة عن الإصغاء إليها، لذلك بدا لنا
الحوار الخارجي أشبه بحوار داخلي، مادام الآخر "يغرق في هدوئه وصمته وعيناه
مسافرتان عبر السطور"
لهذا يسيطر على المرأة إحساس بالدمار فـ"في المرحلة الصعبة يتهدم كل
شيء، ونخال الأيام قد انتهت" تتابع تداعياتها عن الماضي بكل ما يعنيه جمال
الشباب الذي يحمل بين يديه إمكانات الفرح والأمل "تبدأ الحياة والمستقبل
يتراءى خلف بريق الأمل…نخال الغروب شروقا، نخال كل ما نحصل عليه سيلفحنا
بحرارة الغد الذي لم يولد بعد."(5)
أعتقد أن عدم استخدام ضمير الأنا المفردة، في هذه القصة، أفقد
الخطاب حميميته، مما أدى إلى جعله أقرب إلى الخطاب العام! لعل الخوف من
المجتمع دفعها إلى استخدام ضمير يبعد عنها الشبهات!!
تشوّه العلاقات الإنسانية:
في مجموعة
ضياء قصبجي "ثلوج دافئة" ترصد بلغة غرائبية تشوه العلاقات
الإنسانية إلى حد مفزع، والكاتبة هنا لا تبرئ المرأة وتتهم الرجل، بل تبدو
معنية بالتشوهات النفسية التي تحاصر المرأة اليوم! فحين تذهب الصديقة (في
قصة "نداء من الماضي") لتعزي صديقتها، التي تربطها بها خيوط مودة بالية،
بوفاة والدها يستقبلها كلب أسود حاول الخروج إليها ليفترسها، وهو ينبح
نباحا شرسا….وينظر إليها بعينين يتطاير منها الشرر، كان مخيفا…" لذلك
تساءلت بينها وبين نفسها "هل يؤدي الإخلاص إلى التهلكة أحيانا!"(6)
فالصديقة اللاهثة وراء متع الحياة تركت كلبا يتلقى العزاء، لذلك نجد
هذه الصديقة تتمتم في الخاتمة برغبة مكبوتة، تنطق بالحقيقة المؤسية "أليس
من الأفضل أن يذهب الكلب وتبقى السيدة؟؟!!" فنلمح رغبة ملحة في أن تعود
الحياة إلى وضعها الطبيعي، فيتم الاحتفاء بالعلاقات الإنسانية!
نلاحظ في الخاتمة استخدام لغة حيادية، فالصديقة التي تهرب من
صديقتها تفقد صفة الصداقة لذلك تصبح (سيدة) فقط، لاحق لها في امتلاك اسم
يقوم على الصدق والمحبة، لهذا أطلقت عليها اسما محايدا (سيدة) تستحقه
وتحرمها من صفة لا تستحقها (الصديقة)!
كنت أتمنى لو كثّفت الكاتبة لغتها أكثر، فتخلت عن بعض تداعياتها
التي أساءت إلى بنية القصة، كتلك التي تتحدث عن ضعف ذاكرتها، وعن بعض
صفاتها (ص 37_ ص 38)
لعل الغرائبية سمة من سمات الكاتبة ضياء قصبجي، لهذا لا تميز في
أغلب قصص مجموعتها بين امرأة أو رجل، كأنها تريد أن تنذرنا بأننا إذا لم
نحافظ على علاقاتنا الإنسانية بكل دفئها، سنعيش حياة مشوهة تصل حد
الحيوانية، ففي قصة "ليلة العرس" نجد مظاهر البذخ تصل حدودا غير طبيعية،
لذلك بدا العريس "وحشا" وبدت العروس "نعامة"
تدهشنا هذه القصة بدلالاتها الساخرة التي تجعل من أجواء البذخ
والتفاهة جوا يقترب من حديقة الحيوان، مما يذكرنا بعوالم زكريا تامر
الساخرة.
العلاقة مع الرجل:
بدت الكاتبة معنية بالحفاظ على عالم نقي يسود حياتنا الاجتماعية،
لذلك تقوم بتسليط الضوء على العلاقة المشروخة بين المرأة والرجل في قصتها
"شروخ في الخيمة" التي يوحي عنوانها بتمزق الروابط الأسرية التي تجمعها
خيمة الزوجية، خاصة حين تصبح العلاقة بين المرأة والرجل علاقة سيد بمسود،
تقول الزوجة: "أنتظر أن يأمرني بنصبها (الخيمة) في المكان الذي يريده"
قدمت لنا الكاتبة العلاقة المشروخة عبر صوت أعماق المرأة التي تبوح
بآلامها وتسرد قهرها بسبب تسلط الرجل "فقال بصوته الزاجر" فنعايش بؤس
العلاقة الزوجية بكل تناقضاتها، إذ نجد مقابل لغة الزجر الذكورية لغة الحب
الأنثوية، فتجيب المرأة بصوت يملؤه الحب والحنان"
لذلك وجدنا المرأة تعيش علاقة غير سوية أشبه (بالمازوشية) فتردد
بينها وبين نفسها عبارة تجسد ذلك "إنه ظالمي لكنني أعشق ظلمه" فالظلم
والزجر والأنانية والعطالة سمات الرجل (يأكل بشهية وحده، يغط في نوم عميق)
لكونه ينعم بالهدوء وعدم المبالاة بمن حوله!
نلمس لدى الكاتبة تعاطفا ضمنيا مع المرأة ، فنسمع وجهة نظرها في حين
يغيب صوت الرجل في هذه القصة فيتجلى عبر جمل قصيرة ترتكز على توجيه الأوامر
للمرأة "ثبتي عمود الخيمة هنا…وافتحيها" في حين تبدو المرأة فاعلة معطاءة
(تهيئ لزوجها الفراش الوثير وتنام على البساط، تقدم له الطعام ثم تتناول
بقاياه!)
أمام هذا القهر تستجيب المرأة لنداء حب متكافئ، يدعوها إليه رجل آخر
يراها إنسانة لا عبدة، يتعاون معها على حمل أعباء الحياة.
يلفت نظرنا أننا لا نجد في هذه القصة أسماء تحملها الشخصيات سواء
أكانت شخصيات ذكورية أم أنثوية، تكتفي الكاتبة بتجسيدها عبر الضمائر، كي
تضفي عمومية على فضاء قصتها، لكن الملاحظ أن الرجل الظالم تبدى لنا عبر
الضمير الغائب في حين تبدى لنا الرجل المحب عبر ضمير المتكلم الذي ينطق
بلغة إنسانية تؤسس لعلاقة متكافئة بين المرأة والرجل في الوقت الحاضر
والمستقبل، مادام الماضي لم يعد ملكا لنا!
نفتقد في البداية، مع توتر العلاقة بين المرأة والرجل، ضمير الجماعة
الذي يوحد بينهما، لكننا مع ظهور علاقة إنسانية تقوم على الحب والفهم، يبدو
لنا ضمير الجماعة قد وحد بينهما، فباتت أفعال المرأة والرجل واحدة (مررنا،
سررنا) وصفاتهما واحدة (مسرورين) بل أصبح هدفهما واحدا (متجهين نحو …)
أفلحت الكاتبة في توظيف الطبيعة لتكون معادلا فنيا لعلاقة المرأة
بالرجل، فالعلاقة غير السوية (الظالمة بينهما) تنعكس على علاقة الليل
بالنهار "داهم الليل النهار" أما شروق الشمس فقد أصبح "معركة" وظلام الليل
أصبح "احتلالا" وبذلك نفتقد، مع علاقة القهر التي تؤسس علاقة المرأة
بالرجل، جمالية لقاء الليل بالنهار (الغسق والشروق) إذ بات اللقاء صداميا
بينهما كأنه لقاء حربي!
من الملاحظ أن الكاتبة جعلت العلاقة غير السوية بين المرأة والرجل
في فضاء خيمة ممزقة! أي في فضاء ذي دلالة تقليدية، تقهر المرأة، فالخيمة
مازالت رمزا، باعتقادنا للحياة القبلية التي وصلت في الجاهلية إلى درجة وأد
المرأة! وقد منحت الكاتبة صفة التمزق للخيمة لتـزيد في دلالة بؤس العلاقة
المشوهة بين المرأة والرجل التي تظللها خيمة ممزقة!
أما العلاقة السوية فقد تمت في فضاء الطبيعة التي تحمل دلالة منفتحة
على الجمال "الأرض الخضراء" حيث يتم اللقاء "في ظلال الزيزفون" "أمام غدير
طافح بالماء" حيث توقفت الشمس عن معركتها وعاد إليها شروقها الجميل، فانتشت
الطبيعة فرحة، وكست أشعة الشمس مياه الغدير "بريقا متراقصا"
إن جمال العلاقة الإنسانية بين المرأة والرجل انعكس على الطبيعة،
فغابت اللغة القاسية التي تجعل الفضاء الطبيعي أشبه بفضاء حربي (داهم،
معركة، احتلال…) فتقتل أية إمكانية لوجود علاقة إنسانية! ولكن مع العلاقة
الندية بين الرجل والمرأة ظهرت اللغة الرقيقة ذات الإيحاءات الجميلة
المعطاءة (الخضراء، ظلال، غدير، طافح…) بل تحولت الطبيعة إلى أم رؤوم تحنو
على المرأة والرجل حين سكن الحب قلبيهما، فابتعدا عن الحياة الجاهلية "سرنا
في الطريق الذي يبتعد عن الخيمة… تحت أشجار الصنوبر التي تحنو بأوراقها
وظلها علينا."(7)
وبذلك أسهمت اللغة الحساسة في تأسيس فضاء قصصي متميز، يهب القصة
جمالية خاصة تجعل عملية تلقي القصة عملية ممتعة، تغني الروح والفكر، وتجسد
طموح المرأة إلى فضاء أكثر إنسانية ينأى عن السياق الجاهلي الذي مازال يرمي
بثقله على العلاقة بين المرأة والرجل.
مع مجموعة "غسق الأكاسيا"
لأنيسة عبود
تحضر الطبيعة في المقولة
الأساسية للمجموعة (العوان) كما تحضر في التفاصيل، فهي جزء أساسي في صراع
القيم والمثل مع القبح!
نلاحظ امتزاج لغة الهم الخاص بلغة الهم العام، إذ إن أي دمار للوطن
سينعكس أول ما ينعكس على روح المرأة الصافية! وهي غالبا امرأة ريفية ("شروخ
في الزمن" "المرآة") لذلك بدت المدنية الزائفة التي نعيش فيها اليوم المصدر
الأساسي للكآبة التي تعانيها المرأة، إنها مصدر البشاعة التي حلت بحياتنا!
تبدو لنا المدينة المشوهة وقد اعتدت على الطبيعة، فقتلت أجمل رموزها
"شجرة الشط" عندئذ تقتل الأصالة والنقاء والحب والعطاء من أجل أن يسود
الاستهلاك والمال! وقد بدت هذه المجموعة عبر فضائها المشوه (المدينة)
وفضائها النقي (الريف) استمرارا للفضاءات التي عايشناها في روايتها "النعنع
البري"
التجريبية في القصة القصيرة:
يسجل للكاتبة
أنيسة عبود أنها استطاعت أن تقدم القصة القصيرة
التجريبية بشكل إبداعي، ففي قصة "انفجار الألوان" تمتزج القصة القصيرة
باللوحة التشكيلية، إذ تسرد علينا القصة عن طريق لوحة ترسمها الشخصية
(زنوبيا) تفاصيل حياتها فتبدو لنا الريشة قلما تستجلي بها أعماقها "أغمر
ريشتي في الماء كأني أغمرها في محيط بعيد أمتد باتجاهه، علني أرى نهاية هذا
العماء الذي بدأ يتبلور في أعماقي."(8)
تتيح عوالم الفن التشكيلي للكاتبة أدوات تعبيرية مبدعة، لو تأملنا
لفظة (ريشة) التي قد تكون أداة رسم وقد تكون ريشة طائر في مهب الريح، وقد
استطاعت هذه الدلالة أن تجسد لنا الضياع في محيط مضطرب، لذلك لن نستغرب
سيطرة الألوان السوداوية التي تحمل دلالات حزينة!
إن حزن (زنوبيا) ليس حزنا عاديا أو شخصيا إنه "حزن كوني" يؤلمها ما
أصاب أمتها من انكسارات التي تدعوها ساخرة بانتصارات، فتتضح لنا معالم
الشخصية عبر لغة التناقضات التي تجعل الشخصية "وريثة انتصارات الخليج
وانتصارات النفط وانكسارات الأعماق" لهذا بات الفضاء الزمني الذي تعيشه
متأرجحا متراقصا كورقة تعبث فيها الريح! لا يوحي لها بالاستقرار أو الأمان!
نعيش مع هذه الشخصية (زنوبيا) معاناة المرأة المبدعة، التي بدأت
تحقق نقلة نوعية في وعيها، إذ ترى وجودها الإنساني عبر الإبداع، لا عبر
الرجل! لذلك نسمعها تقلب مقولة ديكارت "أنا أفكر إذا أنا موجود" إلى "أنا
أرسم إذا أنا موجودة" لكن هذا الوجود الإبداعي تهدده علاقات إنسانية مشوهة
تحيط بها سواء مع الرجل أم مع المجتمع بما فيه من حيتان مستوردة تهدد
بالتهام الأصالة والجمال من حياتنا!
تتضح لنا في هذه القصة العلاقة بالرجل وتكتفي الكاتبة بالتلميح إلى
العلاقات الأخرى التي بدأت تشوهها الحيتان، نظرا لطبيعة القصة التي تقوم
على الكثافة والاختزال!
تبدو لنا (زنوبيا) امرأة جديدة، تبحث عن ذاتها فتجدها عبر الإبداع
الفني، فهي مقتنعة بأن الإبداع صنو الخلود" وهذا ما يهدد علاقتها بالرجل
الذي لم يتفهم بعد أعماق المرأة المبدعة، لهذا كانت علاقتها بالألوان علاقة
انسجام حتى بدت مندغمة متداخلة بوجودها، في حين كانت تنظر إلى (عاصم) ضجرة
"ترى خيالات عينيه ووجنتيه وشعره، فهي غير متأكدة من لون عينيه ولا من لون
شعره"
إذا ثمة فرق بين الاندغام والتوحد مع الألوان وبين تحول الرجل إلى
مجموعة خيالات باهتة، لذلك لن تستطيع تذكر لون شعره أو عينيه، فكأن الفن
هو الحقيقة التي تتأكد في أعماقها، في حين بات وجود الرجل أقرب إلى الوهم،
فهي غير متأكدة من وجوده، لذلك يبدو لنا سؤال الرجل "أتحبينني؟" في
الافتتاحية سؤالا ذا دلالة سلبية، لأن وجود الرجل في حياة المرأة المبدعة
يدمر فنها، فقد سمعنا جواب (زنوبيا) عن هذا السؤال "أتحبينني؟" موحيا لنا
بدمار الفن "أفرط شعر الريشة فيتناثر عبر فضاءات الغرفة المزدحمة بالألوان
والأشياء والغضب" لذلك من حقها أن تتساءل: "أي سؤال هذا الذي يقف بالباب
موجها لي متطاولا كشجرة تسد علي بظلالها كل منافذ الشمس"
صحيح أن الرجل (الشجرة) ضروري للحياة لكنه لن يكون في أهمية الشمس
أي (الفن) بالنسبة إلى المرأة، لذلك قد يؤدي وجوده لسد آفاق الحياة أمامها
فتراه نوعا من "الطوفان" الذي يدمر حياتها، في حين يراها الرجل "قصيدة"
تزين حياته!
تبدت لنا علاقة المرأة بالرجل، عبر لغة مأزومة (تسد منافذ الشمس،
الطوفان، الغضب…) توحي لنا بمعاناة المرأة مع الرجل، إنه يحاول ترويضها كي
يصبح عالمها الوحيد تدور حياتها حوله، فهو لا يمكنه أن يصدق أن بإمكان
المرأة أن تنشغل عنه بإبداعها الخاص، لترى وجودها من خلاله! بمعزل عن
الرجل!
يبدو لنا الرجل أكثر انشغالا بعالم الماديات، في حين تبدو المرأة
مهمومة بهم الوطن والإنسان! لذلك لم يعد يوحي لها "بلوحات جديدة ولا
بانفجارات لونية"
لكن الكاتبة تدرك أن أي دمار يلحق بالوطن، في ظل النظام العالمي
الجديد، لن يصيب المرأة دون الرجل، لذلك لابد أن يتحدا للوقوف ضده، تتعمد
الكاتبة إخفاء ضمير (الأنا) الذي لحظناه في القصة أثناء الحديث عن هم
الإبداع (الذي هو هم ذاتي) ليفسح المجال لضمير الجماعة (الذي يضم النساء
والرجال) فالأخطار تحيق بهما معا "إن عالما جديدا ينبثق الآن من أصابعنا
وذاكرتنا يحمل السياط ويجلدنا لنعترف على أنفسنا ولندخل لعبة السجن
الجديدة."(9)
تحاول الكاتبة تقديم ملامح عالم الاستهلاك، وقد عززتها الأقمار
الصناعية التي جعلت الإنسان العربي مهددا بتدمير شخصيته وهويته، كي يبقى في
سجن التخلف والذل! ويعيش مقلدا لا مبدعا!!
لهذا تتمنى (زنوبيا) أن يكون الرجل سفينة إنقاذ تساندها كي تواجه
بؤس حياتها وكآبتها، لكن الرجل يخيب ظنها، مازال ممسوخا داخل أفكاره
وأنانيته! تراه نقيضا للفن تراه وسيلة تعول عليها في مواجهة هذا الدمار
وهذا الانهيار في القيم والمثل.
وقد أسهمت اللغة الشعرية في بناء القصة، واستطاعت أن تجسد الحلم
والمكونات الداخلية اللاشعورية الأخرى، فعايشنا فيها كثافة الرموز،
والدلالات التي توحي باختلاط المثل وسيطرة القلق على الشخصية بعد الطوفان
الذي بدأ يدمر حياتنا، بكل ما تحمله من قيم أصيلة: قيم الحب والجمال
والعطاء! "يا لهذه الريشة الملعونة التي ترفض أن تنصاع لرغبتي…أريد أن أرسم
فتاة في طرف اللوحة هنا، أريدها باسمة فرحة…مشرقة الوجه كشجرة اللوز
المغسولة بالمطر..لكن الريشة لا ترسم إلا فتاة مدبوغة بالحقول والهجير
والخوف…"(10)
تمنح القيم المعنى الحقيقي للحياة، لذلك تفتقد المرأة السعادة
والحلم بحياة أفضل حين تفتقدها، لهذا تعيش القلق والخوف والهجران في زمن
الاستهلاك!!
لو تأملنا الفضاء المكاني في هذه اللوحة للاحظنا الحضور الكثيف
للريف بكل تنوعاته (روعة الخضرة، حيواناته وطعامه…) فهو المنبع الوحيد
للفن، وبالتالي المنبع الوحيد القادر على مواجهة الدمار، في حين بدت
المدينة نقيضا للفن، لذلك حين ترسم (زنوبيا) شارعا في مدينتها تبدو عاجزة
عن الإبداع، إذ تخرج الألوان من قانونها…مزج الأزرق بالأصفر لم يعطِ
اخضرارا" لأن المدينة تقتل الخضرة والجمال، فهي بالتالي عاجزة عن إلهام
الفنان!
وقد منح البناء التشكيلي القصصي، إن صح التعبير، الكاتبة قدرة مدهشة
في التخييل، فالشخصية مثلا ترسم في لوحتها خرافا سرعان ما تختفي، فقد
التهمها كلب كبير، ثم انقض على الرسامة ناشبا أظفاره في رقبتها، فهو عالم
القوى الكبرى التي لن تفسح المجال للوداعة والمحبة والعطاء، لذلك يلتهم
الكلب الخراف، ولن يفسح المجال للفن الصادق أن يقول كلمته، سيبذل كل جهده
لخنق هذه الكلمة وينشب أظفاره في عنق كل مبدع!
وقد اختارت الكاتبة اسما لشخصيتها اسم بطلة تاريخية، واجهت الأعداء
وفضلت الموت على الأسر، إنه اسم (زنوبيا) وقد كان اختيارها موفقا لأننا
أمام بطلة معاصرة تواجه دمار وطنها الذي توصل للحقيقة والجمال والمثل
ويقاوم الزيف والبشاعة!
بدت لنا هذه الشخصية أشبه بالشخصية الرسولية التي تحس بتفردها بفضل
إبداعها، لذلك وجدنا لديها طموح الرسل في خلق عالم جديد نقي، بإمكانه أن
يقاوم الزيف والطوفان الذي سيغرق العالم، نسمعها تقول "لدي أمور أود أن
أنجزها قبل الطوفان"
وقد اختارت الكاتبة اسما عاديا للرجل، لا علاقة له بالتاريخ، لكنه
يوحي لنا بصفة الردع التي يراها منوطة به، إذ لديه رغبة في أن يعصم المرأة
من فنها ويبعدها عن كل ما يلهيها عن وجوده، لذلك كان اسم "عاصم" موحيا
بدلالات سلبية!
صحيح أننا لاحظنا امتزاج هموم الوطن بهم المرأة في هذه القصة، لكننا
لمسنا خصوصية الخطاب النسوي بكل معاناته الذاتية والعامة، وبفضل استخدام
الكاتبة لضمير (الأنا) بدت لنا القصة أشبه بقصيدة بوح تضيء أعماق المرأة
بما يشبه الاعتراف، نسمع زنوبيا تقول:"أنا كغيري من النساء أحب الهدايا،
ولكن يكفي أن تهديني قرنفلة أو قصيدة… لأعترف بأني انتظرت هداياك…ويوم كانت
تغيب هداياك الصغيرة، كنت أحزن وأتوقف عن الرسم، لا أعرف لماذا، ربما هي
أنانية المرأة… أعرف أني لم أعترف لك بحبي مع أنني كنت أريد أن تعترف لي
بحبك في كل لحظة، الهدية اعتراف بالحب، أو هي بوح آخر أكثر ترميزا وأكثر
خصوصية من البوح…"(11)
مع هذه اللغة الحميمة نسمع صوت أعماق المرأة معترفا بما يفرحها من
تصرفات وما يسعدها من أقوال، فنعيش معها صدق التجربة وحرارتها، فرسمت لنا
الكاتبة أبعادا للذات الأنثوية قلما نظفر بها في الحياة العادية!
افتقدنا في اللغة القصصية لدى أنيسة عبود،أحيانا، الكثافة والإيجاز،
دون أن يعني هذا القول افتقادها للغة متميزة في حساسيتها وشاعريتها، مما
يمكنها من تقديم قصة تجريبية متميزة.
أخيرا لابد أن يلاحظ المتتبع للقصة القصيرة النسوية السورية أنها
استطاعت أن تجسد خصوصية التجربة الأنثوية عبر خطاب قصصي يسعى للتميز،
والنطق بلغة أدبية خاصة، تمنح القصة فرادتها، فحاولت المزج بين الأسلوب
الحداثي والأسلوب التقليدي! وهذا ما حاوله الكاتب في إبداعه في أغلب
الأحيان! من أجل أن يتمّ التفاعل مع المتلقي بشكل أفضل.
وقد بدا لنا أسلوب الحداثة أسلوبا تجريبيا، كل كاتبة تسعى فيه ليكون
لها صوتها المتميز، صحيح أنها حاولت الابتعاد عن الأسلوب التقليدي، لكن
دون أن يعني هذا القول وجود حاجز حديدي، في كثير من الخطاب القصصي، يفصل
بين الطريقة التقليدية، التي تقدم فضاء القصة بشكل منتظم عبر لغة واقعية،
وبين الطريقة الحديثة التي تجسد صوت الأعماق، عبر لغة الشعر والتخييل.
لكن ما نلاحظه هو تلك المعاناة المشتركة بين الكاتبات سواء كتبن
القصة الحداثية أم القصة التقليدية، وهي اللغة الفضفاضة التي تفتقد الكثافة
اللغوية، مع أنها من أبرز سمات القصة القصيرة.
لكن ما يسجل لصالح القصة النسوية السورية أننا لم نجد في لغة الخطاب
تلك اللغة المتشنجة الانفعالية أو المتعصبة التي تقطر كراهية للآخر (الرجل)
مما يعني تجاوزها محدوية الأفق وفجاجة في الوعي!
الحواشي:
1.غادة السمان "لا بحر في بيروت" دار الآداب، بيروت، ط3،
1975
2.ألفة الأدلبي "ويضحك الشيطان وقصص أخرى" مكتبة أطلس،
دمشق، 1973، ص 16
3.ملاحة الخاني "كيف نشتري الشمس" نشرت بالتعاون مع اتحاد
الكتاب، بدمشق، ط1، 1978، 16
4.أم عصام "خديجة الجراح النشواتي "عندما يغدو المطر ثلجا"
دار مجلة الثقافة، دمشق، ط1، 1980، ص 172
5.المصدر السابق، ص 190
6.ضياء قصبجي "ثلوج دافئة" اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1992،
ص 41
7.المصدر السابق، ص 31
8.أنيسة عبود "غسق الأكاسيا" اتحاد الكتاب العرب، دمشق،
1996، ص 150
9.المصدر السابق، ص 154
10.المصدر السابق نفسه، 158
11.نفسه، ص 155
----------------------------------
ملخص النسوية في القصة القصيرة / نماذج سورية
المؤلفة د. ماجدة حمود /قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة دمشق
مؤتمر الاتحاد العام للكتاب العرب في الخرطوم
إننا لا نحمّل مصطلح (النسوية) دلالات تؤدي إلى تمييز أو تفوق أدب المرأة
على أدب الرجل! لأن الإبداع، في رأيي، هو الانتماء الحقيقي للأدب بغض النظر
عن جنس قائله.
وقد حاولت الدراسة التوقف عند خصوصية دلالة العنوان، وخصوصية التجربة،
وتجربة الأمومة،وخصوصية علاقة المرأة مع الزمن، ثم توقفت الدراسة عند تشوّه
العلاقات الإنسانية، والعلاقة مع الرجل.
إن المتتبع للقصة القصيرة النسوية السورية أنها استطاعت أن تجسد خصوصية
التجربة الأنثوية عبر خطاب قصصي يسعى للتميز، والنطق بلغة أدبية خاصة، تمنح
القصة فرادتها، فحاولت المزج بين الأسلوب الحداثي والأسلوب التقليدي! وهذا
ما حاوله الكاتب في إبداعه في أغلب الأحيان! من أجل أن يتمّ التفاعل مع
المتلقي بشكل أفضل.
وقد بدا لنا أسلوب الحداثة أسلوبا تجريبيا، كل كاتبة تسعى فيه ليكون لها
صوتها المتميز، صحيح أنها حاولت الابتعاد عن الأسلوب التقليدي، لكن دون أن
يعني هذا القول وجود حاجز حديدي، في كثير من الخطاب القصصي، يفصل بين
الطريقة التقليدية، التي تقدم فضاء القصة بشكل منتظم عبر لغة واقعية، وبين
الطريقة الحديثة التي تجسد صوت الأعماق، عبر لغة الشعر والتخييل.
لكن ما نلاحظه هو تلك المعاناة المشتركة بين الكاتبات سواء كتبن القصة
الحداثية أم القصة التقليدية، وهي اللغة الفضفاضة التي تفتقد الكثافة
اللغوية، مع أنها من أبرز سمات القصة القصيرة.
لكن ما يسجل لصالح القصة النسوية السورية أننا لم نجد في لغة الخطاب تلك
اللغة المتشنجة الانفعالية أو المتعصبة التي تقطر كراهية للآخر (الرجل) مما
يعني تجاوزها محدوية الأفق وفجاجة في الوعي!
أضيفت في16/01/2006/ خاص
القصة السورية / المصدر:
الكاتبة
د. ماجدة حمود
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

ملخص صورة المرأة لدى
فارس
زرزور
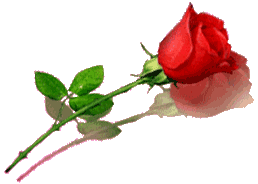 بقلم الكاتبة:
د. ماجدة حمود
بقلم الكاتبة:
د. ماجدة حمود
قدّم لنا
فارس زرزور عبر رواياته وقصصه صورة نادرة للمرأة الريفية السورية، رسمها بنبض
عذاباته، فقد لوّنها الفقر بألوان القهر والعنف! لذلك لم نجد الصورة النمطية
للمرأة التي عايشناها في الرواية السورية، والتي تبدو فيها تارة عاهرة وتارة
قديسة!
صورة المرأة في السياق الاجتماعي والفكري:
لو تأملنا الصورة التي يرسمها الروائي لأية شخصية من شخصياته
الروائية للاحظنا أنها تمتح بعض عناصرها من السياق الاجتماعي الذي عايشه بحكم
النشأة أو العمل، لهذا وجدنا
فارس زرزور
يبيّن لنا أن فكرة رواية (الحفاة و"خفي حنين") جاءته من صورة مختزنة في ذاكرته،
حين كان معلما في "تل علو" في الجزيرة، تضم هذه الصورة مجموعة من العمال
الزراعيين والعاملات وقت الحصاد! فلم تميز الصورة لديه بين ملامح للرجل
والمرأة، فقد بدت خطوطها لنا شديدة القتامة، تضيّع خصوصية كل منهما، فلا يرى
الناظر من بعيد سوى قطع ممزقة، وإذا أمعن النظر فستهزّه حركتهم المضطربة
بأقدامهم الحافية، أنشب الفقر أظافره في ملابسهم فأحالها أسمالا، وحين تقترب
العدسة (المصورة) للكاتب تتضح للمتلقي تفاصيل البؤس أكثر! فنجد أنهم يحملون
صررا أفرغها الجوع من الزاد منذ زمن طويل!
نعايش في هذه الصورة أناسا سلبهم الفقر إنسانيتهم وقرّبهم من حياة
القطيع، لكن الأمل في حياة أفضل، والسعي للعمل من أجلها ينقذ الصورة من
بهيميتها، وبذلك أعاد لهم الراوي إنسانيتهم! وهكذا حقق الفقر مساواة بين المرأة
والرجل، وقضى على التفوق الذكوري والضعف الأنثوي! إذ تعمل المرأة الريفية سواء
أكانت أما أم زوجة وأختا مثل الرجل تماما، ووجدنا الشاب المتعلم وغير المتعلم
يقف إلى جانب عملها، لأن الجوع لم يترك خيارا آخر! لهذا تبدو مناقشة عمل المرأة
في هذا المجتمع الفقير ترفا لا معنى له!
رغم ذلك لاحظنا تعاطف الروائي مع المرأة الفقيرة، فسلط الأضواء
عليها وهي تعمل في أسوأ الظروف (حامل، مرضعة، مريضة...) وهي رغم حاجتها الشديدة
للمال، ترفض امتهان كرامتها، والعبث بشرفها، فتبدو مؤمنة بقيم مجتمعها الأصيلة،
ففي قصة "أمنية" يتحرش الوكيل بالعاملة (زهرة) ويساومها على أجرتها، فترد عليه
بتحد "إلى جهنم"
فالحفاظ على القيم الأصيلة يساوي لدى المرأة أهمية لقمة العيش، لذلك
نجدها رغم جوعها لا تستجيب لإغراءات صاحب العمل!
صحيح أنها محاصرة بظلمة الفقر، لكنها تستنجد بذكائها، فتحقق تأقلما
مع أبشع الظروف، وتقيم توازنا بين قيم أصيلة تحمي كرامتها وحاجات أساسية تحمي
حياتها، لذلك حين تركب النساء القطار المكتظ بالرجال في عربة البهائم، نجد
المرأة القروية تلف جسدها باللحاف كي تتحاشى الالتصاق بالرجال!
هنا نلمس رهافة حس الروائي وقدرته على استجلاء نفسية المرأة، مما
يوحي لنا بوعيه الاجتماعي، وامتداد آفاقه الإنسانية، لذلك استطاع أن يجسد لنا
روح البيئة، متلمسا سمة أصيلة لدى المرأة التي تختلط بالرجال في العمل، وتحافظ
على كرامة جسدها!
إن صورة المرأة الفقيرة الملتفة باللحاف تثير تعاطف المتلقي مع
المرأة العاملة التي ترفض ابتذال ذاتها في أعتى الظروف!
إن ابتكار مخيلة الروائي لهذه الصورة الفريدة، التي تشكلها أدوات
بسيطة في متناول أية امرأة، تشي بالتصاقه بهموم واقعه، ورغبته في عمل المرأة
دون أن تتنازل عن كرامتها! وبذلك لا يشعر المتلقي بغربة الروائي عن مجتمعه، رغم
أنه يحرضه على تجاوز بؤسه!
عايشنا في بعض روايات فارس زرزور ظاهرة اجتماعية تسيء إلى إنسانية
المرأة، إذ تحول المهر عن معناه الديني والإنساني إلى معنى تجاري يسلّع المرأة،
فافتقدنا في البيئة الفقيرة المعنى الراقي للمهر الذي وجدناه في القرآن الكريم
"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"(4) أي هدية تقدم بمناسبة الزواج) إذ يصبح ثمنا
لها! لهذا رضيت الفتاة الصغيرة (فرحة) الزواج من (عواد) الغني رغم أنه في عمر
أبيها، ولديه زوجتين قبلها!
صورة المرأة بين المتعلم والجاهل:
يبدو لنا الروائي الاشتراكي مؤرقا بالبحث في روايته عن طريق للخلاص
من هذا البؤس، فيرشح لذلك (عمر) في رواية (الحفاة و"خفي حنين")الإنسان الواعي،
الذي يعيش هاجس المعرفة، فيبدو رائدا حقيقيا للنهوض، إذ يقف إلى جانب المرأة في
محنة التخلف! فاستطاع أن يواجه بعض العادات، التي ترسخها الحاجة المادية! ويمنع
زواج أخته الصغيرة زواج صفقة، يمتهن كرامتها، في حين لم يستطع الشاب الجاهل (جدعان)
الوقوف في وجه التقاليد التي عقدت تحالفا مع حاجته المادية والغريزية! فقبل
بزواج المبادلة! هنا نتساءل: هل بإمكاننا أن نلومه لأنه لم يقاوم كما قاوم
عمر؟
لو تأملنا الشروط الاجتماعية التي تمّ فيها زواج المبادلة للاحظنا
أن الغبن يقع على الأخ لا الأخت، فهي ستتزوج من (قاسم) الشاب المعافى، في حين
سيتم زواج الأخ من (فرحة) العرجاء، وقد قبل بها، لأنه لا يملك مهرا، ولكونه
سيحصل من وراء هذا الزواج على عدد من الحيوانات وأكياس من القمح! تسانده على
مقاومة القحط وقهر الجوع!
إذاً بمثل هذه التقاليد الاجتماعية التي وثّقتها لنا رواية
"المذنبون" تحايل أبناء المجتمع الفقير على الظروف الاقتصادية القاهرة، كي
يعيشوا، فابتكروا علاقات قد يراها المرء من بعيد ظالمة وغير منطقية، لكن حين
يمعن النظر فيها يراها ضرورة لاستمرار الحياة في أقسى الظروف!
وقد سُلطت الأضواء في هذه الرواية على مشكلة تعدد الزوجات، التي
تجلت عبر سياق يلتحم فيه البؤس الاقتصادي بالاجتماعي وبالفكري، مما حوّل المرأة
إلى سلعة يحصل عليها من يملك ثمنها، أو من يملك القدرة على إطعامها فقط!
يحدثنا صوت الراوي المتماهي بصوت المؤلف بأن أولى مشاكل هؤلاء
الزوجات أنهن آدميات فعلا دون أن يحيين حياة الآدميين، وآخرها أنهن زوجات لرجل
هو (صالح الذياب)
يبدو أن العلاقة جدلية بين المرأة والرجل، فحين تنـتزع آدمية
المرأة باسم الزواج تنتـزع في الوقت نفسه آدمية الرجل!
لذلك صور لنا الروائي (صالح الذياب) الذي يجمع في بيته ثلاث زوجات
في صورة سلبية (مختل، أشبه بحيوان هائج) لا يعرف معنى للعاطفة!!
تغلغل الروائي إلى أعماق صوت المرأة المقهورة بالفقر وبالرجل،
فعايشنا اشتعال نار العداء بين الزوجات الثلاث من أجل رجل لا تعرف المشاعر
طريقها إلى قلبه، فكأنه حين عدّد زوجاته قد انسلخ من حقيقته الإنسانية، أي من
مشاعره، وهذا ما أكده لنا القرآن الكريم"ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه."
(سورة الأحزاب آية 4) فالقلب يتجه بمشاعره نحو امرأة واحدة، ومن المستحيل تحقيق
العدل العاطفي بين الزوجات، لهذا ينسى المسلمون آية أخرى تعلن هذه الحقيقة
الإنسانية "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم..." (سورة النساء، آية
129)
تبيّن لنا الرواية كيف أن المجتمع المتخلف يفسر الدين تفسيرا
متخلفا، إذ ينطلق من احتياجاته الاقتصادية أو الاجتماعية مهملا الحقائق
الإنسانية!
يبدو لنا فارس زرزور أمينا للواقع الريفي الذي يرصده، في بدايات
الستينيات من القرن العشرين، لذلك لم يرسم لنا صورة امرأة تتجاوز واقعها
المتخلف، بل لم نجد لديه امرأة تجرؤ حتى على التفكير أو الحلم بتغييره! إذ تبدو
لنا ظلمة الواقع المتخلف وصلت إلى درجة تقتل فيها إمكانية الحلم!
ومن البديهي أن يسبق الرجل المرأة في التفكير نظرا لطبيعة حياته،
التي هي أكثر انفتاحا على العالم الخارجي!
يبدو، هنا، تعاطف الرجل مع المرأة واضحا، فقد استفزّه الوضع المهين
الذي تعيشه، ودفعه إلى التساؤل عن طريقة أخرى للحياة! خاصة بعد أن اقترب من
المرأة (الزوجة) روحيا وجسديا، فهدته إلى مشاعر جديدة لم يعرفها من قبل (الحب
والشفقة والإحساس بالآخر) فاكتشف وجوده الحقيقي وإنسانيته! وبذلك استطاعت أن
تنقله بفضل هذه المشاعر من عالمه المغلق على (الأنا) إلى عالم أكثر اتساعا ،
وبدأ مرحلة جديدة من حياته يرفض فيها ممارسات الجهل والسحر، لهذا منع المختار
من ضرب أخته، كي يطرد الشياطين التي تلبستها
صورة المرأة والسياق الأسطوري:
يقدم الكاتب في رواية "المذنبون" أسطورة بداية الخلق والهبوط من
الجنة، على لسان الحاوي، فنجده يبرئ الرجل من تلك الخطيئة "لم يعص آدم خالقه
إلا بعد مدة، وذلك عندما وجد إلى جانبه امرأة... هذه الثمرة التي قذفت بأبينا
من السماء إلى الأرض." هنا يقع الكاتب أسير القراءة التقليدية لهذه الأسطورة،
فالهبوط من الجنة سببه المرأة، إذ لم يعص الرجل خالقه ويأكل من الشجرة المحرّمة
إلا بسببها، وقد استخدم الروائي فعلا ذا دلالة سلبية عنيفة (قذفت) بتأثير
القراءة التوراتية للأسطورة! في حين نجد القراءة المنصفة تحمّل كلا من الرجل
والمرأة مسؤولية الخطيئة الأولى، وهذا ما يؤكده تعالى في قوله "فأزلهما
الشيطان" (سورة البقرة آية 36)
رغم ذلك لا نلمس حقدا على المرأة التي يدعوها بـ(الثمرة) فيماهي
بينها وبين الثمرة اللذيذة التي حرمها الرجل في الجنة، وعوّضته عنها المرأة في
الدنيا!
جماليات الصورة:
لن تخرج جماليات الصورة التي رسمها فارس زرزور عن مفردات البيئة
القروية وعاداتها، التي تهب المرأة حرية الحركة والاختلاط أكثر من البيئة
المدنية! فمثلا حين يرى الوكيل (عواد) أن فرحة رقيقة العود لن تستحمل مشاق
السفر والعمل، يجيبه أخوها (عمر) "متى كان القروي يخزّن الأنثى في الخزانة.؟"
تمتاز لغة هذه الصورة بحيويتها بفضل استخدام الاستفهام الاستنكاري،
وبفضل الألفاظ البسيطة التي تقربها من العامية، وقد امتلكت جملة (يخزّن الأنثى
في الخزانة) جماليات لافتة! إذ استخدم فعلا مشتقا من أثاث منـزلي لا يستغنى عنه
(الخزانة) كما تمتاز بدلالتها العميقة على البيئة الريفية، التي لا تعرف حجب
المرأة في البيت، وخزنها مثل أية قطعة أثاث! بل نجد صيغة الاستفهام تستنكر ذلك،
فالمرأة القروية تحمل من المسؤوليات الحياتية ما ينوء عنها الرجل في كثير من
الأحيان! لذلك كان أول ما تتعلمه البنت هو "كيف تخدم الرجل..." وقد عايشنا
صورة القروية التي لا تعمل في الحقل عبر دلالات ذات ظلال سلبية مستمدة من
البيئة الزراعية بنباتاتها المتوفرة والرخيصة (فهي لا تساوي بصلة) كما هي
مستمدة من حيواناتها المتواضعة (الفتاة لن تنفق في سوق الزواج إلا إذا عملت
كالجحش!!!)
ترسم لنا هذه اللغة نظرة دونية للمرأة، لكننا لا نستطيع أن نتهم
الروائي بتكريس هذه الصورة السلبية لها، خاصة أنها تصدر عن رجل مختل هو صالح
الذياب!! في حين وجدنا المتعلم (عمر في رواية "الحفاة وخفي حنين") يستنكر
استخدام لغة دونية تلحق بالمرأة، وتوحي بتشييئها، لذلك يعترض أن تسمي أمه المهر
الذي دفعه عواد لأخته فرحة (عربونا) وبذلك بدأ المتعلم يسائل اللغة، التي ترسم
صورة غير إنسانية للمرأة، فيستنكر تلك المفردات، التي تبدو جزءا من الحياة
اليومية، تستخدم دون أن ينتبه لدلالاتها! مع أنها تحرف العلاقة الإنسانية بين
المرأة والرجل عن سياقها الإنساني، وتحولها إلى عملية بيع وشراء، فكأنه يحث على
استخدام لغة جديدة تؤسس لعلاقة جديدة بين المرأة والرجل!
جماليات القبح:
تبدو صورة المرأة، غالبا، مرسومة بخطوط قاتمة ومشوهة، إذ تكررت
الصورة الشوهاء للمرأة ، التي لحقتها العاهات، فالفتاة البريئة (تميمة في رواية
"حسن جبل") بكماء أشبه بالبلهاء، في حين كانت (أسماء) زوجة حسن جبل عوراء، أما
الشابة فهدة في رواية "المذنبون" فهي عرجاء، في حين تصاب الأم بالعمى ("أم
جدعان" في "المذنبون" وأم عمر في "الحفاة وخفي حنين")
ترى هل يقصد الكاتب من هذه الصورة المشوهة أن يبيّن لنا أن الواقع
المشوّه بالمرض والفقر والجهل والاستعمار، لابد أن يفرز عاهات تعوق الحياة
الطبيعية!؟
وقد لاحظنا أن (فهدة) هي الوحيدة التي تخلق عاهتها معها، ولم تكن
بسبب الجهل والمرض، لكننا حين نتأمل العلاقة بين أمها وأبيها، نجدها علاقة غير
إنسانية (بين عبدة وسيدها) لهذا لابد أن تنجب كائنا مشوها!
لعل صورة فهدة (في رواية "المذنبون") أكثر الصور تأثيرا بعمقها
الإنساني وقدرتها على الكفاح من أجل حياة طبيعية في ظل فقر مرعب! فقد كانت
قبيحة ومشوهة (عرجاء) دون أن يجسر أحد على أن يدفع ثمنها ولو دجاجة، على حد قول
الراوي، لهذا يبدو زواج المبادلة في صالحها، تحسنت حياتها بعده، فبدت صورتها
أكثر وضوحا في الذاكرة، فهي تعمل في البيت وخارجه، دون أن تعوقها عاهتها، فهي
لم تعش عقدة نقص مدمرة، ولن تملأ نفسها حقدا على الآخرين الأصحاء! كذلك لم
نجدها محبطة الذات، تغوص في سوداوية القهر والحرمان الذي يولده الإحساس بالنقص!
على النقيض من ذلك تعيش حياتها موفورة الحيوية، مليئة بالحب والعطاء! لعلها
بذلك تعوض النقص الذي تحسه!
إن اجتماع الفقر والجهل يحطمان الصورة الجميلة للمرأة، ويسلبانها
روحها! فتبدو منسلخة عن إنسانيتها، راضية بأن تسلم قيادها لأخيها! إذ يبدو سؤال
الهوية والبحث عن الذات يحتاج إلى وعي ومستوى معرفي تفتقده القروية في
الخمسينيات! أي في زمن القصة!
وجدنا لغة تشبيه المرأة بالحيوان لدى الأمي (صالح الذياب) ولدى الأخ
المتعلم (عمر) إذ خاطب أخته حين غضب بلغة شديدة القسوة، إذ شبهها بالكلب!
دلالة العنوان:
في عنوان قصته القصيرة "42 راكبا ونصف" يخالف زرزور أفق توقع
المتلقي، إذ يتبادر لذهنه أن المقصود من كلمة "النصف" المثبتة في العنوان هو
المرأة، انسجاما مع الفكر التقليدي ذي النظرة الدونية للمرأة، لكنه يفاجأ بأن
المقصود هو رجل أشبه بمسخ اخترعته مخيلة الكاتب! وجعلته إنسانا يتحرك دون أن
يكسو قفصه العظمي وجمجمته أي شيء!
أما في الروايات فلم نجده يخصص للمرأة أي عنوان، مثلما خصص الرجل
بعنوان "حسن جبل" ربما للدور الذي لعبه الرجل في معركة الاستقلال ضد المستعمر
الفرنسي، في حين بدا دور المرأة هامشيا، لكننا لاحظنا أن معظم عناوين رواياته
تضع المرأة والرجل في خيمة البؤس الواحدة "الحفاة..." "المذنبون" "الأشقياء..."
فتبدو المرأة شريكة شقاء الرجل مثلما هي شريكة حياته!
دلالة الاسم:
يتكرر اسم (فرحة) في رواية "المذنبون" و"الحفاة وخفي حنين" كما
تتكرر الصفات التي لحقت هذا الاسم (الشباب، الجمال، الفقر، وجود الأم الحنون
والأخ...) هنا نتساءل هل السبب في تكرار هذا الاسم رغبة الكاتب بأن يوحي بدور
المرأة في الحياة، وما تبعثه من فرح يجعل الحياة البائسة محتملة في القرية
الفقيرة أو في عربة البهائم في القطار المتجه بالقرويين للعمل في الحصاد!
ثمة حساسية مرهفة في اختيار اسم المرأة لدى الكاتب، إذ احتار اسم
فرحة للفتاة الجميلة السليمة، في حين اختار اسم أنثى الحيوان (فهدة) ليطلقه على
الفتاة العرجاء، لكنه لم يختر اسم حيوان ضعيف أو ذليل بل اختاره قويا يوحي
للمتلقي بقدرة هذه الشخصية على مواجهة أعباء الحياة في غابة البشر!
سيختار للشاب (عمر) المتعلم اسما مستمدا من التراث يحمل دلالات
إيجابية في إحقاق الحق والعدل، ومواجهة الظلم! في حين يختار للجاهل اسم (جدعان)
يدل على الشجاعة والقوة في مواجهة الظروف القاسية، لهذا بدا اسمه منسجما مع اسم
زوجته (فهدة) مما يوحي لنا بأنهما سيحققان معا انتصارا في معركتهما مع الفقر!
أضيفت في28/01/2007/ خاص
القصة السورية / المصدر الكاتبة (
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   
------------------------------------
*
د. ماجدة حمود من مواليد دمشق 15/ 11/ 1954
نالت الإجازة من قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة دمشق
نالت الدبلوم/ القسم الأدبي عام1979/ من قسم اللغة العربية/ كلية
الآداب/ جامعة دمشق
نالت شهادة الماجستير عام 1984/ من قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/
جامعة دمشق، كانت الرسالة بعنوان "الشخصية الفلسطينية في أعمال غسان
كنفاني"
نالت شهادة الدكتوراه عام 1988 / من قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/
جامعة دمشق، كانت الرسالة بعنوان "حركة النقد الفلسطيني في الشتات"
_ عينت مدرسة عام 1988 في قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة دمشق
_رفعت إلى درجة أستاذة مساعدة 1994
_ رفعت إلى درجة أستاذة عام 1999
مؤلفات د. ماجدة حمود
1."النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات" دار كنعان، دمشق، ط1، 1992
2."القلق وتمجيد الحياة" بالمشاركة المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت، ط1، 1995
3."رواية الحب السماوي بين مي زيادة وجبران خليل جبران" دار الأهالي،
دمشق، ط1، 1997
4."علاقة النقد بالإبداع الأدبي" وزارة الثقافة، دمشق، ط1، 1997
5."نقاد فلسطينيون في الشتات" دار كوثا، دمشق، ط1، 1998
6."مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن" اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1،
2000
7."الأدب المقارن: مدخلات نظرية ونصوص ودراسات تطبيقية" بالمشاركة،
منشورات جامعة دمشق، ط1، 2001
8."الكواكبي فارس النهضة والأدب" اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط12001
9."الخطاب القصصي النسوي: نماذج من سورية" دار الفكر دمشق، ط1، 2002
10."صور أدبية في الحضارة الإسلامية: دراسات في صورة الآخر" المستشارية
الإيرانية في دمشق، ط1، 2003
11."جماليات المغامرة الروائية لدى غادة السمان" دار الطليعة، بيروت،
ط1، 2005
12."جماليات الشخصية الفلسطينية لدى غسان كنفاني" دار النمير، دمشق ،
2005
بالإضافة
إلى مجموعة من المقالات والبحوث المنشورة في الدوريات العربية
الرسائل الجامعية التي نوقشت بإشراف د. ماجدة حمود
•رسالة دكتوراه بعنوان "البطل في الرواية الفلسطينية"
•رسالة دكتوراه بعنوان "دراسة نقدية تطبيقية للقصة القصيرة السورية"
•رسالة ماجستير بعنوان "النقد الأدبي عند الرافعي"
•المشاركة في مناقشة العديد من الرسائل الجامعية في جامعة دمشق وجامعة
تشرين في اللاذقية وجامعة حلب، وجامعة البعث في حمص
أضيفت في16/01/2006/ * خاص
القصة السورية / المصدر:
الكاتبة د. ماجدة حمود
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

الأنوثة
المطعونة في قصص
زينب أحمد حفني
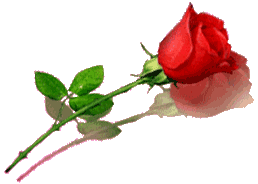 بقلم الكاتبة:
د. عبد الله
أبو هيف بقلم الكاتبة:
د. عبد الله
أبو هيف
تعد قصص الكاتبة السعودية
زينب أحمد حفني (هناك أشياء تغيب) شهادة طيبة على تطور السرد الأنثوي
لأسباب كثيرة أذكر منها؛ أولاً دوران المجموعة بكاملها حول موضوع محدد هو
حرية جماعتها المغمورة، فلا تزال المرأة عندها تنتمي إلى جماعة مغمورة
تعاني وطأة العيش في شرط تاريخي واجتماعي قاهر، وثانيها هو مقدرتها الفنية
العالية على صوغ سردي شديد الإيماء ضمن تحفيز واقعي غالباً ما يفلح في
إنتاج دلالاته وتثمير غرضه، وثالثها تنوع نماذجها النسائية وتعدد مشكلاتهن،
ورابعها ابتعادها عن التماهي السيري أو الذاتي مع نماذجها المقهورة،
وخامسها ضبط المنظور السردي وتلوينه بترميز شفيف.
تهدي القاصة مجموعتها، على
سبيل الترميز اللماح (إليه.. بالرغم من كل شيء (ص 7)، وفي (11) قصة قصيرة
حوتها المجموعة، حيث يظهر التوق إلى الحرية لدى نساء في أوضاع مختلفة، وهن
واعيات لشرطهن الاجتماعي والإنساني، فتتباين مواقفهن من حال إلى حال،
مدركات لمصائرهن المعذبة.
تتجه المرأة في القصة التي
تحمل عنوان المجموعة (هناك أشياء تغيب) إلى موعدها معه، في مطعم الروشة
ببيروت، فقد بعثت له رسالة بالبريد الإلكتروني مبدية رغبتها في جسر من
التواصل بينهما، وسرعان ما ينتصب الحاجز: مراودة توكيد الأنوثة وحريتها،
وتوكيد الذكورة وقيودها وسطوتها. وهي اللعبة المستمرة في هذا الظرف، وكانت
المعادلة الصريحة التي تتبدى في التعرية المتبادلة بينهما، وتعهدها أن يكون
الأوحد في حياتها، فهو رجل شرقي الهوى أرفض أن يزاحمني شيء في عواطفي (ص
17)، على أن المرأة ترفض الخنوع في داخلها من جهة، وتعلن قبولاً أنثويا من
جهة أخرى.
تتناول القصة، على وجه
الخصوص تعذر الاتصال بين الرجل والمرأة، إذ سرعان ما جاهرت الأنثى بمعاداة
الذكورة لتسلطها عليها، وخاطبته نافية للخنوع، وألا تتقبل ديكتاتوريته، فهو
رجل معقد، مغرور لا ثقة له بالنساء! (ص13).
وتعالت انفعالية الأنوثة من
الذكورة، واتهمته أن (النتيجة واحدة سواء كانت المبادرة منك، أم مني.. ألم
تكن راغباً في لمس يدي؟!) (ص14)، ثم أعلنت تباهيها بأنوثتها، وتفاخرها
بنجاحاتها على الرغم من طغيان الذكورة وهيمنتها، بينما واجهها الرجل ساخراً
من تمجيدها لذكائها، وأدان حريتها على أنها امرأة رخيصة، فريسة من السهل
اصطيادها(ص15)، وتفاقمت نبرته العدائية عند مخالفة خدش الحياء، وأشار إلى
تجاربها القاسية، ورفضه للاعتراف بذاتها الخاصة.
أما هي فأكدت فشل العلاقة من
جديد، بتأثير الضباب في رؤيته، (وهذا لا يعني وجود عيب قهري في شخصيتك، أو
شخصية الطرف الآخر!) (ص16)، وانتقدت عشق الرجل للمرأة التي تظهر الضعف
والاستكانة، وتبطن الحيرة والذكاء، وداهمته في دواخله، وأعلن أنه شرقي
الهوى، ورافض لمزاحمة عواطفه.
وعاودت مخاطبته ليقبل
الأنوثة ضمن خصوصياتها واستقلاليتها وإرادة الحياة عندها، فلم (يجد حرجاً
في ضمّها، ثم استغرقا في حديث هامس) (ص18).
كشفت قصة (بيت خالي) عن
مقدرة حكائية ماهرة في بنية سردية قوامها تحفيز واقعي مفعم بنبرة إنسانية
موحية وداخلية في الوقت نفسه، فثمة انتقال ذكي بين الارتجاع والراهنية حين
تمتزج صورة الفقدان ثقيلة ضاغطة على الوجدان، إذ فقدت ابنة خالها صفية التي
تتلامح صورتها في صورة خالها نفسه. ثم دعيت للتعزية بوفاة خالها... وتتداعى
أحزان فقدان الخال وأحزان فقدان صفية الذي لا يبارحها، ما تزال صورة صفية
حية على الرغم من رحيلها المبكر بتأثير الحب، فقد تطوحت في الهواء عن السلم
وسقطت على الأرض الصلبة لتموت بعد ثلاثة أيام؛ لأنها أرادت أن ترمي رسالة
لصديق ابن الجيران، وكأنه نقد خفي للفصل بين الجنسين. وعندما خرجت من بيت
خالها إثر التعزية، دمعت عيناها، و(أمرت السائق بالتحرك، أيقنت أني لن أخطو
عتبة البيت مرة أخرى) (ص25).
نجحت المرأة في قصة (لم تكن
تدري!) بتسوية قضايا التركة العالقة مع أهل زوجها المتوفي، ولعلها وقعت
بحبّ المحامي من أول نظرة، ولا يفارقها عشقه، وعندما أفلح ماضيها، من وجهة
نظرها، في كسب الدعوى، ركضت إليه، وأعلنت حبّها له، غير أنه عاجز عن
التواصل معها، فقد تلاشى إيمانها بتملكه و(أحست بحاجتها إلى نسمة توقظها من
كابوسها الضاحك الباكي) (ص17).
أظهرت قصة (أغنية منسية) ولع
الذكورة بالأنوثة، وبالعكس، على أن يكون عابراً، وغير مستقر، فقد التقى بها
في مقهاها بلندن، واستمعت إلى خطبته السياسية عن وضع بلاده العراقية
البائس، على أن (الحرب أكبر وصمة في تاريخ البشرية. إنها دليل قاطع أن
الإنسان ما زال بربرياً في دواخله!)(ص75).
ودعاها لربط أواصر المحبة
والألفة بينهما في رحابة الحرية، بعيداً عن التلازم أو الالتزام، واعتذرت
له عن دعوته لأنها لا ترغب التورط في علاقات عابرة، وقد اجتاحتها رعشة
مفاجئة، وتلفتت جزعة، وعقدت ذراعي في بعضهما، (بتعبيرها)، أحكمت ردائي
بقوة، طردت خيبتي، غادرة المكان بسرعة (ص78).
وهجت المرأة في قصة (وغسلت
حياتها) الرجل، إذ قُبض على زوجها المدمن، وبدأت هي مع أولادها حياة جديدة،
واعترفت علانية أنها مسرورة لخروجه من حياتها، وخلاصها منه، وأنها ستبدأ
حياة مضيئة باستقلالها عن عبث الرجل وهدره للمرأة.
أبانت قصة (وسقط كوبي
الزجاجي) نبرة أخرى لرفض التبعية للرجل، إيماناً باستقلالية المرأة، وها هي
ذي تتذكر صورته ورحلتها معه إلى روما، وكيف رفضت أن تكون مطيته، وكيف
اقتنعت أن الهرب هو أفضل الطرق للنجاة، فلاذت بنفسها، ومسحت دمعتين، وعادت
لنبش أشيائها.
تبتعد قصص زينب حفني عن ذلك
التماهي السيري أو الذاتي، فلا تقف عند مشكلة واحدة، ولا تنسب القهر إلى
الرجل وحده، لأن الروح الإنسانية هي علامة الرجاء، ولا فرق في ذلك بين ذكر
وأنثى، كما في قصة (وغرقت في نفسي)، حين عرفت المرأة حكاية العم جابر الثري
الذي صار أبله الحارة في جدة، لأن زوجته خانته مع رجل آخر، مما يعيد إلى
البال قصة خيانة زوجها مع خادمتها الآسيوية، وطلاقها منه.
تناولت حفني في قصتها (امرأة
فقدت وجهها) قلق المرأة من دخولها سن اليأس وخوفها من نهايتها كامرأة.
وتشابك هذا القلق مع حكايات انتحار نساء في صقيع الشيخوخة، مما جعلها تقرر
عودتها إلى الحياة بالعمل، غير أنها لا تفارق الخشية من سيرة المرأة وأثر
صقيع الشيخوخة عليها، مما أنهك طاقتها، وأضعفها، فخمدت في الهزال، وكأن
الرجل لا يقبل المرأة إلا في شبابها، فطلبت من خادمتها إغلاق الباب، (وغصت
من جديد في بحيرة النوم) (ص48).
طالبت الزوجة البائسة زوجها
بحقها في الحبّ والحياة في قصة (وباتت متورمة الجفنين)، وطالت سنوات
عذابها، عند استئصال نهدها الأيسر من قبل طبيبها، قبل أن ينتقل الورم إلى
نهدها الآخر، (بقاؤه فيه خطر على حياتك) (ص50)، ثم اتسعت الفجوة بينها وبين
زوجها، وتأكدت أنه يعبث بمفرده في وعاء فحولته، حتى أنه، برأيها، يخونها،
(هناك امرأة أخرى في حياته!) (ص52)، وأرعبها أن زوجها يتمنى موتها، وصارت
الجفوة بينهما مؤذية، على أنه يمارس ذكورته بمفرده، فقتلته بأحد أمواس
الحلاقة، و(مررتها ببرود على عنقه، انفجر الدم في وجهي، تناثر على منامتي،
مفترشاً غطاء سريره، الرائحة الغريبة تختفي، تذوي، تذوب، جثوت على ركبتيّ،
شممت بنشوة رائحة دمه الفاتر، وضعت رأسي على صدر زوجي، ورحت في سبات عميق!)
(ص55).
لجأت القاصة إلى أسلوب
الأمثولة في كتابة قصتها (الخرزة الزرقاء)، حين مهدت لها بعتبة احترازية
مفادها أن وقائع هذه القصة حدثت (في مكان ما بأحد البلدان العربية) (ص16)،
والقصة عن لقاء مفترض بين امرأة ورجل يحاكم النسوية العربية، ولكنه يندفع
بشبق نحوها فتقاومه، إلى أن يحكم عليها، ويأمر الحارس بتقييدها. إنها
الأنوثة المطعونة من ذكورة تتلبس نمط العيش والتفكير بعد ذلك، وهذا ما
تقوله قصص، (هناك أشياء تغيب) الأخرى ببلاغة سردية لا تخفي.
استغرقت قصص زينب حفني
بالنسوية المناهضة للذكورة على أن الأنوثة مطعونة تحت فساد العلاقة بين
الرجل والمرأة.
زينب أحمد
حفني: هناك أشياء تغيب، مجموعة قصص، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت
أضيفت في16/01/2006/ خاص
القصة السورية /
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

|
