|
فلتسقط الحرية.. ولتحيا العبودية!
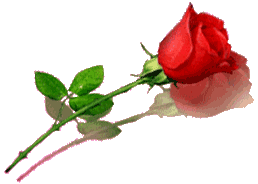 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
كثيرة تلك الصور التي تجعلنا نداري وجوهنا خجلا كلما مرت مشاهدها
امام مخيلتنا، او لوح الغرباء بها امام انظارنا، في رغبة خبيثة لاماطة اللثام
عن حقيقة امتنا العربية، فيعرون شخصيتها المهزوزة، ويفضحون على الملأ العيوب
التي تملأ جسدها، حتى تكف هذه الامة عن التلاسن والتناحر، ورمي كل فئة اخطاءها
في سلال الآخرين!! امة للأسف تعودت على لعق جراحها باستكانة الضعفاء، وعلى رمي
مطالبها ببرود في اقرب محرقة ثم تشعل النار فيها لتتحول الى رماد، بعدها تنتظر
اول ريح تهب لتبعثر رمادها وتنسى ما لها وما عليها. امة عربية صارت تعيش في
منطقة متأرجحة، بين فتونة مزيفة، ورجولة ناقصة، لا تعرف كيف تطالب، واذا طالبت
فلا تعرف كيف تساوم، واذا ساومت فلا تعرف كيف تأخذ ما لها وتعطي ما عليها!! هذه
هي اوضاع الامة العربية اليوم، لم تتعلم من تجاربها التاريخية سوى التلصص من
ثقب الباب الذي بالكاد لا يبين سوى موقع اقدامها، دون ان تحاول القاء النظر الى
البعيد لاستكشاف الحدود المرسومة، ومعرفة أين وصل بأهلها المآل، كأن الذي يجري
من حولها لا يدخل في دائرة اختصاصها كأمة عربية مسلمة! عندما نفضت امريكا يدها
من افغانستان، واعلنت فوزها في القضاء على طالبان، لم تحاول الامة العربية
المسلمة ان تتساءل وماذا بعد كل هذا الدمار؟! لم تُصدّع رأسها، ولم تستفسر عن
المردودات السلبية لهذه الحرب التي راح ضحيتها اعداد كبيرة من المدنيين؟! المهم
في الامر ان امريكا شفت غليلها وانتقمت لكرامتها المهدرة رغم فشلها في القبض
على بن لادن والملا عمر!! ثم جاء دور الاعلام الغربي ليكمل تحضير الوجبة
المحروقة في شكل خبر مقتضب يبعث على السخرية، فحواه ان المفوضية الاوروبية
اطلقت برنامجا اذاعيا يوميا ترفيهيا من اذاعة كابول تحت عنوان «صباح الخير يا
افغانستان». سخرت من الاسم معلقة بأنه كان من الافضل ان يطلق على البرنامج صباح
الحزن يا افغانستان، ففي رأيي ان افغانستان ما زالت تتخبط في مستنقع مشاكلها
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كنت اتمنى لو قامت اذاعة كابول ببث برامج
تتحدث عن المنازعات السياسية، نتيجة عودة القبائل للتناحر من أجل الاستحواذ على
السلطة. كنت اتمنى ان تلقي الضوء على زراعة المخدرات التي تنتشر بشكل واسع في
افغانستان، مع تأكيد الهيئة الدولية لمراقبة وتهريب المخدرات، ان انتاج
المخدرات وتهريبها جزء لا يتجزأ من المجتمع الافغاني. كنت اتمنى ان تلقي الضوء
على معاناة الشعب الحياتية من أجل توفير لقمة العيش، وسط مناخ قاس من الحرمان
والضنك، واضطرار بعض الآباء بيع ابنائهم لسد جوع الاسرة. وقد نشرت صحيفة «الشرق
الأوسط» مؤخرا صورة لرجل افغاني قام بمقايضة ولديه مع أحد الاثرياء بتموين شهري
من القمح. أليس هذا نوعا من الرق كان سائدا في عصور الجاهلية؟! لقد عاود الظهور
في العقود الأخيرة في بعض دول العالم الثالث، نتيجة الحروب والمجاعات التي
التهمت خيراته وأقضت مضاجعه نتيجة انشغال الساسة بأطماعهم السلطوية على حساب
أمن واستقرار اوطانهم. معظمنا يقدّر ظروف الاب الذي يدفع بأولاده الصغار الى
العمل من أجل كسب لقمة العيش بطريق شريف. وجميعنا يتعاطف مع الاسر التي تحرم
ابناءها من التعليم لعدم قدرتها على تغطية تكاليف تعليمهم، لكنني لم استوعب كيف
يمكن ان يبيع الاب فلذات كبده لانعدام فرص الحياة. لا اعرف كيف يمكن ان يجرّد
اب ولده من حريته، وهو يدرك في قرارة نفسه أن الحرية هي اثمن ما في الوجود،
كونها هي التي تشعر الانسان بآدميته مهما تجرع من كؤوس الظلم، ومهما ذاق من مر
الحرمان!! لكنني بعيدة عن هذه الأوضاع المأساوية، فلم يقرصني الجوع يوما في
وطني، ولم اسمع طوال عمري هدير طائرة حربية، ولم يخترق أذني صوت القنابل ولم
ترم بي الظروف في ارض تعجُ بضحايا المجاعات والحروب، لذا التمس الاعذار لهؤلاء
الناس، واعتب على الامة العربية التي تقف موقف المتفرج أمام كل ما يحدث لهذا
الشعب المسلم! التقيت بسيدة افغانية مثقفة في لندن تشغلها هموم وطنها، طلبت مني
السفر معها الى كابول لأرى بأم عيني ما يجري على حقيقته هناك، مؤكدة لي ان ما
ينشر في الصحف ويعلن عنه في محطات الاذاعة لا يعبّر إلا عن جزء بسيط مما يجري
على ارض الواقع. قالت لي ان الأمر لم يعد يتوقف على انتشار الرق وعودة
العبودية، لكن في ظهور جمعيات تنصيرية تأخذ الاطفال المسلمين الذين قتل ذووهم
في الحرب، وتدفع بهم الى اسر مسيحية تقوم بتبنيهم وتغيير ديانتهم، وتتم هذه
العمليات في سرية تامة. قالت لي.. نحن شعب محكوم عليه بالموت كل يوم، واعتدنا
الغوص في بحور من الدم حتى صرنا نؤمن بأن الاستقرار لن يعم يوما ارضنا. نريد ان
تكون لنا كشعب الاحقية في اتخاذ قرارات تخص مصائرنا، لكن المشكلة ان الشعب لاهٍ
في تضميد جراحه المعيشية، تائها على ارضه المخضبة بأحزانها. سألتها.. لماذا
تعيشين هنا، وليس هناك وسط اهلك؟! لماذا لا تتبنين قضية وطنك من هناك؟! قالت..
بالرغم من سلبيات الغرب الكثيرة، إلا انني هنا استطيع ان افعل شيئا. اذا صرخت
يسمع الجميع صوتي، اما في بلدي فالصراخ رد فعل اعتيادي، يرتد صداه في حجرة نومي
دون ان يلتفت اليه احد!!. طرحت تساؤلات كثيرة، وسمعت آهات موجعة، خرجت بقناعة
ذاتية ان التفكير في مصير هذا البلد مثل الكلمات المتقاطعة التي يتعب المرء من
الدوران في زواياها ليضع الحروف المناسبة لها، وان الافضل طي صفحاته المتشابكة
الى الابد، لكنني عدت مرة أخيرة للتساؤل.. ايهما افضل للانسان.. التمتع بحرية
ناقصة الاهلية ام التمرغ في لقمة عيش مضمونة؟! واذا اختار المرء طريق الكرامة
ودرب الحرية، الا يصبح الموت لحظتها واقعا محتوما؟! اعلم ان الموت في بعض
الاحيان يكون راحة للكثير من المعذبين على الارض، لكن عندما يصبح الموت الحل
الاوحد هنا تتحول الحرية الى هدف رخيص، ومن الصعب لحظتها اجبار الشعب الافغاني
على اختيار طريق الحرية، فالجوع يشل حواس الانسان، ويضطره الى الوقوف على حافة
الهاوية، صارخا بقوة وبملء حنجرته.. فلتسقط الحرية.. ولتحيا العبودية.. المهم
ان اعيش.. اعيش!
16/3/2002
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

نساء «مسترجلات»!!
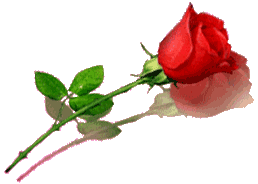 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
اختير اليوم الاول من فبراير في كل عام، ان يكون «يوم المرأة
العربية». وهذا العام اهتم المؤتمر، مثل سابقيه بالتركيز على ضرورة تهيئة ظروف
اجتماعية واقتصادية وسياسية تلائم المرأة العربية العصرية. والسؤال الذي يردده
الكثيرون من الجنسين عند اقامة كل مؤتمر نسوي.. هل نجحت المؤتمرات في تذليل
الصعاب التي تواجهها المرأة العربية داخل مجتمعاتها؟! هل بالفعل ساهمت البنود
التي يتم وضعها، في تحسين وضع المرأة في بلدها؟! أم أن كل المقترحات داخل أروقة
المؤتمرات لا تتجاوز في ردود أفعالها، قيمة الحبر الذي أهدر في كتابة
بياناتها؟! وهل التهاون في تطبيق المقترحات، تقع مسؤوليته على المسؤولين
المشرفين على تنفيذها؟! أم ان كافة الافراد داخل المجتمعات تقع عليهم المسؤولية
الكبرى؟! وهل من الممكن فصل الصورة القاتمة التي تحيا فيها المرأة العربية
اليوم، عن التردي الفكري والاقتصادي والاجتماعي، الذي يعد نتيجة حتمية للأوضاع
السياسية المتأزمة داخل الأقطار العربية، التي أصبحت تعيش على قنابل موقوتة؟!
هل من الاجحاف القول بأن المرأة العربية، وحدها التي تعاني من هذه
السلبيات القاتلة معنويا، ام ان الرجل العربي صار ايضا يدور في ساقية البطالة،
ويتجرع من كؤوس الفقر الذي ارتفعت شعبيته في مجمل البلدان العربية؟! هل تقييد
ادوار المرأة بحجة انها مخلوق هش، غير قادر على تحمل المسؤوليات الجسام، جعلها
تستسلم طواعية لوضعها؟! أم ان المرأة تتحمل جزءا من هذا الاثم، كونها استسلمت
لمصيرها الذي كبلها فيه المجتمع، دون ان تحاول كسر القيود المفروضة عليها،
والمطالبة بحقوقها التي اندثرت تحت اغطية الاعراف والتقاليد الذكورية، التي
توارثتها الاجيال؟! ام ان المجتمع برجاله ونسائه يقع عليه الوزر الاكبر، من
خلال تأييدهم للادوار الثانوية الموكلة للمرأة، ودفعها على القبول بنصيبها
الضئيل من «قالب حلوى» المجتمع؟! واتذكر هنا عبارة جميلة تحمل مضمونا ساخرا
للأديب الايرلندي جورج برناردشو «لا تحاول ان تغير فكر المرأة.. فتحرمها بذلك
متعة تغييره من تلقاء نفسها!!». فهل فقدت المرأة في عالمنا العربي متعة تغيير
واقعها!!
في حادثة نادرة في المجتمعات الاسلامية، صرح رئيس الوزراء الماليزي
مهاتير محمد، بأنه يفضل تعيين النساء في المناصب العليا لأنهن اكثر كفاءة من
الرجال، متابعا بأنه يعتمد على الكفاءة وليس على نوع الجنس!! هذا القول الذي
ادلى به رئيس الوزراء الماليزي، يعكس حالة نادرة في التاريخ الاسلامي المعاصر
عامة وفي العربي خاصة، حيث ان الاغلبية اليوم لا تقر بتفوق المرأة على الرجل،
بل هناك من يستهين بقدراتها، ويستخف بانجازاتها، وان من تقحم نفسها في مواقع
مقتصرة على عالم الرجل، تنعت «بالمرأة المسترجلة»، كأن النبوغ والتفوق العلمي
من خصائص الرجل فقط!! والشيء الآخر الذي أثار دهشتي سلبا صورتان، احداهما في
مصر، من خلال المؤتمر الذي عقد عن المرأة المبدعة في العام الماضي، من اجل
تذليل الصعاب الموضوعة امام المرأة لكي تنتج، حيث اقترحت واحدة من الناقدات،
منح جائزة خاصة لكل رجل يُقدم الدعم للمرأة المبدعة، ويتيح لها الفرصة للتميز
والابتكار، وقد تساءلت حينها ان كان هذا الاقتراح يعني بالفعل مساندة المرأة في
نتاجها الابداعي او الفكري، ام انه تأكيد على ان المرأة لا تقوى على الصراع
بمفردها دون عون الرجل!! أليس هذا بخسا في حق ملايين النساء اللاتي استطعن
الصمود بمفردهن، ودفعن اثمانا باهظة من اجل قلب عجلة التاريخ لصالحهن، دون ان
ينتظرن أيدي ذكورية تأخذ بأيديهن وتدلهن على طريق النجاح!! ألا توجد نساء وقفن
بجانب ازواجهن ليصبحوا رجالا عظماء؟! الا يعطينا صمود المرأة الفلسطينية داخل
الاراضي الفلسطينية، صورة مضيئة لقدرة المرأة العربية على الصمود من اجل تحرير
وطنها؟!
الصورة السلبية الاخرى، كانت في الرياض بالسعودية، حيث قام مركز
سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة، بعقد دورة للسعوديات عنوانها «كيف
تحافظين على الزوج الأخير»، ويدور مضمونها حول كيفية المحافظة على الزوج وعدم
التفريط فيه مهما اشتدت المشاكل، فربما يكون الزوج الاخير!! لقد عقدت الدهشة
لساني، وبدل من ان يكون مضمون الدورة تعريف المرأة بحقوقها التي اقرتها لها
شريعتها، يلقنونها كيف تتنازل عن حقوقها في سبيل عدم اللحاق بركب المطلقات،
والتلويح بشبح الوحدة في وجهها، حتى لو ادى الامر الى جرح كرامتها والدهس على
آدميتها من زوج لا يراعي الله في تعامله معها!! ولا ادري ما المشكلة في ان يكون
هذا الزوج فرصتها الاخيرة!! لماذا تعتبر المرأة نفسها خاسرة اذا فقدت زوجا غير
صالح!! كنت اتمنى ان تسعى هذه الدورة الى نزع آفة الخوف من اعماق المرأة، وتزرع
مكانها الثقة بنفسها، وتشجيعها على عدم الاستسلام لحياة تخلو من المودة والرحمة
التي تقوم عليها دعائم الحياة الزوجية. كنت اود ان تغرس نبتة التحدي في دواخل
المرأة، من خلال تعليمها كيفية مواجهة واقعها، والعمل على تغيير دفة المستقبل
لصالحها، بسلاح العلم والمعرفة.
في دراسة اجريت مؤخرا في بريطانيا على «الزوج المنزلي»، وهو لقب
يطلق على الزوج الذي يترك عمله ويتفرغ لشؤون البيت وتربية الاطفال، ظهر أن هذا
النوع من الازواج معرض لأخطار الاصابة بأمراض القلب بنسبة %28 مقارنة بالرجال
العاديين الذين يحيون حياة طبيعية، وهذا الامر يعود حسب رأي الخبراء الى الضغوط
التي يواجهها الرجل اثناء مهماته داخل البيت. أليست هذه الدراسة دليلا على قدرة
المرأة على تحمل اعباء الحياة!! فكيف إذن الحال بالمرأة العربية المعاصرة
اليوم، التي ترعى شؤون بيتها وتربي اطفالها وتشارك الزوج اعباء الحياة بالخروج
الى معترك الحياة العملية!! أليس في كل هذا ما يدعوها الى التشبث بحقوقها
ومعرفة ما لها وما عليها!!
جميل ان تعقد المؤتمرات، وتقام الافراح والليالي الملاح عند ختام كل
مؤتمر، لكن القضية لا تنتهي بوضع البنود كما هو حادث في عالم السياسة، ومسؤولية
تغيير واقع المرأة نحو مستقبل مشرق يبدأ من دواخل كل امرأة مهما كان وضعها في
المجتمع، وذلك بسؤال نفسها.. هل بالفعل اطمح الى ان اكون عضوا فعالا في
مجتمعي؟! هل أنا بالفعل اسعى لأن اكون مربية واعية لأجيال الغد؟! هل أقدر
بالفعل على ان اسجل علامة بارزة داخل وطني؟! وبعدها سيكون لكل حادث حديث!!
8/2/2003
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

السعادة.. وقفص الذهب!
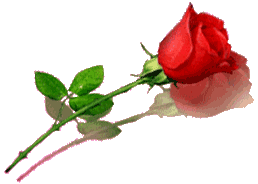 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
ماذا تعني السعادة؟! هل هي بالفعل هدف يسعى إليه كافة البشر مهما
اختلفوا في تعريف مدلولها؟! هل سعادة الناس الحقيقية، محصورة في سعيهم لتحقيق
أمانيهم الحياتية المتباينة؟! وماذا تعني السعادة؟! هل تعني الحصول على مركز
مرموق، أو تحقيق ثروة كبيرة، أو الزواج بمواصفات مغرية، أو تذوق طعم الحب؟! أم
ان السعادة تعني كل هذا؟! أم انها مفهوم واسع من الصعب وضعه في اطار محدد، أو
توزيعه كمنشور وتعليقه في الحوانيت؟! إذا شرعت نافذتك، واطلقت عينيك جهة
الأشجار، لشاهدت العصافير تغرد على الأغصان نشيد الحرية، كون السعادة تعني
لديها الحرية، وما ان تقبض على واحد منها، وتحبسه في قفص حتى لو كان مصنوعا من
ذهب، لرأيت صوته يختنق داخل حنجرته، ويكف عن التغريد، الى ان يموت وحيدا، كون
حريته قد سلبت منه. وإذا أرهفت السمع عند باب كوخ لفلاح فقير، وسمعته يدندن
بنبرة مرحة، فاعلم ان مفهوم السعادة عنده ينبثق من قناعته بحياته البسيطة
بالرغم من مشقتها. وإذا وجدت وميض الفرحة يرتسم في عيني المرأة، فأدرك على
الفور انها تعيش حالة حب، كون مفهوم السعادة عند المرأة مرتبطا بتجرع كؤوس الحب
دوما.
يرى كنفوشيوس، احد حكماء الصين العظام، الذين كان لهم أثر قوي في
التاريخ البشري، ان احساس الإنسان بالحياة، لا يكمن في عدد السنوات الطوال التي
يعيشها على الأرض، وانما من خلال ما حقق فيها من انجازات، وان هناك فئة كبيرة
من البشر يعيشون الى أرذل العمر، وأيديهم بعيدة عن الوصول الى منابع السعادة،
أو احتساء رشفة واحدة تشعرهم بأنهم موجودون على الأرض. وهناك فئة محدودة من
البشر تحيا حياة قصيرة الأمد، لكنها حافلة بالمسرات والأفراح، كونهم وضعوا
أيديهم على مواطن سعادتهم. ويرى كذلك ان السعادة تعني الخير، بمعنى ان الإنسان
كائن اجتماعي بطبعه، وان تبادل الأخذ والعطاء هو الذي يجلب السعادة، وان
الإنسان يسعى الى تحقيق سعادة نفسه، وفي نفس الوقت يساند الآخرين من أجل تحقيق
أمانيهم، ومن هنا يحدث المطب الذي تقع فيه أغلبية الخلق، الذين يتبرمون سريعا
من قيود الصبر، ويسلكون طريقا احمق، ويختارون متعة عاجلة اقل أثرا، حتى لو كان
الثمن بخس حق الآخرين في الحياة، بدلا من التروي لقطف متعة آجلة، أعظم أثرا
للإنسان وللمحيطين به، مرددا مقولته الشهيرة، ان الحكمة تعني معرفة الناس،
والفضيلة هي حب الناس، وان الإنسانية لا يمكن ان تجد السعادة إلا في مجتمع
تعاوني لأناس أحرار، يسألون أنفسهم باستمرار.. ما الشيء الصواب الذي نؤديه في
حياتنا!! وان السعادة الحقيقية ليست لها علاقة بالثروة أو المكانة وانما هي
مرتبطة بالخلق والمعرفة اللذين يعتبران ثمرة التربية الفعلية، وكم من أناس
أهدروا حياتهم في اللهث خلف بريق المال وجاه المنصب وبريق الشهرة، لاعتقادهم
بأن فيها سعادتهم الحقيقية، ليكتشفوا بعد وصولهم الى نهاية الدرب، انهم لم
يتذوقوا طعم السعادة، وان ما غمسوا أنفسهم فيه كان سرابا خادعا، كالذي يراه
التائه في الصحراء خلف كثبان الرمال!! وتاريخ الصين القديم، يبين ان حكماءهم
استطاعوا ادخال السعادة لحياتهم وحياة تلاميذهم، بالتدريب على استخدام القدرات
العقلية للتخلص من الاضطرابات النفسية الحاصلة نتيجة الفقر أو الحرمان
بأنواعه!! لكن الغريب في الأمر ان الدراسات اظهرت مؤخرا ان الصين يموت فيها ربع
مليون شخص أكثرهم من الشباب ومن الفتيات، نتيجة الضغوطات الحياتية، ونقص الوازع
الديني!! وفي إسرائيل أشار تقرير رسمي إلى ان هناك ظاهرة مرعبة بدأت تتزايد
داخل المجتمع الإسرائيلي، وهي محاولة الأطفال، الانتحار، الذي يعود حسب رأي
الخبراء النفسيين، إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي بدأت تغزو إسرائيل
نتيجة التدهور الأمني!!
إننا نتفق جميعا على ان للوازع الديني دورا كبيرا في ردع المرء عن
وضع نقطة النهاية لحياته بيديه، لكن هذه التقارير المعلن عنها هنا وهناك، تجعل
المرء يقف متسائلا.. كيف يمكن ان يؤثر الإنسان الموت على الحياة وهو ما زال في
مستهل الدرب؟! هل سلبيات الحياة العصرية، طغت كفتها على مباهجها ومسراتها، مما
جعل البعض يقرر الرحيل بلغة صامتة؟! هل القضية تعود إلى تفاقم اليأس في النفوس
المتعبة من أزمة الأخلاق والضمائر، التي تتناقص يوما بعد يوم في المجتمعات؟! هل
بالفعل العالم اليوم بحاجة إلى تدريب الإنسان العصري، على تربية أخلاقية جديدة،
تقوم على البذل والعطاء حتى يشعر بالسعادة في داخله؟! هل حصر مفهوم السعادة في
زاوية الأخذ، والأخذ فقط، هو الذي حول الإنسان مع مرور الأيام إلى وحش آدمي،
فقد القدرة على التمييز بين السعادة الحقيقية، وبين المتع الوقتية التي لا تمت
بصلة قرابة لها، ودفعه إلى الغرف بهمجية من متع الحياة دون توقف، حتى لو كان
الثمن الدهس على رقاب الآخرين؟! هل الخوف من المجهول، والفقر، وعدم الاحساس
بالأمان، تكالبت جميعها على سلب الإنسان طمأنينة فؤاده، التي تشكل الحيز الأهم
من سعادة الإنسان؟!
لقد نجح الفيتناميون في اسدال الستار على آلامهم التي تجرعوها على
مدى سنوات، إبان اجتياح الأمريكيين لبلادهم، وأظهرت احصائية نشرت مؤخرا بأنهم
أكثر شعوب آسيا سعادة، وانهم راضون اليوم عن حياتهم، بعد أعوام الفقر والحرب.
نعم المهم تجاوز الآلام والأحزان، وكم من أمم لملمت مصائبها، وودعت نكباتها،
ودفنتها في قبور جماعية، ثم أولتها ظهرها والتهت في بناء مستقبلها، متناسية
الكدمات المتواجدة على جسدها. المهم ان يتعلم كل فرد العزف على قيثارة الحياة
بمهارة، ليس من أجل الأنا القابعة في أعماقه فقط، وإنما من أجل الآخرين أيضا،
فكم من ناي صادق النغمات أحيا قلوبا يائسة!! وان يفكر بروية من أين يبدأ نقطة
الانطلاق، ويتعقب بحذر الجهة التي ستأتيه منها نسمة السعادة، ويعي دروس الماضي
والحاضر ويترقب المستقبل بعين متفائلة، حتى يمسك سعادته الحقيقية بين يديه،
قائلا بصوت طربي.. أنا سعيد.. نعم أنا سعيد.
21/12/2002
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

المرأة.. وصخب الهتافات!
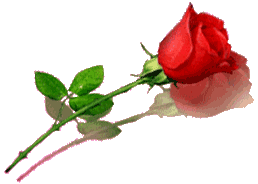 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
هل المرأة العربية ما زالت تقف عند مفترق طرق، بالرغم من عصر
الفضائيات، وثورة التكنولوجيا التي أدت الى تلاشي الكثير من المفاهيم
الاجتماعية في العديد من المجتمعات العربية؟! هل الانفتاح الثقافي والاجتماعي
والسياسي ساهم في تغيير بعض الاعراف المرتبطة بالمرأة العربية؟! هل بالفعل
المرأة العربية استطاعت تحديد اهدافها، والتعبير عن مطالبها في مجتمع ينضح
بالذكورية؟! هناك من يرى بأن المرأة هي أول من تجني على بنات جنسها، وان من
النادر ان تتبنى امرأة آراء امرأة أخرى!! وان المرأة بطبيعتها لا تثق في جنس
حواء، بل ان معظم النساء في داخلهن قناعة ذاتية بأن المرأة لا تملك القدرة
الكافية لحل مشاكل مجتمعها، لاحساسها بأنها مهيضة الجناح بحاجة الى رجل يأخذ
بيدها ويريها الدرب الآمن الذي يجب عليها ان تسلكه.
لقد لفت انتباهي مؤخرا، الخبر الذي نشرته الصحف عن برنامج «الاصلاح
العربي»، الذي انعقد مؤخرا في واشنطن، بالولايات المتحدة الامريكية، والذي
اشرفت على تنظيمه اليزابيث تشيني، ابنة نائب الرئيس الامريكي، هادفا الى تعزيز
ونشر الديمقراطية في منطقة الشرق الاوسط، من خلال اطلاع النساء العربيات على
الدور الذي يجب ان تقوم به المرأة الامريكية في عملية الانتخابات لجهة الترشيح
للانتخابات أو لجهة تنظيم الحملات الانتخابية، وكيفية خوضها كمرشحة داخل امريكا،
وقد اشتركت في البرنامج 50 امرأة عربية من عدة دول عربية. وقرأت كذلك عن
التغطية التي تمت مع حرم ملك البحرين اثناء لقائها مع طالبات جامعة البحرين،
ودعوتها النساء البحرينيات الى وجوب اثبات استقلاليتهن عبر التصويت الحر في
الانتخابات التشريعية.
جميلة هذه المحاولات التي تحدث هنا وهناك في تعليم المرأة أصول
الديمقراطية، أو تنبيهها لحقوقها السياسية، لكنها ليست بجديدة على تاريخنا
الاسلامي كما يعتقد الكثيرون، الذي يحفل بالكثير من المواقف المشرفة لنساء
عربيات، كانت لهن ادوار ايجابية داخل مجتمعاتهن، بل واستطعن قلب أوجه عصورهن
ببسالتهن وسعة أفقهن. لكن القضية في رأيي لا تنتهي بفتح الباب على مصراعيه أمام
المرأة وتشجيعها على المشاركة السياسية. القضية في رأيي أعمق من هذا بكثير، وهي
قضية تصب في تأمل الواقع العربي اليوم!! والسؤال التلقائي الذي يطرح نفسه.. هل
بالفعل المجتمعات العربية متقبلة في داخلها فكرة حق المرأة في الانتخاب
والتصويت؟! إذا سلمنا جدلا بنجاح المشاركة السياسية للمرأة في عدد من الدول
العربية مثل مصر وتونس والمغرب، سنجد ان نسبة نجاحها ضئيلة مقارنة بدول الغرب،
بل ان بعض الدول تدخلت حكوماتها، لفرض بعض اسماء نسائية داخل برلماناتها، لكي
تستطيع المرأة من خلال مقعدها تمثيل بنات جنسها والتحدث باسمائهن. في دول
الخليج يختلف الوضع جذريا، فهناك دول تتقيد بأعرافها، وتحرص على عدم الخروج عن
تقاليدها الاجتماعية، التي هي اشد تأثيرا على الافراد من روافد أخرى، ويكفي ان
ننظر الى دول مثل قطر والبحرين وعمان كنماذج، والتي منحت المرأة الحق في
المشاركة السياسية انتخابا وتصويتا لنرى انها فشلت فشلا ذريعا، في الوقت الذي
ما زالت الى اليوم المرأة الكويتية تصارع من أجل انتزاع هذا الحق دون جدوى. كل
هذه الصور المتباينة المضمون، تؤكد بأن المجتمعات العربية بصفة عامة، والخليجية
بصفة خاصة، ليست مؤهلة نفسيا للسماح للمرأة بأن تحمل على كتفيها قضايا مجتمعها،
وتتحدث باسم افرادها، وهناك مشاعر لاارادية داخل جلَّ افراد المجتمعات العربية
تؤمن بأن المرأة تعجز عن حل القضايا، فكيف بتلك التي عجز عن حلها عتاولة
الرجال!! كما ان المرأة نفسها للأسف لا تثق في بنات جنسها، وتوليهن ظهرها، بل
في قرارة نفسها ونتيجة لتربيتها الاسرية، والمفاهيم التي تلقتها في صغرها،
تستحلي تبعية الرجل، وترشحه لدائرتها عن قناعة كاملة، كما ان النساء يحرصن على
تتبع خط أزواجهن في مواقفهم السياسية، لأن خروجهن عن خطهم قد يتسبب في حدوث
خلافات وانشقاقات داخل الاسر.
في كتابها «شهرزاد ليست مغربية» تحكي فاطمة المرنيسي عن تجربتها بعد
عودتها من امريكا، بعد حصولها على شهادة الدكتوراه، معتقدة بأن كل ابواب العمل
ستكون مفتوحة على مصراعيها أمامها، لتفاجأ بأن المجتمع ينظر الى المرأة الناجحة
بتحفز وريبة وشك، وتحكي عن صدفة جمعتها بأحد الرجال كان يردد بصوت مسموع بأنه
لن يسمح يوما لامرأة بأن تقاضيه، أو تدافع عنه، أو تدير أعماله. هذا الموقف
الذي سردته المرنيسي في كتابها حدث عام 1973، فهل تغيرت نظرة المجتمع الذكوري
للمرأة العربية بعد مرور ما يقارب الثلاثة عقود، أم ان الوضع ما زال على ما هو
عليه؟!
هل يمكن للمرء ان يمشي قبل ان يحبو؟! هل يستطيع الانسان ان يمسك
العصا من قعرها ويتكئ عليها؟! هذا للاسف ما فعلته المجتمعات العربية مع
نسائها!! واجب حتمي ان يكون للمرأة منبر تعبر من خلاله عن قضاياها، لكن الامر
ليس بهذه السهولة، ولا يكفي ان يصدر حاكم دولة فرمانا يجيز به حق المرأة في
المشاركة السياسية، ثم تجري الامور عشوائيا!! لا بد من بحث أمور أكثر أهمية،
والانطلاق يبدأ من قاعدة البيت، بتعويد الفتاة على تحمل مسؤولياتها، وتوابع
قراراتها، لأن هذا سيصقل شخصيتها ويدفعها تلقائيا الى احترام ذاتها واحترام
الحرية الممنوحة لها، خاصة في دول الخليج العربي، التي ما زالت المرأة ترفل في
عباءة الترف، وتستعذب رخاوة العيش!! بجانب تعويد الولد منذ صغره على ان المرأة
ليست مجرد معمل لتفريخ الدواجن، بل كائن له حقوق وعليه واجبات، ليتقبل فكرة
مشاركتها له في جوانب الحياة، حتى لا يستخف بقدراتها حين يكبر ويعي الدنيا من
حوله، مفسحا عن قناعة المجال أمامها لكي تثبت كفاءتها. كما يرى احد الكتاب
العرب ان رفع شعار «المرأة هي الحل»، سيساعد المرأة على الخروج من دائرة
التقوقع، مؤكدا ان اصل البلاء في المجتمعات العربية يكمن في الهيمنة الذكورية،
وفي تفشي الامية التي وصلت الى اكثر من النصف، وان تشجيع المرأة على التعليم
والمعرفة سيؤدي على المدى البعيد الى خلق مجتمعات اكثر تقدما وتطورا، كما حدث
في المجتمعات المتحضرة التي فتحت الباب على مصراعيه امام المرأة لكي تتعلم وتصل
الى ارقى المناصب.
دعونا نتوقف ولو هنيهة عن التنديد صباحا ومساء بالتحرر الجنسي الذي
وصلت اليه المجتمعات الغربية، ولننظر الى الكأس من نصفها الملآن، لنجد ان
المرأة الغربية تدرجت في المناصب حتى وصلت الى منصب رئاسة الوزراء، وهو ما يؤكد
ان القضية في اساسها هي قضية رواسب اجتماعية، ومشاكل عالقة داخل النفس العربية.
إنها مسؤولية مجتمع بكامل افراده، وليست لائحة تكتب بحبر اسود «انتخبوا هذه
المرأة» والسلام!!
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

لعبة الغمـز ولعبـة الحبـس
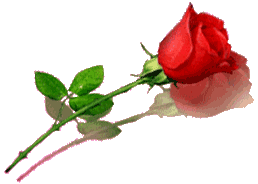 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
ونحن صغار، كنا نمارس لعبة جميلة، تبدأ برسم خطوط على الأرض
بالطباشير البيضاء، ثم نقوم بالقفز برجل واحدة عبر الحدود المرسومة، مع دفع حجر
رخامي صغير بقدمنا، والفائزة من تتجاوز بحجرها الخطوط المرسومة، وتصمد حتى تصل
إلى نقطة النهاية. لا أدري لماذا اليوم عندما تخطر ببالي هذه اللعبة، أقارن
بينها وبين ما يتخلل حياة الصحافي والكاتب من منزلقات! كلاهما مرغم على القفز
فوق الخطوط المحظورة ليصل إلى مراده، لكن الفرق بين الاثنتين أن اللعبة تظل
لعبة في نهاية الأمر، لا توقع ضررا على صاحبها، بعكس الصحافة والكتابة التي
يبقى صاحبها طوال الوقت تحت المجهر، وقد يتلقى في الظلام ضربة مباغتة مجهولة
المصدر، أو صفعة من هنا وركلة من هناك، ليلتزم بالواقع المحتوم. مع هذا كثير من
الصحافيين والكتاب يتمسكون بمهنتهم على الرغم من أنها مهنة خطرة، وبالكاد توفر
لقمة العيش لصاحبها، الا إذا استثنينا فئة محدودة استطاعت تحقيق ثروة بالركض
بين دهاليز الصحافة. أكدت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين أن هناك أكثر من 25
صحافيا قتلوا عام 2000م أثناء تغطيتهم لأحداث الحروب والمجازر والانقلابات في
العالم، وفي حرب أفغانستان الأخيرة تم الإعلان عن مقتل 3 صحافيين بينهم امرأة .
قد يتساءل الكثيرون: لماذا يعرض الصحافي حياته للخطر؟! هل يعود ذلك الى رغبته
في كشف الحقيقة أمام الناس؟! هل تنبع من صفتي المجازفة والمخاطرة، اللتين
تعتبران من سمات الصحافي الحقيقي؟! هل هي السعي لتحقيق سبق صحافي، يمكنه من
تسلق سلم المجد؟! هل تختلف اهداف الصحافي الغربي عن نظيره العربي؟! هل الرأي
الذي نادى به يوما الكاتب أحمد بهاء الدين فيه جانب من الصواب، حين قال إن
السجن الذي له جدران، خير من السجن غير الواضح بلا جدران؟! هل كان يقصد
المعاناة التي يعانيها الصحافي والكاتب العربي ليوصل افكاره للناس، بعد ان تتم
محاكمته محاكمة هزلية، ويزج به في السجن ليصبح عبرة لغيره؟! في عالمنا العربي
يتربى الأفراد بطبيعة الحال داخل المجتمعات العربية على الازدواجية في التعامل،
وهي عادة عربية ورثناها عن أسلافنا منذ قديم الزمان، وظلت عالقة في جدران
عروبتنا، ويشبون على استخدام أسلوب التورية في احاديثهم، كونه من الأساليب
البلاغية الجميلة التي تحتوي عليها لغتنا، وقد استعان بها العديد من الصحافيين
والكتاب العرب للتعبير عما يدور في رؤوسهم، وحتى لا يقعوا في دائرة المساءلة!
وما زال الصحافي والكاتب العربي يمارس يوميا لعبة القفز لتفادي الألغام
الأرضية، والحواجز الشائكة، والزلازل المفاجئة، وملهيا في تعلم لغة الغمز
واللمز، حتى يظل قادرا على الاستمرار والتنفس في أجواء ملوثة! وإلا حلت عليه
اللعنة وسقط في سلسلة طويلة من الاستجوابات، التي قد تنتهي باتهامه بالخيانة
العظمى، واذا لم يرتدع فهناك ألف وسيلة ووسيلة لإعادته لصوابه. قرأت بالأمس
واقعة غريبة على مجتمعاتنا العربية، وهي قيام أحد الكتاب الصحافيين في البحرين،
برفع قضية على وزير الاعلام، لأنه أمر بإيقافه عن الكتابة، ومنعه من السفر.
ولست هنا بصدد التعليق على قرار وزير الاعلام البحريني، وانما نظرت الى الحادثة
على أنها بداية نشوء ظاهرة صحية جديدة في عالمنا العربي، من خلال فسح المجال
أمام هذه الفئة، في اللجوء للقضاء، والمطالبة بحقوقها، كما حدث مؤخرا في قضيتي
الأديبتين الكويتيتين ليلى العثمان، وعالية شعيب، واستعانتهما بالقضاء لتوضيح
موقفهما الأدبي. هل الصحافي والكاتب العربي، عمره الافتراضي قصير نتيجة
الضغوطات النفسية والمعيشية التي يتعرض لها مقارنة بالغربي؟! الكاتب محمد حسنين
هيكل يتحدث عن أحد اساطير الصحافة البريطانية «أندرو نايت» رئيس تحرير أشهر
المجلات الاقتصادية في أوروبا، الذي اعتزل العمل الصحافي، واشترى بيتاً تحيط به
مزرعة بالريف الانجليزي، ليقضي فيها ما تبقى من عمره مع زوجته الجديدة. يكرر
هيكل عبارة أحد الفلاسفة «.. السعادة مثل الكرة نجري إليها، فإذا وصلنا ركلناها
بأقدامنا الى البعيد، ثم عدنا نلهث وراءها حتى نلحقها ثم نركلها من جديد..»،
مبديا دهشته واستغرابه من قرار هذا الرجل، متسائلا في حيرة: هل من الممكن ان
نفارق اشياءنا الحميمة التي ربيناها في احضاننا الدافئة سنوات.. وسنوات؟! في
رأيي الحياة لا تمطر العطايا جملة واحدة، والأيام تعلم الإنسان دوما لعبة
المقايضة، وقد يكتشف صحافي أو كاتب ان الكتابة لم تكن حبه الحقيقي، وان كل
النجاحات والانجازات التي حققها كانت مجرد تحديات حياتية وأحلام شبابية، لكنها
لم تكن يوما دربه المنشود، وأن سعادته الحقيقية كانت تمرح طوال الوقت متخفية في
اعماقه، حتى يكتشفها فجأة في خريف العمر. مع هذا أؤمن ان عالم الكتابة، عالم
صاخب في حياة الصحافي والكاتب، بالرغم من طابع القلق الذي يلتصق بشخصية صاحبه،
هذا القلم الذي يميد بصاحبه نحو هوة الهلاك حينا، ويرفعه الى أوج المجد حينا
آخر، ومع هذا تظل الكتابة قدراً جميلاً ومخيفاً في نفس الوقت. في عالمنا العربي
قد يقذف الصحافي والكاتب بقلمه من أعلى قمة شاهقة، اذا شعر بأن تحقيق المجتمع
المثالي الذي يحلم به قد اضحى ضربا من المستحيل، أو يقرر التواري في الظلال
يجتر احزانه حتى يبتلعه النسيان. أو يختار لغة الصمت المطبق ليضمن السلامة
لحياته وأهله في عالمه العربي المضطرب، المهووس بلعبة الاستبداد، أو يتسرب
الملل فجأة الى أعماقه، ويقرر رفع راية الاستسلام بعد أن تعب قلمه من التناحر،
والصدامات المتكررة داخل أوطانه. في النهاية دنيا الصحافة والكتابة تدور في
محورين رئيسيين، لغة الغمز.. ولغة الحبس، وهما قدران احلاهما مر، وعلى الصحافي
والكاتب أن يقرر أي الدربين يسلك، وأي الهدفين يختار.. المتاجرة بمبادئه، أم
التضحية بالنفس من أجل ارسائها!
المثقف.. أصل وصورة!!
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

المثقف.. أصل وصورة
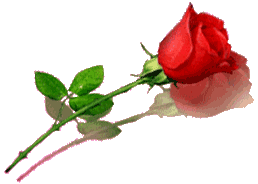 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
نجاح أي كاتب مرهون بقائمة بريده، وكلما زاد عدد قرائه، اعتبر دليلا
على مهارته في التلاحم مع قضايا أمته، والاحساس بهموم مجتمعه، لهذا لم أهمل
يوما رسالة قارئ رغم تأخري في الرد أحياناً لضيق وقتي. وتفاجئني بين فترة وأخرى
رسالة من قارئ كريم، معبأة بالهجوم على شخصي، واتهامي جورا بتجاهله، وانني
اترفع في الرد عليه. هذه النوعية من الرسائل توجعني، لأن القارئ له حق مباح عند
كاتبه المفضل. وهناك شريحة أخرى، من الصحافيين والكتاب والقراء المغاربة، تصلني
رسائلهم من حين لآخر عبر بريدي الإلكتروني، هذه الرسائل تسعدني كوني أؤمن
بأهمية التواصل الثقافي، والتبادل المعرفي بين أبناء عروبتي. وقد استرعت
انتباهي منذ فترة وجيزة، رسالة من أحد الصحافيين الشباب من دولة المغرب، معبرا
عن سخطه من بعض الكُتّاب، الذين يتشدقون بالمبادئ والقيم، وهم بعيدون في واقع
الأمر عن هموم الناس، وعن معاناة الشباب، رغم إعلانهم ليلا ونهارا عبر القنوات
الاعلامية المختلفة، بضرورة دعم المواهب الشابة، والأخذ بيدها، وتوجيهها
الاتجاه الصحيح، لتطرح ثمارها مستقبلاً.
لست هنا في موقع المدافع المستميت عن كافة الكُتّاب والأدباء
لإدراكي ان دهاليز الصحافة، ومنابر الأدب، تحوي الكثير من المتناقضات، وبين
جدرانها تقع العديد من القصص والحكايات التي تنفع تفاصيلها في كتابة مئات
الروايات، وفصول من المسرحيات، وأن هناك بالفعل زمرة من الادعياء، مرصوصين في
قوائم المثقفين، لكنهم في دواخلهم انتهازيون أفاقون، يمارسون أفعالا تناقض ما
يطرحونه على صفحات الجرائد، وما يسطرونه بين طيات الكتب، معترفة انني في
بداياتي الصحافية، اصطدمت بكُتَّاب من هذه النوعية، كانوا موضوعين في مرتبة
عالية في فكري، واكتشفت ان كل شيء في أعرافهم له ثمن وحسابات خاصة!! وأصبحوا
بعد مواقفهم المزدوجة في أدنى موقع عندي، مع هذا لم تتغير قناعاتي بأن هناك
نخلات باسقات تظل وارفة الظلال، مهما اكتوت من لظى الأيام! هناك حقيقة غائبة عن
الكثير من الناس، ان العديد من دول العالم الثالث، تضيق في أرجائها مساحة
الحريات، لذا يشعر المثقف النزيه أنه يحمل روحه على كفه كما يقولون، فهو مهدد
بقطع لسانه، وقصف قلمه مما يجعله يسير متلفتا جزعا، وإن استلقى على فراشه، ظلت
عيناه متسعتين عن آخرهما، هلعاً من أن يستيقظ فجرا على دقات عنيفة على بابه،
وزوار غلاظ يأخذونه من الدار إلى النار!
في الدول المتحضرة يتعرض الكتاب والأدباء الذين يتجاوزون الخطوط
الحمراء في بلادهم، الى المحاكمة والغرامة، خاصة أصحاب الكتابات التي تتعرض
سلبا لتاريخ اليهود، كما حصل مع المفكر الفرنسي روجيه جارودي، حين اتهم
بمعاداته للسامية، بعداً ان شكك في ضحايا المحرقة «الهولوكوست» ابان العصر
النازي، من خلال كتابه «الأساطير المؤسسة للصهيونية». الأمر يأخذ بعدا أشد عنفا
في بعض دول العالم الثالث، حيث يتم رمي أصحاب المواقف الثابتة من المثقفين في
غياهب السجون حتى يتراجعوا عن مواقفهم، وقد يتعرضون للتعذيب الذي يصل الى القتل
في بعض الأحيان، ويكون محظوظا من يستطيع الافلات بجلده الى أرض يتنفس فيها
بحرية، وينعم بالعدالة الاجتماعية التي يفقدها في بلاده.
هناك مئات من المثقفين العراقيين أضحوا اليوم يعيشون في المنافي
هربا من بطش السلطة في بلادهم، وحماية لأسرهم من الضياع والتشرد، ومات بعضهم في
أرض الغربة، وهم يحلمون بالعودة إلى وطنهم. ومنذ فترة قريبة بعد عدة عقود،
أعادت تركيا الاعتبار لشاعرها ناظم حكمت، الذي مات في منفاه بالاتحاد السوفيتي
سابقا، وقال في وصيته «ادفنوني تحت ظل شجرة صفصاف وارفة الظلال في إحدى مقابر
قرى الاناضول». من أمثال هؤلاء الشرفاء يوجد كثيرون قدموا أرواحهم فداء لمبادئ
آمنوا بها، ومن أجل حياة أفضل.
لكن على النقيض، هناك فئة أعطت ضميرها إجازة طويلة، وأراحت عقلها،
وتحولت إلى أبواق للسلطة، تهلل ليلا ونهارا على قراراتها، وتطبطب على نهجها،
حتى لو كانت تعسفية! هذا لا يعني ان كل من اقترب من السلطة لا بد ان يكون
متملقاً، والشرط الأساسي كما يرى الناقد رجاء النقاش للاقتراب من السلطة ان
يكون المثقف مخلصا شريفا صاحب أفكار وطنية وانسانية، يود تحقيقها في مجتمعه،
وقد قام بهذا الدور العديد من المثقفين العرب، أمثال الأديب عباس محمود العقاد،
الذي كانت تربطه صلة قوية بحكومة الوفد في مصر.
وهناك فئة لم تستطع مقاومة تيار الاغراءات المحيطة بها، وغرقت في
لجج مطالبها الحياتية، كون الكتابة في العالم العربي، لا يجني صاحبها ثروة من
ورائها، وبالتالي لا توفر لأهله حياة كريمة كذلك الكاتب والأديب الصادق يتطلع
دوما لمجتمع مثالي، يود لو يراه واقعا أمامه، لكنه قليل الحيلة، مقيد القدمين
واليدين، بجانب إدراكه ان ذاكرة قومه ضعيفة، سرعان ما تنسى تضحيات أبطالها!
ولو تتبعنا تاريخ الأدباء والكتاب العظام في العالم، سنجد أن
تصرفاتهم فيها شيء من الغرابة، وان العديد منهم فشل في اقامة جسور من الود
والتفاهم بين أقرب الناس اليه. فالمفكر الفرنسي جان جاك روسو، الذي شغل الدنيا
بنظرياته في العقد الاجتماعي، رفض الاعتراف بأبوته لأطفاله غير الشرعيين،
وتركهم يتربون في الملاجئ. والأديبة الذائعة الصيت جورج صاند، كانت امرأة تعيش
حياتها طولا وعرضا، ضاربة عرض الحائط بالتقاليد المحافظة التي كانت سائدة في
عصرها.
وفي عالمنا العربي هناك الكثير من الأمثلة لأدباء عاشوا حياة تناقض
ما خلفوه من نتاج أدبي، لكننا في عالمنا العربي نسدل الستار على حيوات
المشهورين، لأن قانون التستر على العيوب، يظل المعيار المهيمن داخل المجتمعات،
حتى لو كان فيه استخفاف بحقوق الأفراد، مما يلقي ظلالا هلامية على شخصياتها
البارزة.
مع هذا هناك أسماء حفظ لنا التاريخ سيرهم البائسة، من العصر
الجاهلي، ومن العصور الاسلامية التي تعاقبت على مدار التاريخ الى العصر الحديث.
هذه العواصف الهوجاء التي يمر بها الكُتَّاب والأدباء من الجنسين تجعلهم يقفون
في مفترق طرق، منهم من تنزلق قدماه وينحدر الى الهاوية، وينغمس في أوحال
الرذيلة أيا كان نوعها، كونه يملك إرادة هشة، وشخصية مهزوزة لا تحتمل
المزايدات، ومنهم من يملك إرادة صلبة وشخصية قوية يقاوم بها أعاصير الحياة،
ويظل صامدا حتى يصل إلى مراده، متسلحا بثقافته المتينة الجذور.
إن الأقلام البارزة على الساحة الثقافية، أصحابها ليسوا ملائكة تمشي
على الأرض، وإنما هم بشر يخطئون ويصيبون، والكلمة الفصل في النهاية تعود للقارئ
الواعي الذي يدرك ابعاد الاشياء، ويستشف الحقيقة الغائبة من بين السطور
المعلنة.
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

حكايتي مع الحرف
محاضرة الكاتبة والأديبة السعودية زينب حفـني
ملتقى المرأة والكتابة
المغرب/ آسفي
15-16-17 يوليو 2004م
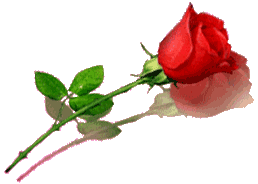 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
كانت جدتي لأبي أول مخلوق فتح أمامي آفاق الخيال القصصي، كانت تمتاز
بشخصية صارمة، وذات شكيمة قوية، لكنها على الجانب الآخر كانت تتمتع بحس فكاهي،
وميل كبير للدعابة، تعودت أنا وإخوتي بعد صلاة العصر في عطلتنا الأسبوعية،
الذهاب إلى ملحقها الذي بناه لها أبي في ركن من البيت، فكانت تجلسنا حولها في
دائرة بالشرفة الأرضية التي تطل على الحديقة، وتقص علينا حكايات الشاطر حسن،
وعلي بابا والأربعين حرامي، وقصة "أمنا الغول" وتقوم بتجسيد المشهد بإخراج طاقم
أسنانها في وجوهنا وتُـضخّـم صوتها فنصرخ هلعاً ونتشبث ببعضنا البعض، لكن ما أن
يزول تأثير الخوف منا حتّـى ننفجر في الضحك ونتوسل إليها أن تَـسرد علينا
المزيد من الحكايات.
كانت جدتي تهوى سماع الأغاني القديمة وتحتفظ بجهاز "بيك أب" قديم من
النوع الذي تدار فيه الأسطوانات الكبيرة، فكنت ألِّـحُ عليها أن تسمح لي بتشغيل
الجهاز لأستمع لأغاني فريد الأطرش وصباح وعبد الحليم حافظ وغيرهم، ومن الأشياء
التي ندمت عليها عدم احتفاظي بهذا الجهاز الأثري الذي لا أدري أين آل مصيره بعد
موت جدتي. كما كانت تحتفظ بصندوق خشبي كبير، يحتوي على ثيابها التي كانت
ترتديها في الأعياد والمناسبات العائلية والأعراس، حيث كان للسيدات المسنات في
مجتمع المنطقة الغربية بالحجاز زي خاص يتميزّن به، مثل "الصديرية" التي تلبس
بالجذع العلوي وهي محاكة من قماش الكتان الأبيض وتُقفل من الأمام بمجموعة من
الأزارير الذهبية، أما الجذع السفلي فيغطى بقماش قطني سميك مزركش الألوان، يلف
حول الجسد بالإضافة إلى وشاح من القماش الشفاف لتغطية شعر الرأس يسمى "المحرمة"
يُمسك بمشابك جميلة مُثبت في أعلاها حبات من اللؤلؤ الأبيض، كانت السيدات
العجائز يستخدمونها لتثبيت الوشاح حتّـى لا ينسدل عن رؤوسهن.
في أول أيام العيد كانت جدتي تحرص على ارتداء هذا الزي وتستقبل به
أبناءها وأقاربها الذين يحرصون على زيارتها لتهنئتها بقدوم العيد.كنتُ أنظر
إليها بإعجاب وانبهار بطلعتها، كانت على الرغم من عمرها الذي تجاوز الستين إلا
أنها كانت تمشي بقامة مرفوعة وخطوات ثابتة في تحدٍ عنيد لشيخوختها، وهـو ما كان
يدفعني إلى مغافلتها أحيانا والتسلل لغرفتها وهي نائمة والعبث في حاجاتها، كان
الفضول يتملكني إلى تقليدها فألبس واحدة من هذه "الصديريات" وأقف أمام المرآة،
وأرفع أطراف أصابع قدمي، وأمدُّ قفص صدري إلى الأمام في محاولة لتقليد خطواتها
وتصبح هيئتي لحظتها مثل مهرجي السيرك في هذه الثياب الفضفاضة التي لا تتوافق مع
بنيتي الضئيلة.كان حظي العاثر يوقعني أحيانا معها فتستيقظ من نومها وتضبطني
بالجرم المشهود وتقوم بتوبيخي على فعلتي متوعدةً إيايَّ بأنها ستحرمني من سماع
قصصها، وكان هذا بالنسبة لي يُـشكِّـل عقاباً قاسياً، فأستسمحها وأعدها بأنني
لن أعود لهذا الفعل مرةً ثانيةً ثم أقومُ بطبع قبلة على يديها وقبلة على
جبينها، فتضحك وتنظر في وجهي بحنان، لكن ما أن تمر أيام على هذه الواقعة حتّـى
أنسى وعدي لها وأكرر فعلتي.
عندما ماتت جدتي بكيت كثيرا عليها، على الرغم من أنها كفت عن سرد
الحكايات بعد أن جرفتها دوامة أمراض الشيخوخة، لكنها ظلت تعني لي الكثير، كانت
معلمتي الأولى في تعليمي فن القصص وقد أخذت عن جدتي قوة المراس، والقدرة على
المواجهة، وتحدي الصعاب. فقدت جدتي زوجها وهي ما زالت شابة صغيرة، ترك لها ستة
أبناء صغار، في بلد كان أهلها يحيون حياة قاسية بعيدة كل البعد عن حياة الترف،
ويعانون من شظف العيش قبل اكتشاف النفط، لكن بجلادتها استطاعت أن تدير دفة
بيتها وترعى أبناءها، قسّمت بينهم الأعمال، كانوا بعد عودتهم من المدرسة يقوم
أحدهم بجلب الماء من "الكنداسة" المصدر الوحيد للشرب حيث كان السقا يحضر للبيت
مرتين في الأسبوع وكان الماء الذي يحمله مخصص فقط لتنظيف البيت، وآخر يشتري
لوازم البيت أما الأبناء الكبار فكانوا يعملون في متجر عمهم لكي يوفروا دخلا
مادياً للأسرة.
كان أبي يأخذنا في ليالي رمضان من كل عام إلى السوق ليشتري لنا
ملابس العيد حيث تظل الأسواق مفتوحةً إلى ساعاتٍ متأخرةٍ، كان يشير بيده ونحن
نمر بالسيارة عبر أحياء جدة القديمة التي تغيّرت الكثير من مبانيها الشعبية،
قائلا بنبرة حزينة.. هنا الحي الذي ولدت وتربيت فيه وقضيت به شطرا من شبابي.
متابعا.. رحم الله تلك الأيام الجميلة على الرغم من ضنكها.
حكى لي أبي بأن جدتي لم تنتقل إلى العيش في بيتنا إلا بعد محاولات
مستميتة من أبي وأعمامي، شخصيتها الأبيّة جعلتها تتشبث بحقها في البقاء ببيتها،
حتّـى رضخت في النهاية لمطلبهم بعد أن أقنعوها بأنه سيكون لها جناح مستقل.
هذه الحياة الصعبة التي عاشتها جدتي الأميَّـة مع أبنائها والتي حكى
لي أبي جوانباً منها، علمتني أن الحياة بقدر ما تأخذ من الإنسان بقدر ما تزيده
صلابة إذا استطاع التكيّـف مع ظروفه، وأطلعتني على جانب خفي من حياة المرأة
السعودية، في أنها قادرة على التأقلم مع وضعها ومواجهة واقعها ببسالة إذا
استلزمت الظروف منها ذلك، وأن ما يتردد اليوم بوجوب محاصرة المرأة وتقييد
حركتها وتدجين شخصيتها ما هي إلا محاولات جائرة للتقليل من قدراتها الحقيقية.
= = = = = = =
عامل أساسي آخر ساهم في تخصيب خيالي وهو مسقط رأس أمي حيث تعود
أصولها إلى قرية بالريف المصري. كنتُ أعد الأيام والأسابيع لأسافر إلى القاهرة،
وهناك كانت أمي تصحبني أنا وأخوتي لزيارة أقاربها ببلدتها الصغيرة، فكنتُ أهرع
إلى الحقول وأختار شجرة ضخمة بظلال وارفة وأسند ظهري الصغير عليها وأمد ساقي
لأستمتع برؤية الفلاحين البسطاء وهم يفلحون أرضهم، وأمتع ناظري بمجرى نهر
النيل، وألاحق بعيني الفلاحات وهن يرفعن أطراف جلابيبهن ليقمن بغسل ملابسهن
وأشيائهن عند حافة النهر. وفي المساء كنا نتسامر أنا وإخوتي مع أقاربنا بالجلوس
في حلقة كبيرة عند شاطئ النهر إلى ساعات متأخرة، وأستمع لأحاديثهم المشوقة عن
حكايات الأشباح التي تطوف بالقرية في الليالي الحالكة الظلمة، كان ضوء القمر
يعكس ظلاله على الوجوه مما يعطي للأحاديث الدائرة متعة خاصة، لا يخترقها إلا
صوت نقيق الضفادع الصادر من بركة الماء الراكدة، القائمة عند أطراف القرية. هذه
المشاهد ساهمت في تخصيب فكري، وفي إمدادي مستقبلا بمادة ثرية للكتابة، وفتحت
أمام عيني مجالا رحبا للتأمل، ولرؤية جوانب مضيئة للإنسان الكادح في الحياة،
الذي يُـطلقُ لصوته العنان بالغناء وهو يفلح أرضه، ثم يعود عند الغروب إلى
أسرته، تعلمتُ من هذه الصور العفوية أن في الدنيا مقومات عديدة للسعادة.
منذ سنوات لم أعد أذهب إلى بلدة أمي فقد سمعت بأن الكهرباء قد
دخلتها وأن الكثير من المباني الطينية قد تحولت إلى مبانٍ أسمنتية، وهو ما جعل
نفسي تعافها فقد فقدت من وجهة نظري أبرز ملامح جمالها بعد أن خلعت ثوبها الريفي
ولبست ملابس عصرية ولطّـخت وجهها بالمساحيق الفاقعة الألوان!!
عندما دلفت لعالم الأنوثة هرعت فرحة إلى أمي أخبرها بأن العادة
الشهرية قد صارت تأتيني مثلها، أخذتني في حضنها وقبلتني، كان هذا يعني بأنني
سأضع المساحيق على وجهي، وألبس حذاء بكعب عالٍ، نمتُ ليلتها وأنا أحلم بولوج
هذا العالم الجديد. فوجئت بها في اليوم التالي تُـقدّم لي عباءةً سوداء وتطلب
مني أن أرتديها عند خروجي من المنزل، سألتها.. لماذا؟! ما السبب؟! قالت.. لقد
أصبحت عروسا. عدت إلى سؤالها.. أين العريس يا أمي؟! ابتسمت معلقة.. بالتأكيد
سيأتي يوما. أخذت العباءة وحشرتها في دولابي وداهمتني لحظتها فكرة مجنونة قمتُ
بتنفيذها فورا، بالخروج من البيت بدونـها، همست الخادمة في أذن أمي بفعلتي،
ألفيتها تهرع نحوي، صارخة في وجهي، مهددة بأنها ستخبر أبي بما اقترفته من
جُـرم، وتابعت قائلة بنبرةٍ غاضبةٍ.. هل تريدين أن تلوكَ سمعتنا الألسن؟! دخلت
إلى غرفتي وسألت نفسي.. ماذا يمكن أن يتقوّل الناس علـي إذا لم ألبس العباءة؟!
هل سيمتنع العريس عن خطبتي؟! هل.. وهل.. وهل؟! مع مرور الوقت أدركت بأن الكثير
من موروثاتنا الاجتماعية لا تمت لشريعتنا الإسلامية بصلة، لكنها أصبحت من
المسلمات مع تعاقب الأزمنة، وأن من الصعب على أي فرد في مجتمعنا أن يخرج من
قوقعة الأعراف دون أن تُـلقى عليه الحجارة ويُـنعت بأبشع التهم.
يُـقال بأن الإنسان كلما ابتعد عن منطقة طفولته كلما التحم بأحداثها
أكثر، وبدأت مشاهدها تلاحقه في ساعات نهاره وليله، لقد شكّلت هذه الحادثة أول
بوادر الثورة في أعماقي على الكثير من العادات التي تشربتها في طفولتي، وهو ما
دفعني إلى مواجهتها في مرحلة نضجي عندما أصبح لي حيز في عالم الكتابة، حيث بدأت
الكثير من علامات الاستفهام تتحول إلى أحرف نارية تتفجّـر على الورق.
= = = = = =
الحديث عن المرأة في بلادي كان في الماضي منطقة محرمة محظور على أي
أحد الاقتراب منها، وهذا يعود إلى اعتقاد الكثيرين بأن فتح باب النقاش حول شئون
المرأة سيؤدي إلى انفراط سبحة الأخلاق، وإلى حدوث زلزال في أرضية المجتمع
السعودي، مما جعل اقتحام هذه الرقعة هو التهور بعينه، لكن في ظل التغيرات
الحاصلة في العالم اليوم، ظهر مؤخرا انفراج في أوضاع المرأة السعودية، فقد تمَّ
إنشاء إدارة عامة للحماية الاجتماعية تُـعنى بقضايا النساء والأطفال الذين
يتعرضون للإيذاء البدني والنفسي والجسدي ودراسة مشاكلهم وعرضها على المحاكم
الشرعية إذا لزم الأمر، كما أن سيدات الأعمال اللاتي عانين طويلا من مشكلة
الكفيل أو الوكيل الشرعي والتي كانت تحد من حركتهن قد ألغيت، كما تمَّ فتح
مجالات عمل جديدة للمرأة وإن كانت ما تزال في حدود ضيقة.
أنا سعيدة بهذه التغيرات حتّـى وإن كانت طفيفة فأول الغيث قطرة كما
يُـقال، لكن يجب الاعتراف أيضا بأن الطريق أمام المرأة السعودية ما زال طويلا،
فالمجتمع يُـصرُّ على معاملة المرأة كمخلوق ناقص الأهلية يجب فرض الوصاية
عليه؟! فالمرأة ممنوع أن تسافر خارج الوطن إلا بإذن من ولي أمرها، واختيار طريق
مستقبلها التعليمي من المدرسة إلى الجامعة مرهون بموافقة ولي أمرها، والبطاقة
الشخصية وجواز السفر لا يحق لها أن تستخرجهما إلا بخطاب من ولي الأمر، وهناك
الكثير من الوظائف ما زالت مقتصرة على الرجل دون المرأة بحجة الخوف من أن يؤدي
هذا التسامح الفكري إلى تفسّخ اجتماعي!! بجانب أنها محرومة من قيادة السيارة في
الوقت التي يسمح لها بالركوب مع سائق غريب عنها بمفردها، كما أن الإعلام
بقنواته المتباينة يُـديره الرجل، فإذا نظرنا إلى الصحافة المكتوبة سنجد بأن
الصحافية السعودية بعيدة عن موقع القرار، فلم تتبوأ صحافية رئاسة تحرير أي
صحيفة محلية بالرغم من نجاح عدد منهن في الخارج، أما دور مديرات التحرير الذي
حصلت عليه بعضهن فهو منصب صوري لا تملك صاحبته الصلاحية في تغيير موقع إعلان
بالصحيفة التي تعمل بها!! فإذا انتقلنا إلى الإعلام المسموع والمرئي، نجد أن
المذيعات مقيدات ببرامج معينة ويتم التعاقد معهن بأجورٍ زهيدةٍ، وليس ضمن
الكادر الوظيفي أسوة بالرجال، مما يؤكد بأن مجتمعنا السعودي، مجتمعاً ذكورياً
خالصاً. هذه الوقائع أدت إلى تقييد حركة المرأة واضطرارها إلى الوقوف في آخر
الصفوف حتّـى يمـنَّ الرجل عليها ويفتح أمامها السبل المغلقة، وكم يكون حظ
المرأة عاثراً لو وقعت في يد ولي أمرٍ قاسٍ لا يرحمها مستغلا الصلاحيات
الممنوحة له ليلعب بمصيرها حسب أهوائه، هادماً قصورَ أحلامها من منطلق أنه
الوصي عليها والساهر على راحتها، وهو ما يقودها في نهاية المطاف إلى رفع رايةِ
الاستسلام والانصياع الكلي.
= = = = = = =
عندما دخلتُ معترك الأدب، سخّرت قلمي لإلقاء الضوء على السلبيات
التي تعيق حركة المرأة في بلادي، وناديت من خلال كتاباتي بفك القيود الموضوعة
عليها، ودافعت عن حقوقها المسلوبة، لإيماني بأن قضية المرأة لا تنفصل عراها عن
قضايا المجتمع الكبرى إن لم تكن أهمها، فقد منحني البيت الذي نشأت فيه
الاستقلالية في الرأي، وعلمني معنى الحرية المسؤولة، وهو ما جعلني أعلن رفضي
بقاء المرأة نصفا مشلولا داخل مجتمعي. هذا المسلك الذي انتهجته منذ البداية جعل
دربي محفوفا بالمخاطر والمنزلقات والفواجع النفسية، لكن على الجانب الآخر قـوّى
من عزيمتي وزادني صلابة.
أتذكّـر واقعة قرأتها عن الشاعر نزار قباني، أنه عندما كتب "دفاتر
النكسة" قامت حملة مسعورة عليه ومُنعت كتبه من دخول مصر، كتب عندها رسالة إلى
الرئيس جمال عبد الناصر يقول له فيها".. لم يكن بوسعي أن أقف أمام جسد أمتي
المريض أعالجه بالأدعية والأحجبة، فالذي يحب أمته يُـطهّـر جراحها ويكوي إذا
لزم الأمر المناطق المصابة بالنار..".
= = = = = = =
قلت لابنتي.. يوما ما ستتزوجين وستأتيك ابنتك من المدرسة فرحة وهي
تلوّح بكتاب الأدب قائلة لك بنبرة فرحة.. اليوم درسنا نصا لجدتي. نعم إلى اليوم
لا يُـدرَّس أدب المرأة السعودية في المدارس ولا الجامعات، مع أن حضارة كل أمة
تبدأ بتدوين نتاج فكر أدبائها ومفكريها رجالا ونساء، لتكون مرجعا للأجيال
القادمة.
نعم.. لقد عرضتني أفكاري للكثير من المشاكل، وهاجمتني شرائح متباينة
من مجتمعي، ودفعتُ يوما ثمن جرأتي في هذا العالم الذي اخترته بكامل إرادتي،
لكنني لم ولن أندم يوما على اختياراتي. بكيت !! نعم.. ألقيت بأوراقي وأقلامي في
سلة المهملات!! نعم. قررت الانزواء بعيدا!! نعم. لكن دوما كان هناك صوت بداخلي
يحثني أن أعاود الوقوف وأصمد لأقاوم كل المعاول التي تريد هدم كياني الذي أسسته
على مدى سنواتٍ، وأنا واثقة بأن القضية ستحسم لصالح المرأة في المستقبل، وأن
التغيير قادم لا محالة، فمن المستحيل أن تتوقف عجلة الزمن، لكن ما يحزنني
أحيانا بأنني لن أرى هذا اليوم لكنني أعود فأهدأ لأن الأجيال القادمة ستقطف
ثمار هذه المحاولات التي تشع مني ومن غيري من الكاتبات اللواتي دخلن ساحات
الوغى بشجاعة وبإيمان راسخ بمطالبهن. لذا لم يعد يهمني أن أكون ضحيةً، فلم أكن
أول الضحايا، ولن أكون آخرهن، يكفيني أن تتبنى فكري أجيالُ الغدِ بدلاً من أن
تُـلقى كلماتي للجرذان أو القطط الشاردة. أريد أن أدخل التاريخ بملابس ناصعة
وأن يُـشار إلى قبري ويُـقال.. هنا ترقد امرأة ساهمت يوما في دفع مجتمعها نحو
حياةٍ أفضل.. إمرأة رفضت أن تعيشَ في الظلال، وقررت أن تمشي تحت وهج الشمس،
فأحيانا الحرارة العالية تحمي الإنسان من الصقيع الرابض في أعماقه.
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

أحلامي.. سر حياتي
ورقة الكاتبة والأديبة السعودية زينب أحمد حفـني
ملتقى المرأة والكتابة
المغرب/ آسفي
20-21-22 يوليو 2006م
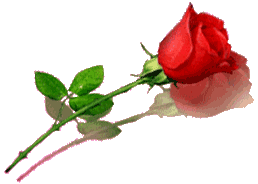 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
كل إنسان منا رجلا كان أم امرأة يحمل بذور دماره، وبذور بقاءه في
أحشائه، وفي كلتا الحالتين المرء وحده القادر على تطويع أدوات تمرده لتنعكس
إيجابيّا على حياته، حيثُ أنها تُمثل جزءا لا يتجزأ من طبائع البشر، يولدونا
بها، وتظل ترافق أصحابها إلى أن تتوقف نبضات قلوبهم، ويحملونها معهم إلى مثواهم
الأخير.
أتذكّر عبارة لباولو كويليو، الروائي البرازيلي الشهير "بأن العالم
على نوعين.. العالم الذي نحلم به، والعالم الحقيقي". وهنا أجد نفسي أخالفه
رأيه، لإيماني العميق بأن أحلامنا التي تنام وتستيقظ معنا داخل وجداننا، لا
تنفصل عن محيط العالم الذي نعيش فيه، حيثُ تظل هذه الأحلام تحثنا ليلا ونهارا
لإخراجها على أرض الواقع، ولولا هذا الإلحاح الذي يتحرّك في دواخلنا، وفورة
الثورة التي تندلع في أذهاننا، وتطفو على سطح تفكيرنا بين هنيهة وأخرى، لما نجح
علماء الطبيعة والفلاسفة والمفكرون والمبدعون في تغيير العالم من حولهم، وفي
تحويل أحلامهم إلى حقائق على الأرض.
أحلامي، جزء لا ينفصل عن قناعاتي، هي التي حثتني على أن أحارب
بضراوة على مدار عمري، كي أرى مردوداتها بأم عينيَّ تمشي متبخترة على الطريق.
هذه الأحلام حملتها أجنة في أحشائي، منها ما نجحت في ولادتها ولادة طبيعية،
وأصبحت حرة طليقة. ومنها ما اضطررت إلى إنجابها بعملية قيصرية بعد أن حملت بها
سنوات طويلة حتّى تعب جسدي من ثقل وزنها. ومنها من توفيت في المهد دون أن أفلح
في إنقاذها، بعد أن أعيتني الحيلة في إيجاد تربة خصبة لها لكي تنمو وتترعرع.
لقد بنيتُ حلمي في أن أكون كاتبة منذ أن أدركتُ معنى الحرف، وقيمة
القلم، ولولاه لما استطعتُ رفع صوتي احتجاجا على ما يجري من سلبيات حولي، وبخس
لحقوق المرأة في بلادي. إن عالم الكتابة بالنسبة لي قارب النجاة الذي أتطلع أن
يُوصلني إلى شاطيء الأمان، مثلي كمثل الغريق الذي يتعلق بالقشة على أمل أن ينجو
بحياته من المصير المحتوم الذي ينتظره.
عالم الكتابة كان وما زال قدرا حتميّا، وسأظل إلى آخر يوم في عمري
مدينة لأبي، الذي لعب دورا كبيرا في رعاية هذا الحب، من خلال تشجيعي على
القراءة، وعدم حظر أي كتاب عني مهما كانت مساحة جرأته كبيرة. كبرتُ وأنا لا
أؤمن بالحدود، ولا أعترف بالحواجز، ولا آبه بالمحاذير، بالرغم من أنني نشأت في
مجتمع شديد الصرامة، يُطبّق ازدواجية المعايير في كل أمور حياته!!. تعلمت وقتها
أن أعطي الحرية لعقلي، بالنبش في مضامين تلك الإبداعات، التي تركها الأدباء،
الذين أثروا العالم بنصوصهم الجميلة، وأدبهم الرائع، والذي كان الباب الرحب
الذي فتح عينيَّ على تجارب الإنسانية.
هل الكتابة قدر؟! أم أنها كالمارد المحشور في أنبوب زجاجي، ينتظر
شباك صيّاد عابر، لكي يستخرجه من قاع البحار وينزع غطاءه لينطلق منه المارد في
الفضاء بصوته المجلجل، كما تروي لنا قصص ألف ليلة وليلة؟! هذه التساؤلات تطرح
نفسها في ذهني، كلما تعرضت لهجوم شرس من ذوي العقول المتحجرة في مجتمعي حول
مضامين ما أكتب.
==========
لماذا فضّلتُ عالم الرواية والقصة؟! يُلقى عليَّ هذا السؤال كثيرا
في الكثير من الحوارات التي تُجرى معي. من وجهة نظري، يظل هذا العالم المنبر
الأقدر على كشف المستور، وفضح الحقائق الملتوية، ولأن المرأة المبدعة من خلال
هذا الجنس الأدبي، تستطيع تعرية شخوص رواياتها، وتركها تتصرف على سجيتها،
وتُعلن عن رغباتها، وتتنفس بحرية، مبيّنة مستواها الفكري، فاضحة مرتبتها
الاجتماعية، وهو ما يجعلني أميل للمقولة الرائجة بأن الكتابة عملية لا أخلاقية.
إن شهرزاد صاحبة الفضل الأول على النساء، في تعليم المرأة فن الحكي
لسلب عقل الرجل، حيثُ تتباهى بأنها نجت من سيف الجّلاد لمهارتها في سرد القصص،
وفي جذب شهريار إلى عوالم مدهشة، حتّى نجحت في النهاية في ثنيه عن قتلها، ووقف
هوس الرغبة في أعماقه لقتل كل أنثى، وهو ما سطرته الباحثة فاطمة المرنيسي في
كتابها الرائع "نساء على أجنحة الحلم".
=============
أُتهم دوما بأنني أصوّر الرجل في عوالم رواياتي، بأنه الظالم
المتجنّي على المرأة، ولكن الحقيقة الراسخة في وجداني، هي أنني لم أقف يوما في
مواجهة الرجل، ولا أفكر بتلويح سيفي في وجهه، فالرجل يُمثل همزة وصل حقيقية في
حياتي، وإنما أقف ضد الكثير من موروثاتنا الاجتماعية، التي هي في الأصل نتاج
عقول ذكوريّة متخلفة، طمست إنجازات المرأة، وساهمت في منح الرجل الكثير من
الصلاحيات، وحصرت نظرته الضيقة في المرأة، بأنها مجرد صندوق أثري، من حقه أن
يُلقي بداخله كل أشياءه القديمة بلا مبالاة، كونها من وجهة نظره تُمثل جزءا من
إرثه التاريخي!!
==============
المثير للسخرية أن خطابنا الثقافي تجاه المرأة لم يتغيّر منذ عصر
النهضة إلى اليوم، مما يرسم علامات استفهام متعددة.. هل هذا عائد إلى انصراف
الكاتبة العربية عن الترويج لقضايا بنات جنسها؟! أم لتسرّب اليأس لقلبها،
وإحساسها بفقدان الأمل في التغيير؟! هل لكونها اكتشفت أن المرأة مهما بلغت درجة
ثقافتها، أشد عداوة من الرجل في التعامل مع بنات جنسها من جهة، وانعدام جسر
الثقة بين بعضهن البعض من جهة أخرى، مما جعل الرجل يستغل هذه النقطة لزيادة
مساحة صلاحياته؟! وللتأكيد على صحة كلامي، أختتم بعبارة الأديبة مي زيادة التي
سبقت زمانها، والتي ما زالت سطورها يرن صداها في أذن كل امرأة مبدعة، تحلم بأن
تتحقق مطالبها ذات يوم على أرض الواقع ( يجب أن يُباشر بتحرير المرأة لئلا يكون
المتغذون بلبنها عبيدا، وهل تُربي العبدة إلا عبيدا؟!.. الرجل هو الأب والأخ
والصديق والزوج، فإذا سقط سقطنا معه، وإذا أرتفع كنّا له بارتفاعه عظيما، لذلك
نُريد له خيرا بشرط أن ينصب عرشنا بقرب عرشه). تُرى لو كانت مي زيادة بيننا
اليوم، هل سترى عروشنا قد ارتفعت، أم أننا ما زلنا نحيا في دائرة الحلم
المستحيل؟!
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   

أتيتُ هنا لأعتذر!!
ورقة الكاتبة والأديبة السعودية
زينب أحمد حفني
بمناسبة اليوبيل الفضي للإتحاد النسائي الأردني العام
حول "المشاركة النسائية في البرلمانات العربية"
الأردن/عمّان
11-12/9/2006م
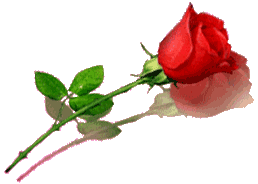 بقلم الكاتبة:
زينب حفني
بقلم الكاتبة:
زينب حفني
أعتذر، لأني قادمة إليكم من بلادي خاوية اليدين. أعتذر، لأني أتيتُ
إليكم بنبرات مجروحة. أعتذر، لأني حاضرة بينكم وأنا أحمل تحت ذراعي الأيمن حاضر
منقوص بحاجة لمراجعة مستفيضة، وتحت ذراعي الأيسر تاريخ قديم ومشرّف لإنجازات
المرأة على أرض الجزيرة العربية. أعتذر، لأني أدسُّ في كفي اليمين صفرا، وفي
كفي اليسار أيضا صفرا. أقول بصوت غاضب ممزوج بالحسرة واللوعة.. لا توجد لدينا
وزيرة، أو نائبة، أو سفيرة، بالرغم من أن المرأة السعودية اليوم، بتعليمها
وعلمها وثقافتها، أثبتت أنها قادرة على الوقوف بجانب الرجل، بل وان تكون ندّا
له إن لزم الأمر لما فيه خير مجتمعها.
لكن يجب أن نكون منصفين وعادلين، ونقر بأن هناك جوانب سلبية عديدة
تُعاني منها المجتمعات الخليجية الأخرى. فالنساء اللائي تبوأن مناصب عليا
يُعددن على الأصابع، وأقول على استحياء بأنه لم تنجح للأسف ولا مرشحة ممن
تقدّمن بفضل أصوات الناخبين من مختلف شرائح المجتمع، بل جميعهن تم تعينهن من
قبل حكوماتهن. هذا يعني بان المرأة لا تلقى أصواتا كافية تدعمها، لتصل إلى
البرلمان بمختلف تسمياته، ويؤكد على أن المرأة لا تثق في المرأة ولا تمنحها
صوتها، كونها في داخلها وبحكم موروثاتها الاجتماعية، وتربيتها التي نشأت عليها،
ترى بأن الرجل هو الأقدر على حمايتها وتلبية مطالبها. والأمثلة المتوفرة كثيرة،
ففي الكويت، لم تنجح في الانتخابات الأخيرة ولا واحدة من المرشحات، اللواتي
تقدّمن لعضوية مجلس الأمة. وفي السعودية، نجحت سيدتين فقط ممن تقدمن للانتخاب
في مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة، ويعود الفضل لنجاح إحداهما إلى أصوات
الرجال التي بلغت 650 صوتا مقابل 50 فقط من أصوات النساء.
إنه من العار أن تقف النساء في مواجهة بعضهن البعض، بدلا من أن
يتكاتفن لكي ينتزعن حقوقهن، كون الضرب بيد واحدة لا يُحدثُ دويّا مهما كانت
سماكة باطن الكف!! لكنني لا أريد تحميل المرأة الذنب الأكبر، فعدم وجود وعي
اجتماعي، سحب الثقة من تحت أقدام المرأة، وجعلها في نظر المجتمع بنسائه ورجاله
ناقصة عقل ودين، مما يعني أنها غير مؤهلة لأن تكون في موقع المسئولية. وزاد
الطين بلة خروج بعض أئمة المساجد، والتنديد من على المنابر، برفض مشاركة المرأة
في انتخابات الغرف التجارية في السعودية، متسائلة في قرارة نفسي كيف سيكون
الحال لو تعلّق الأمر بفتح باب العضوية لها في مجلس الشورى!! كذلك لا يبعد عن
ذهننا ما قام به النائب الطبطبائي في الكويت، حين حرّم حق المرأة في التصويت
بدون إذن زوجها، ثم تراجع عن فتواه عندما هوجم من قبل الطبقة المثقفة.
يجب أيضا أن لا نغفل دور وسائل الإعلام، التي تتحمل جزءا كبيرا من
المسئولية، بالاستمرار في مسلسل استغلال جسد المرأة في البرامج الترفيهية، وفي
استخدامها كسلعة في الدعايات التجارية، والتعاطي مع قضاياها بطرق سطحية، من
خلال مسلسلات تصورها إما بالمرأة الشريرة، أو الزوجة المغلوبة على أمرها،
المستسلمة لظروفها. إضافة إلى إطلاق عدد من رجال الدين عبر البرامج الدينية،
فتاوى شرعية تدعو المرأة إلى احتساب الأجر عند ربها عند وقوع ظلم عليها، مما
رسّخ مفهوم الرضوخ للأمر الواقع في أعماق المرأة، وأوجد خلطا خاطئا حول مفهوم
الدين، تجاه العلاقة السوية بين الرجل والمرأة من ناحية، وبين حقها الطبيعي في
التمسّك بحقوقها المشروعة من ناحية أخرى.
هذا كله يؤكد على وجود ردة فكرية تجاه المرأة حين يتعلق الأمر
بدورها في المشاركة بالحياة العامة في بلادها. فالمرأة كانت وما زالت حاضنة
الأجيال، في حجرها تربى الزعماء والقادة والحكام، الذين صنعوا التاريخ،
والتنكّر لصنيعتها، وإغفال أدوارها، وسحب الثقة من تحت قدميها، سيؤدي إلى
انعكاسات خطيرة داخل المجتمع على المدى البعيد.
يقول الشيخ أحمد زكي يماني ".. قضية المرأة في مجتمعاتنا العربية
والإسلامية، من القضايا التي يحتدم حولها النقاش.. بين متزمتين متشددين يبالغون
في الاستهانة بأمر المرأة لدرجة تحقيرها، والإساءة إلى إنسانيتها، معتمدين على
أحاديث نبوية ضعيفة، أو تفسير ممجوج لآيات الكتاب وصحيح السنة، محاولة منهم بان
يضعوا على تقاليدهم القبلية غلافا دينيّا إسلاميّا..".
لقد أتيتُ هنا متعمدة لكي أصرخ وأصرخ وأصرخ، لكي يسمع الجميع صوتي،
ويدركون بأن دوّامة الترف الاجتماعي، وآبار النفط التي نشأنا على خيراتها،
وصرامة موروثاتنا وأعرافنا، التي تصر على وضع المرأة طوال الوقت تحت الإقامة
الجبرية، لم تلهنا عن المطالبة بحقوقنا، ولم تجعلنا نقف صاغرين خانعين. أتيت
هنا لكي أؤكد على وجوب تمكين المرأة السعودية من المشاركة في الحياة السياسية،
والتأكيد على أن هذه المشاركة ستكون بوابة المرور لدعم مطالبها، في عمل إصلاحات
قانونية تقوم على التشريع، يُصحح وضعها، ويُبرز قدراتها داخل وطنها، ويُتيح لها
المجال للانخراط في كافة المجالات التي ما زال معظمها حكرا على الرجل، بما
يتلائم مع طبيعة الحياة العصرية.
إنني أضمُّ صوتي إلى صوت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة
للسكان، الدكتورة السعودية ثريا عبيد، التي طالبت بمناسبة اليوم العالمي
للمرأة، تمكين المرأة العربية من المشاركة في مجتمعها، وأن الإصرار على عزلها
سيؤدي إلى حرمان النساء من المطالبة بحقوقهن الإنسانية، المتمثلة في القضاء على
الفقر والأمية والتمييز في التعليم والوظائف وغيرها من الأمور.
سيداتي.. سادتي.. مخطئ من يعتقد بان المرأة ليس لها دراية في العمل
السياسي، ففي عصور الجاهلية كانت هناك العديد من الملكات حكمن بلدانهن، وكانت
عصورهن من أزهى العصور، ويكفي بأن القرآن الكريم ذكر الملكة بلقيس مبينا بأنه
كان لها ملك عظيم. وفي عصور الإسلام الزاهية، كانت المرأة العربية دوما حاضرة،
لها الحق الكامل في التعبير عن آرائها، وفي ممارسة النشاط السياسي.
في كتاب سلطانات منسيات، تؤكد الباحثة فاطمة المرنيسي، بأن النساء
لسن جديدات على المناخ السياسي، مؤكدة بأنه تمَّ أخذ البيعة منهن على خلافة
سيدنا أبي بكر الصديق. وفي النزاع الذي دار حول خلافة معاوية، انقسم النساء
حوله، فمنهن من وقفن في صف معاوية، ومنهن من أعلن نصرتهن للأمام علي بن أبي
طالب، مستخدمات فصاحتهن وبلاغتهن التي اشتهرن بها في تأييده.
هناك صفة جميلة في المرأة لا توجد لدى الرجل، أنها حين تؤمن بشيء
تحارب من أجله بضراوة، ملقية بنفسها في رحى المعركة بدون درع يقيها من الضربات
القاتلة. بعكس الرجل الذي يتلفت حوله قبل أن يُقدم على موقف أو رؤية أو تصرّف،
لأنه يضع نصب عينيه اعتبارات المجتمع، وعواقب الأفعال. ألا يكفي هذا لكي تقتنع
مجتمعاتنا العربية، بحق المرأة في أن ترث التاريخ الذي تركنه لها جداتها
القدامى!!
أضيفت في13/01/2007/ خاص
القصة السورية
/المصدر: الكاتبة
(
للتعليق والمشاركة بالندوة الخاصة حول
أدب المرأة )
   
 |
